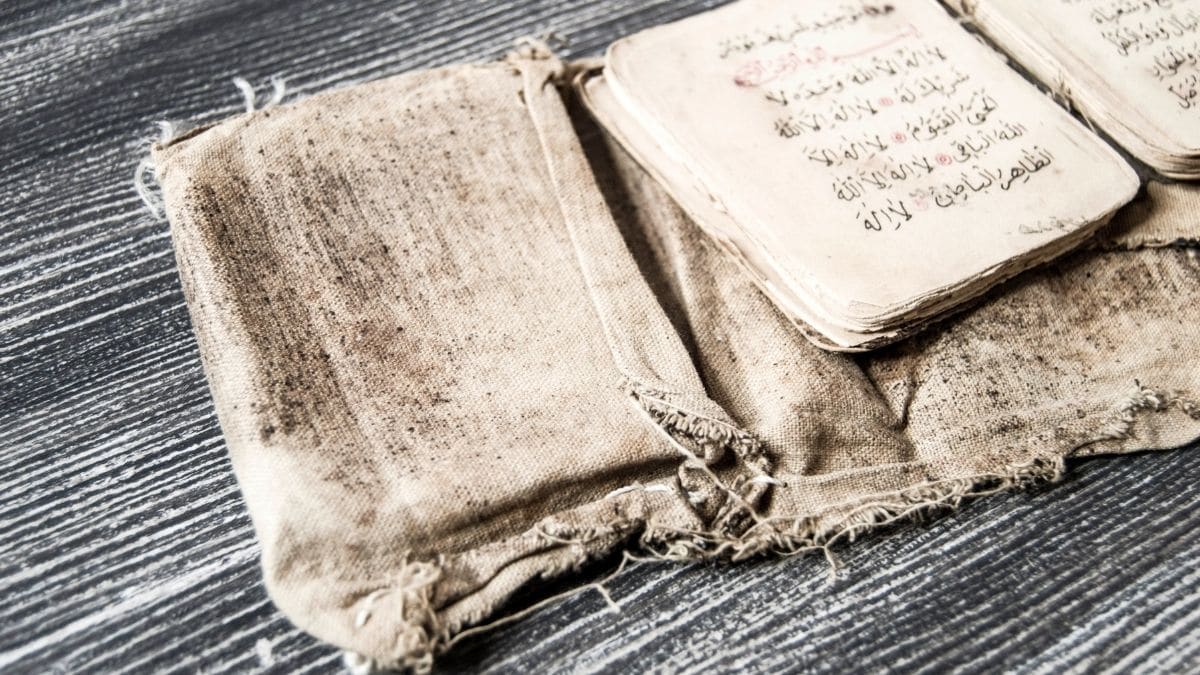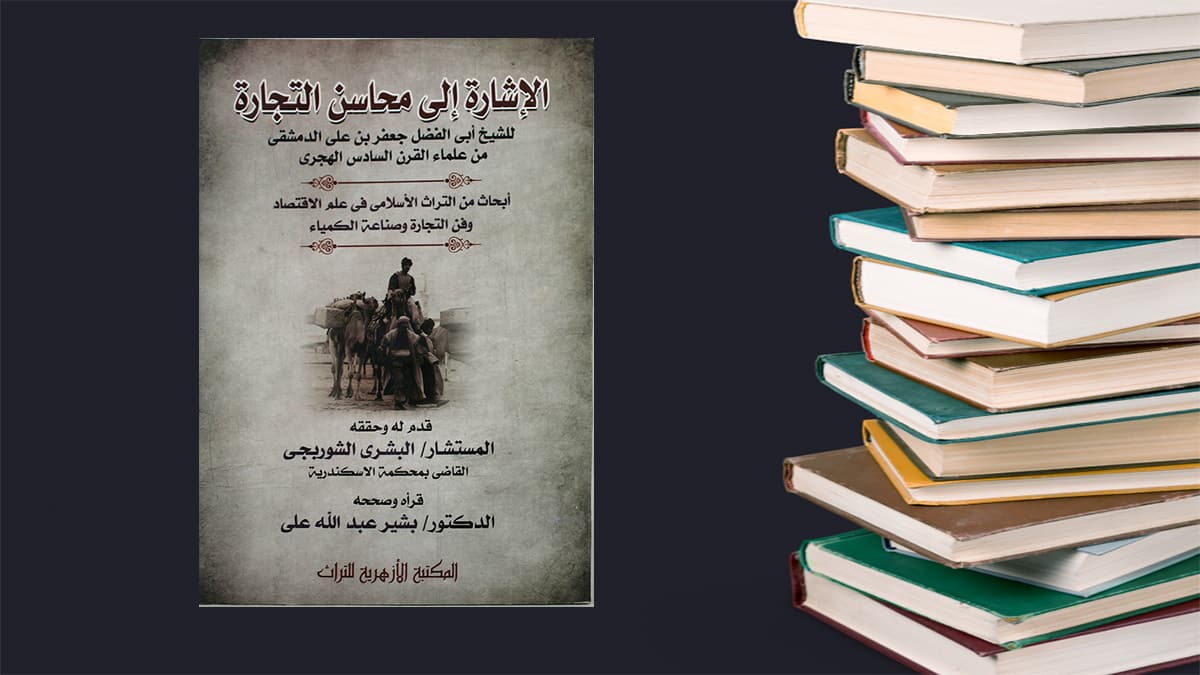كيف يمكن أن يصبح الاستصحاب أداة فعالة لمواجهة قضايا معاصرة في الفقه؟ في هذا الحوار ، يقدم لنا الدكتور إسماعيل الحسني رؤيته حول الاستصحاب كأداة فقهية مستمرة، مؤكدًا على تطبيقاته العملية التي تتفاعل مع التحديات الفقهية المعاصرة.
الدكتور إسماعيل الحسني، أستاذ مقاصد الشريعة والفقه المعاصر في كلية الآداب بجامعة القاضي عياض في مراكش، المغرب، هو أحد أبرز العلماء في مجال الفقه المعاصر. وُلد في مدينة مكناس بالمغرب عام 1963م، وبدأ عمله الأكاديمي في مجال تدريس مقاصد الشريعة والفقه المعاصر في جامعة القاضي عياض منذ عام 1993م. تميز الدكتور إسماعيل بالتركيز على تطوير الفكر الفقهي في ضوء مستجدات العصر، كما أسهم بشكل كبير في مجال الدراسات المقاصدية من خلال العديد من المؤلفات التي تُعد مرجعًا في الفقه المعاصر، مثل “نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور” و”التجديد والنظرية النقدية في خطاب التجديد الإسلامي في المغرب.
لقد حصل الدكتور إسماعيل على العديد من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة علال الفاسي عام 1996م، وجائزة عبد الله كنون عام 2003م. وهو من الأسماء البارزة في المجال الفقهي المعاصر، لا سيما في تطبيق مقاصد الشريعة في معالجة قضايا العصر المتجددة.
نلتقي بالدكتور إسماعيل الحسني على هامش أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المقام في مدينة الدوحة، قطر، والذي يجمع نخبة من الفقهاء والباحثين في مجال الفقه الإسلامي.
في هذا اللقاء، يناقش الدكتور إسماعيل الحسني عددًا من القضايا الفقهية المعاصرة ويقدم رؤيته حول آليات الاجتهاد في زمن النوازل وأهمية الاستصحاب كأداة اجتهادية.
إلى الحوار:
دكتور إسماعيل الحسني، أنتم تشاركون في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بناءً على استكتاب علمي من الأمانة العامة، وليس باختيار شخصي لموضوع الورقة. كيف تقيّمون هذه المنهجية في اختيار الموضوعات؟ وهل ترون أن المجمع يُحسن توجيه البحث الفقهي من خلال استكتاب الخبراء والمتخصصين؟
من المسلم به أن للأمانة العلمية للمجمع خبرة طويلة بجملة المسائل التي ترى أنها جديرة بالمدارسة العلمية في هذا الباب، ومن ثم فإن لها من العلم والإحاطة والانفتاح الكافي على كل الجهود التي يبذلها العلماء في هذا المضمار. ولهذا فإنها لا تتوقف عن استشارتهم وطلب خبراتهم من أجل تعميم آرائهم واجتهاداتهم المتصلة بما يستجد في حياة المسلمين من نوازل وقضايا.
كيف ترون إدراج دليل الاستصحاب ضمن الآليات الاجتهادية في زمن النوازل؟ وهل ترون أنه كافٍ وحده لحسم المسائل الطارئة؟
الاستصحاب هو جعل الحكم الثابت في الزمن السابق مستمراً في الزمن اللاحق عليه حتى يقوم دليل ينفيه ويناقضه.
آلية الاستصحاب متمثلة في جعل الحال مصاحبة لذلك الحكم الثابت أو المنفي… أعني أنه إجراء استدلالي معتبر في الدفع وفي الثبوت، يلجأ إليه المفتي عندما لا يجد مستندًا غيره. ولهذا قال الرازي: “لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني على القول بالاستصحاب”.
إننا عندما نفتقر إلى الدليل النقلي من الشريعة، وعندما لا نتوفر على النظير منها الذي يمكننا من أن نقيس عليه، فقد نلجأ إلى استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي أو استصحاب إبقاء ما كان على ما كان من نفي أو إثبات…
الاستصحاب فعل استدلالي من الفقيه المفتي يعكس استدامة الحكم السابق الثابت بدليله بسبب عدم الدليل المغير
يبدو من استقراء الاستدلالات الفقهية القائمة على الاستصحاب أن الحكم الشرعي فيها مستند، كما بين الشربيني، إلى الدليل القائم الذي استصحبه الفقيه المفتي، وهو مصاحب له في كل وقت حكمه.
وعليه، فإن الاستصحاب فعل استدلالي من الفقيه المفتي يعكس استدامة الحكم السابق الثابت بدليله بسبب عدم الدليل المغير، مثل الإباحة الأصلية، مثل العدم الأصلي، ومثل استمرار حكم شرعي بناءً على وجود سببه. وعليه، فإن تسمية الاستصحاب بالدليل إنما هي تسمية على سبيل التجوز كما أوضح الخوارزمي.
ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستصحاب ليس دليلاً في ذاته بل “حالة مؤقتة بانتظار الدليل”.. ما رأيكم في هذا؟ وهل تنحازون إلى المدرسة المعتبرة له كدليل قائم؟
أمثال هذه التساؤلات لا نجد فيها جوابًا وحيدًا لأن الاختلاف بين الفقهاء في الاستدلال هو متلون بحسب نسق كل واحد منهم. من يقرر نسقه الاستدلال بالمصالح والأعراف تضيق عنده دائرة الاستدلال بالاستصحاب، ومن يحصر نسقه الاستدلالي على الاستدلال بالمنقولات من الكتاب والسنة والإجماع، فيوسع كثيرًا من دائرة العمل بالاستصحاب عندما لا يجد نصًا ولا إجماعًا. أما من أخذ بالقياس في استدلالاته فإنه يضيق، بهذه الدرجة أو تلك، دائرة الاستصحاب فلا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد من النصوص والإجماع ما يمكن أن يقيس عليه.
يظهر الإعمال الميداني للاستصحاب صورًا متنوعة من تدافع الأنظار الاستدلالية التي يفيد أصحابها من الإباحة الأصلية ومن العدم الأصلي ومن كل ما يتفرع عنه من قواعد أصولية وفقهية…
من ذلك استعمال الفقهاء قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث…
ومن ذلك استعمال الفقهاء أيضًا قاعدة “اليقين لا يزول بالشك”. ولا يخفى المنحى المقاصدي الذي تنص عليه هذه القاعدة والمتمثل في رفع الحرج عن المكلفين بأحكام الشريعة الإسلامية. الأصل في المعتبر فيها هو اليقين، أما الشك فتردد يلزم صاحبه ويتصل به ويلصقه…
الاختلاف بين الفقهاء في الاستدلال هو متلون بحسب نسق كل واحد منهم
والحق أن فروع هذه القاعدة الفقهية والأصولية والمقاصدية كثيرة وتعز عن الحصر. نستخلص من واقعها الاستدلالي أن الشريعة الإسلامية بمثابة البناء الذي سبق وأن كابدنا أو سبق وأن تعبنا في إيجاد أسباب تحصيله وفي بناء أعمدته وأركانه… ولا زلنا كذلك حتى عرفنا بدقة “متناهية” مداخله ومخارجه، أسراره وفضاءاته وكل أمكنته بل وكل ما يكتنزه من مرافق ومنافع.
ومن ثم حق لي أن أقول، وأنا أقتبس من لغة الغزالي أبو حامد رحمه الله، إن حال المستدل بالاستصحاب مماثل لحال مالك بناء البيت لأنه هو “الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي غلبة الظن. أما الأعمى الذي يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت”.
في حالات مثل حكم المفقود أو نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين.. كيف برز الاستصحاب عندكم كأداة لحماية المقاصد قبل أن يكون مجرد قاعدة إثبات؟
الحماية هنا هي حماية أولًا وقبل شيء لحقوق المفقود، فهو حي في حق نفسه، له حقوق وعليه واجبات تتعلق بالزوجة والنفقة والإرث. إذ لا يرثه أحد وأنه يرث من غيره، وهو قول الجمهور من الشافعي ومالك. المفقود عندهم يرث من غيره ويحتفظ له بنصيبه من الإرث وتثبت له الوصايا…
استصحاب الإباحة دائر في فلك التوسط الذي يقصد الشارع سبحانه وتعالى بدون مغالاة الغالين ولا انتحال المبطلين
يبدو أن أصحاب هذا القول يستصحبون حياته فتظل حقوقه التي كانت قبل فقده على ملكيته، أي أن المفقود يرث ولا يورث. وتتزوج زوجته ولا تؤخذ وديعته من مودعه. دليل ذلك استصحاب حياة المفقود حتى يظهر خلاف ذلك. الاستصحاب هنا حجة في الإثبات كما في الدفع. ولظاهر من هذه الآراء رجحان القول بالرأي الأول لأنه قائم على دليل الاستصحاب الذي هو حجة في النفي والإثبات إلى أن يقوم دليل يخالفه ويناقضه. نقرر هذا وإن اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي يشترط فيها الحكم بموت المفقود.
العلاقة بين الاستصحاب والمقاصد: هل الاستصحاب خادم للمقاصد فقط؟ أم أنه يمكن أن يُفهم في بعض صوره كمقصد ضمني، يحفظ الاستقرار واليقين؟
لا بد من الحذر لكل من يسلك طريق الاستصحاب عند الإفتاء في النوازل والقضايا المستجدة. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المكلفين البراءة، الأصل في اليقين، كلها أصول يستصحبها الفقيه المفتي ولا يتوقف عن إعمالها إلا عند وجود دليل قوي معتبر يناقضها.
اليقين في الوضوء أو التيقن من انعقاد النكاح مستصحبان دائمًا ولا يزولان ولا يتزعزعا بمجرد الشك. فمن يحس على سبيل المثال بشيء في مخرجه يشبه خروج الريح فلا ينصرف حتى يتيقن ولا يستسلم للوساوس حتى لا يصبح أسير مرض نفساني خطير. وذلك مناقض لكلية أو مصلحة حفظ النفس.
براءة ذمة المتهم أيضًا ثابتة أصلية ومستصحبة في الأقضية فلا ترفع البراءة إلا بدليل يثبت إدانته. كما أن في استصحاب البراءة الأصلية اتساق مع ذلك المبدأ الاقتصادي الذي يحكم القانون المدني، ومفاده أن المرء بريء من كل اتهام إلا أن يأتي المدعي بالدليل والبينة. أما المعاملات وسائر الأفعال الإنسانية فمباحة نستصحب إباحتها إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعها.
في استصحاب البراءة الأصلية اتساق مع ذلك المبدأ الاقتصادي الذي يحكم القانون المدني، ومفاده أن المرء بريء من كل اتهام إلا أن يأتي المدعي بالدليل والبينة
إن في استصحاب الإباحة تصحيحًا لكثير من الأعمال والمعاملات والعقود لأن أي فعل لم يوجد نص شرعي في حكمه فهو مباح ما دام غير مناقض لأصول الشريعة وغير مخالف لما يريده الشارع جل وعلا من مصالح في الشرع الإسلامي. أعني إن فعل استصحاب الإباحة دائر في فلك التوسط الذي يقصد الشارع سبحانه وتعالى بدون مغالاة الغالين ولا انتحال المبطلين، أقول بدون تشدد المتشددين، نعم لا شك في ذلك ولكن أقول في الوقت نفسه بدون تنطع المنحرفين. ففي فلك هذا المقصد المصلحي وما يندرج فيه من سماحة ومن يسر يبرز بوضوح تام، كما قال الأديب الشاعر والفقيه النابه قطب ريسوني: “التلازم المتين بين الاستصحاب والاستصلاح”. لا يعني سلوك الاستصحاب عدم انضباطه لما يناقضه من حجج دامغة ومن أدلة قوية لأن ما يكشف حدود الاستدلال به هو تطبيقاته الفقهية المختلفة.