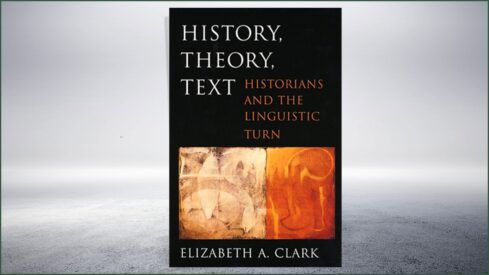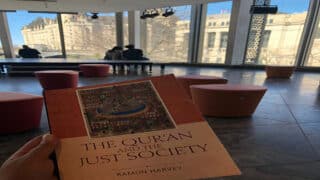في كتابها عن ” التأريخ والنظرية والنصّ: “المؤرخون والمنعطف اللغوي” تبحث أستاذة الأديان الأميركية إليزابيث كلارك العلاقة بين التأريخ من جهة، والفلسفات والنظريات والتيارات الفكرية التي ظهرت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين من جهة ثانية، لاسيما ما ارتبط منها باللغة، أو بما يُطلق عليه “المنعطف اللغوي”. كما تطرح العديد من الأسئلة: لمن يُكتب التاريخ؟ وإلى أي عنوان يُرسل؟ وكيف تصنع الحقيقة التاريخية؟
صدر مؤخرا عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، العدد السادس والثلاثون (شتاء 2022) من الدورية المحكّمة “تبيُّن” للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، وضمّ موادّ حول فلسفة ابن رشد، وما بعد الكولونيالية الفرنسية إلى جانب مراجعات الكتب والترجمات. وفي الباب الأخير (مراجعات الكتب)، وردت مراجعة لكتاب “التأريخ والنظرية والنصّ: المؤرخون والمنعطف اللغوي” لمؤلفته إليزابيث كلارك، أعدّها الدكتور عمرو عثمان. الكتاب يقع في حدود 336 صفحة، صدر عام 2004، عن دار نشر جامعة هارفارد في كامبريدج/ لندن.
ويعمل د. عمرو عثمان الذي يعمل أستاذًا مشاركًا بقسم العلوم الإنسانية بجامعة قطر. وتشمل اهتماماته البحثية الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة والفكر العربي الحديث والمعاصر. وقد درس الأستاذ عمرو عثمان العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز بإسكتلندا، ودرجة الدكتوراه من جامعة برنستون الأمريكية في التاريخ الإسلامي.
قصة التأريخ بالفلسفات والتيارات الفكرية
يلخّص هذا الكتاب قصة العلاقة بين التأريخ من جهة، والفلسفات والنظريات والتيارات الفكرية التي ظهرت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين من جهة ثانية، لا سيما ما ارتبط منها باللغة، أو بما يُطلق عليه “المنعطف اللغوي” The Linguistic Turn تحديدًا.
ويقول الدكتور عمرو عثمان أن مؤلفة الكتاب إليزابيث كلارك – وهي أستاذة أديان متقاعدة في جامعة ديوك الأميركية – تبدأ كتابها بمقدمة تشرح فيها الهدف منه، أي السعي إلى إقناع المؤرخين (“التقليديين”، كما تشير إليهم في بعض أجزاء الكتاب)، بأن المهتمين بالنظريات الحديثة من المؤرخين ليسوا متمردين على حرفة التأريخ، بل يناقشون، في شكل جديد، قضايا فكرية ذات تاريخٍ طويل ).
ويؤكد عمرو عثمان أن الكتاب حاول تحقيق هذا الهدف من خلال عرضٍ ومناقشة لأهم الجدالات التي وقعت في نهاية القرن التاسع عشر، وعلى مدار القرن العشرين، فيما يتعلق بالتأريخ والفلسفة والنظرية النقدية. مشيرا في ذات الوقت إلى أن ثمة هدف أصغر يتمثّل في رغبة المؤلفة في البرهنة على أن النظريات اللغوية الحديثة وأفكارها عن اللغة والنصّ، تُعدّ أكثر فائدة في دراسة النصوص المسيحية القديمة، وهي مجال تخصّصها نفسها.
الدفاع عن التأريخ والتحسر عليه
ويأخذنا الدكتور عمرو عثمان في جولة قصيرة بين ثنايا هذا الكتاب، الذي يتكون من مقدمة وثمانية فصول. يتناول الفصل الأول، وعنوانه “الدفاع عن التأريخ والتحسّر عليه”، بوجهٍ عام فكر المؤرخ الألماني ليوبولد فون رانكه Leopold von Ranke التأريخي وإرث هذا الفكر ونقاده، ثم أثر رانكه في التأريخ ، فضلاً عن بعض المشكلات الإبستيمولوجية المرتبطة بأفكاره، وصولاً إلى “الأزمة” التي وجد المؤرخون التقليديون أنفسهم فيها.
ويبدو من النظرة الرانكية أن الحقيقة التاريخية واحدة، يمكن التوصل إليها بموضوعية صارمة ووصفها في شكل سردي، اعتمادًا على وثائق الأرشيفات وقراءتها (أي الوثائق) نقديًا. وقد ارتبطت هذه النظرة الرانكية الوضعية بفكرة الموضوعية العلمية) نسبة إلى العلوم الطبيعية (في المراحل الأولى للحداثة، إلا أنها فشلت – كما أشار نقادها – في الانتباه إلى التحوّل المعرفي الذي طرأ على العلوم الطبيعية نفسها في بدايات القرن العشرين، وأدى إلى التخلّي عن فكرتَي اليقين والثبات، والانتباه إلى أن قياس الزمان والمكان لا ينفصل عن “وضع” الباحث أو ملاحِظ الظاهرة العلمية.
وتلفت مؤلفة الكتاب إليزابيث كلارك النظر هنا، إلى أن نقد أفكار رانكه كان قد بدأ في ألمانيا نفسها مع الفيلسوفَين الألمانيين فريدريك نيتشه Friedrisch Nietzsche ، وفيلهلم دلتاي Wilhelm Dilthey، اللذَين رفضَا فكرة الموضوعية، بل أصرّ دلتاي على أهمية التأويل الذي يرتبط بواقع المؤرخ ارتباطًا حتميًا . فلكي يفسر المؤرخ التاريخ، لا مفر من أن يبدأ ببعض الأفكار، ثم ينظر في الماضي، ليعود مرة أخرى إلى الحاضر، وهكذا في عملية تشبه “الدائرة التأويلية”. إن المدهش في هذا الأمر، بحسب كلارك، هو أن هذا النقد الألماني لأفكار رانكه، لم يكن له أثر في العالم الأنكلوفوني، ربما بسبب حاجز اللغة، ذلك أن قلة فقط من المؤرخين الأنكلوفونيين – من أهمهم تشارلز بيرد – هي التي اهتمت بأفكار دلتاي وغيره من المنظرين والفلاسفة الألمان.
الفلسفة التحليلية والمؤرخون
في الفصل الثاني تنتقل كلارك إلى الحديث عن الفلسفة التحليلية Analytic Philosophy، وهي تندرج عمومًا، بحسب المؤلفة، في الفلسفة اللغوية التي هيمنت على العالم الأنكلوفوني طوال الجزء الأكبر من القرن العشرين.
تناقش كارك في هذا الفصل أفكار كارل بوبر Karl Popper وكارل غوستاف همبل Carl Gustav Hempel ونقادهما، وقد رفض الأول فكرتَي الموضوعية ووجود قوانين تاريخية، بينما قبلهما الثاني. وقد انصبَّ جزءٌ كبير من الجدل هنا على قضية تفسير التاريخ، وتحديدًا على سؤال: هل يمكن تفسير التاريخ بالأسلوب نفسه الذي نفسّر به الطبيعة المادية؟ يبرز هنا رأي فيلسوف التاريخ الكندي وليام دراي William Dray، إذ يبيّن أنه بينما يسعى التفسير التاريخي للإجابة عن سؤال “كيف، على نحو محتَمَل “How–possibly، فإن تفسير الطبيعة المادية يسعى للإجابة عن سؤال “لماذا، على نحو حتمي “Why–necessarily .
تُعدّ قضية علاقة اللغة بالعالم الخارجي، أو قضيتا الدلالة Reference والتصوير) أو التمثيل(Representation، إحدى القضايا الأساسية في الجدالات الفلسفية والفكرية الحديثة بوجه عام .إن السؤال الأساسي هنا هو: هل تعكس اللغةُ العالمَ الخارجي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي كما يعتقد من ينتمون إلى ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة، فكيف يمكن المؤرخ افتراض قدرته على وصف “ما حدث بالفعل” باستخدام اللغة؟
تناقش كارك في هذا السياق إسهامات بعض المفكرين، ومنهم الفيلسوف الأميركي هياري بوتنام Hilary Putnam وفكرته عن “الواقعية الداخلية “Internal Realism، ومفادها أن العقل لا يعكس العالم الخارجي (كما يقول الوضعيون Positivists أو يصنعه) كما يقول من ينتمون إلى ما بعد البنيوية ،وإنما يعكس الواقع من خلال تجاربنا التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمنظومتنا المعرفية والعَقَدية. يعني هذا أن الموضوعية نفسها نسبيّة، فهي موضوعية خاصة بنا، وليست موضوعية مفارقة مستقلة عنا.
عن البنيوية والبنيويين
تبدأ كارك في الفصل الثالث، الحديث عن البنيويةStructuralism، وهي واحدة من أبعد نظريات القرن العشرين أثرًا، وجاءت على النقيض من الفلسفتَين، الوجودية Existentialism، والظاهراتيةPhenomenology، اللتَين انتعشتا في فرنسا وأوروبا في النصف الأول من القرن العشرين، وبوصفها ردة فعل على التطورات السياسية في فرنسا في ستينيات القرن العشرين، فضاً عن كونها حركة نقدية لقيم التنوير وأفكاره.
وقد ارتبط ظهور البنيوية، كما هو معروف، بظهور علم اللغويات الحديث على يدَي اللغوي السويسري فرديناند دي سوسيرFerdinand de Saussure ، وقد امتد أثرها إلى الأنثروبولوجيا والنقد الأدبي والتحليل النفسي والفلسفة، إلى أن بدأت في الضعف في الربع الثالث من القرن العشرين، لتحل محلها ما بعد البنيوية Post–structuralism)). بدت البنيوية – باعتبار تركيزها على البنية في مقابل التطور الزمني، وعلى الشكل في مقابل المحتوى، وعلى الدالّ في مقابل المدلول، وعلى الاوعيفي مقابل الوعي) وهو أحد أهم أسباب ارتباطها بالأنثروبولوجيا (، وعلى الانقطاع والصدوع في مقابل الاستمرارية والتماسك – مناقضة لما يقوم به المؤرخ. وقد قام منهج دي سوسير على التقليل من أهمية العامل الزمني في دراسة اللغة، وعلى التأكيد على الطبيعة الرمزية والاعتباطية للغة، وهي فكرة عدّها المؤرخون كفيلة بالقضاء على نظرية المطابقة التي اعتمدوا عليها. وهاجمت البنيوية فكرة السياق التاريخي والبحث عن الجذور والتسلسل الزمني ومبدأ الغائية، بل أظهر كثير من البنيويين عداء لفكرة التأريخ، ومنهم كلود ليفى–ستراوس Claude Lévi–Strauss الذي نفى الأمر، وإن أكّد على الطبيعية الجزئية والانحيازية للمعرفة التاريخية التي تعتمد دائمًا على نصوص منتقاة.
ينتهي هذا الفصل بنقد أربعة من المفكرين ،للبنيوية، قد يكون أشهرهم وأهمهم الفرنسيان بول ريكورPaul Ricœur ، وجاك دريدا Jacques Derrida ، وقد كان لهذا الأخير جدلٌ كبير مع ليفي ستراوس حول أسبقية الكتابةبمفهومها الواسع لدى دريدا على الحديث الشفاهي أو الكلام المنطوق، وهو جدل انحاز فيه المؤرخون إلى دريدا الذي قال بأسبقية الحديث على الكتابة.
وتعدّ كلارك البنيويةَ صاحبة الفضل في أي انتباه أولاه بعض المؤرخين لدور اللغة في دراسة التاريخ.
مدرسة الحوليات ومجال المؤرخ
وفي الفصل الرابع، المعنون “مجال المؤرخ”، تبدأ كلارك بتناول مدرسة الحوليات الفرنسية التي انطلقت عام 929 مع لوسيان فيفر Lucien ومارك بلوكMarc Bloch ، وعُدَّت أهم ما أنتجت فرنسا من فكر تاريخي في القرن العشرين. جاءت مدرسة الحوليات ردة فعل للمذهب الوضعي التاريخي الذي ساد في فرنسا نفسها، ومن أهم أعلامه تشارلز لانغلوا Charles Langlois ، وتشارلز سينيوبوسCharles Seignobos.
هكذا، نرى الانتقال من تركيز الوضعية على الوثائق إلى تركيز الحوليات على المؤرخ نفسه، والانتقال من الوصف إلى التحليل. فالمؤرخ هو الذي يصوغ السؤال؛ ما يعني أنه يخلق موضوع التأريخ ولا يعثر عليه كما ترى وضعية رانكه.
وتوضح كارك أن مدرسة الحوليات بدأت، فقط، في مرحلة لاحقة من تاريخها، الاهتمام ببعض القضايا النظرية، مثل النقد الأيديولوجي والتحليل النفسي واللغويات البنيوية والخطاب ،وهو تطوّر أدى في النهاية إلى ظهور ما أُطلق عليه “التاريخ الجديد”. وبعد تعرّض البنيوية لنقد شديد في فرنسا لتركيزها على البنى وإهمالها الإنسان، فضلاً عن ازدرائها الأحداث، بدأ الجيل الثالث من مؤرخي الحوليات، ومن أعلامه فرانسوا دوس Doss Francois، الاهتمام بالحدث، بل الاهتمام بالأفكار الجديدة حول النص. وظهر جيل من مؤرخي “التاريخ الجزئي “الذين أشاروا إلى فائدة التركيز على تجربة الناس الحياتية ومشكاتهم اليومية في دراسة التاريخ، وهو أمر رفضته الأجيال الأولى من مؤرخي الحوليات، على الرغم من أنه قد يمثل نافذة يطل منها المؤرخ على قضايا مجتمعية أكبر.
تتحدث كلارك، في هذا السياق، أيضًا عن تاريخ الذهنيات L’histoire des mentalités في فرنسا، وكيف ركّز على أفكار الناس العاديين في مقابل تركيز التاريخ الفكري في الولايات المتحدة على النصوص “العليا” أو المتقدمة التي أنتجها المفكرون والمثقفون. إلا أن مؤرخي التاريخ الجزئي، بحسب كارك، أهملوا، كنظرائهم في مدرسة الحوليات، القضايا النظرية والمعرفية المرتبطة بالتأريخ.
وعلى الرغم من الثقافة الواسعة لكل هؤلاء المؤرخين الذين ذكرتهم كلارك في هذا الفصل، فإنهم تجاهلوا القضايا النظرية والمعرفية، بل عادَوْا من حاول إقحامها في دراسة التاريخ، ما ترك هذا المجال للمنظّرين أنفسهم، وقلة من المؤرخين المشتغلين بالتاريخ الفكري والتاريخ الثقافي كما تبيّن كلارك بعد ذلك.
السرد والتأريخ
تنتقل كارك في الفصل الخامس للحديث عن “السرد والتأريخ”، إذ يُعد السردُ في نظر مؤرخي الحوليات إشكاليًا لأنه يرتبط بتاريخ الأحداث الذي لا يليق بالمؤرخ الجادّ الذي يجب أن ينصبّ جل عمله على التحليل، وليس مجرد الوصف .وصل هذا النقد إلى درجة وصف المؤرخ الفرنسي جاك لو غوف Jacques le Goff السردَ بـ “الجثّة الهامدة” التي لا تهتم إلا بالحدث السياسي و”الأبطال” أو العظماء الذين يفترض أنهم محركو أحداث التاريخ. أما المنظّرون، مثل رولاند بارت والمؤرخ الأميركي هايدن وايت فرفضا فكرة حيادية السرد بوصفه نتاج الموضوعية المزعومة. فالسرد في نظرهم يفرض على أحداث التاريخ تماسكًا وتواصاً واكتمالاً وختامًا، ,هي كلها أمور لا تعكس حيوية الحياة وعشوائية المصادر والفوضى التي يتسم بها كلاهما.
ويتجاهل السرد فجوات التاريخ ونواقصه أو يتجاوزها أو يعالجها بهدف خلق “أثر واقعي” زائف. يعني كل ذلك أن التاريخ السردي هو، في النهاية ،تاريخ أيديولوجي، وأن أيّ وصف للماضي لا يمكن أن يكون “بريئًا” أو محايدًا .فالأسئلة التي يصوغها المؤرخ ترتبط بالضرورة بواقعه هو، وليس بالماضي الذي يبحث فيه .إن التاريخ، في هذه النظرة، ما هو إلا عملية ذهنية فكرية تقع في الحاضر وفي رأس المؤرخ ،كما يقول المؤرخ البريطاني المتخصص في تاريخ الأفكار غاريث ستيدمان جونز Gareth Stedman Jones. إلا أنه كان للسرد من يدافعون عنه، لا سيّما من المؤرخين المتأثرين بالفلسفة التحليلية مثل آرثر كولمان دانتو الذي رأى أن التاريخ يروي القصص ،إلا أن المؤرخ لا يصف فقط أحداث التاريخ ، بل ينظمها ليبرز أهميتها.
التاريخ الفكري الجديد
وفي الفصل السادس، وعنوانه “التاريخ الفكري الجديد”، تبدأ كارك الحديث عن المؤرخ الأميركي آرثر لافجوي Arthur Lovejoy وفكرته عن “تاريخ الأفكار” المتجاوزة للزمن والمشتركة بين الحضارات. وعلى الرغم من أفول نجم لافجوي سريعًا بسبب النقد، الظالم أحيانًا، الذي تعرّض له منهجه، فإنه كان سبّاقًا في دعوته إلى الاستفادة من التخصصات المختلفة في دراسة التاريخ.
وعمومًا، كان هناك مؤرخون آخرون مهتمون بما يدور في “عقول البشر السابقين ،”مثل المؤرخ البريطاني روبن جورج كولينغوود، الذي رأى أن كل التأريخ هو تأريخ للأفكار، فالأحداث ما هي إلا الجزء الخارجي الظاهر مما وقع في الماضي. أما بُعدها الداخلي، فيتمثّل في الأفكار التي حرّكت الأحداث على نحو معيّن.
والتاريخ الفكري الجديد، كان من أعلامه الفلاسفة والمؤرخون الفرنسيون من أمثال ميشال فوكو Michel Foucault وميشيل دي سيرتو Michel de Certeau وروجر تشارتير Roger Chartier. ,يهتم التاريخ الفكري الجديد بالسياق المادي والثقافي، ويركّز على التصدعات والثغرات والتقطّعات والتناقضات والمعضات والصدفة والخطأ والمسكوت عنه في النصوص وفي التاريخ، فضلاً عن الأيديولوجيا والقوة والتأويل، وذلك في مقابل النظرة التقليدية التي سعت إلى عرض التاريخ في شكل سردي تواصلي لا ثغرات فيه ولا غموض.
النصوص والسياقات
في الفصل السابع، الذي جاء بعنوان “النصوص والسياقات”، تعرض المؤلفة فكرة المؤرخين التقليدية عن النص بوصفه شيئًا ثابتًا ومتماسكًا ومصدرًا موثوقًا للمعلومات، بل شيئًا يستقل عن السياق .وفرّق هؤلاء المؤرخون بين النصوص والوثائق، فبينما ترتبط الأولى بالمصادر الأدبية والفكرية التي يتعامل معها مؤرخو الأفكار، فإن الوثائق هي التي تحتوي على معلومات وبيانات سياسية واجتماعية واقتصادية، أي البيانات التي يستخدمها هؤلاء المؤرخون التقليديون .أما المنظّرون، ولا سيما الذين ينتمون إلى ما بعد البنيوية منهم الآن، فنظروا إلى النصوص نظرة مختلفة تمام الاختاف.
تتحدث كلارك عن رولان بارت وجاك دريدا وجوليا كريستيفا، وكيف نظر هؤلاء المنظّرون إلى النص بوصفه مُنتِجًا، يتمتع باستقلالية وقوة خاصة به. تظهر هذه الإنتاجية في عملية القراءة، تلك العملية التي تولّد الأفكار من النصوص. يعني هذا الفهمُ التخلي عن فكرة البحث عن قصد المؤلف، بل عن سياق التأليف، فالكتابة تحديدًا، كما صرّح دريدا، تفصل القارئ عن المؤلف أو تعني غياب المؤلف، وهو أمر يعزّز إنتاجية النص. وقد وسّع بارت مفهوم اللغة، التي عدّها، على خلاف دي سوسير، أعمّ من علم العامات Semiology، ما يجعلها جديرة أن تكون موضوع البحث.
وأخيرًا، تناقش كارك أفكار بعض المؤرخين “السياقيين” المعاصرين، ومن أبرزهم كوانتين سكينر Quentin Skinner وجون جغيفيل أغارد بوكوك ، وقد كان اهتمامهما ب[، وليس بالسياق المادي الذي اعتاد عليه المؤرخون التقليديون. فاللغة، في هذه النظرة، تمثل السياق الحقيقي الذي يجب على المؤرخ الاهتمام به والتركيز عليه.
لمن يُكتب التاريخ؟ وإلى أي عنوان يُرسل؟
تناقش كلارك في الفصل الثامن والأخير، بعنوان “التاريخ والنظرية والنصوص قبل الحديثة”، ما استفادته هي من النظريات التي عرضتها في كتابها، وسبل مساعدة هذه النظريات الباحثَ في دراسة النصوص المرتبطة بالفترة المتأخرة من المسيحية القديمة، أي بمجال تخصص المؤلّفة.
وتصرّح بأنها استفادت من هايدن وايت في طرح السؤال الأول: لمن يُكتب التاريخ؟ وإلى أي عنوان يُرسل؟ واستفادت من ميشيل دي سيرتو في الانتباه إلى اختلاف الماضي) وهو يختلف عن التأريخ الذي هو عملية يبررها غياب الماضي الذي يعود إلى الحياة فقط في خطابات معاصرة .
واستفادت من لاكابرا في فكرة أن الماضي ليس كيانًا وُجد في وقت ما بشروطه ومن أجل ذاته، ولكنه يرجع إلى أسئلة المؤرخ الذي يصنع الحقيقة التاريخية ولا يجدها، وهي فكرة استفادتها أيضًا من مدرسة الحوليات ومن المؤرخ كولينغوود.
كما استفادت من مدرسة الحوليات ومن لافجوي في الانتباه إلى أهمية الإفادة من التخصصات الأخرى. واستفادت أيضا من غادامر في ضرورة عدم التفريق بين النص وآفاق المؤلف الذي أنتجه.
وتناسب كل هذه الأمور طبيعة المصادر التي تتعامل معها كلارك، ذلك أنها ليست “وثائق” مثل تلك التي يعتمد عليها المؤرخ المنتمي إلى التيارات المتأثرة بالعلوم الاجتماعية ،على سبيل المثال، بل هي نصوص “عليا” أدبية وفلسفية وأيديولوجية تحتاج إلى تحليل نظري ،وهو الأمر الذي تتيحه النظريات الحديثة، من وجهة نظر كارك.
كلارك وتقويم المحاولة
كتبت كارك هذا الكتاب عام 2004، إلا أن دعوتها لم يكن لها، في ما يبدو، صدى كبيرا، وذلك على الرغم من أنه حظي بقدر كبير من الاهتمام كما يظهر في مراجعات الكتب الكثيرة التي نُشرت عنه. فما زال المؤرخون “التقليديون” الذين تخاطبهم كلارك في كتابها متمسكين بـ “حرفة “التأريخ كما يعرفونها ويفهمونها، وما زالوا يتوجسون من تلك النظريات اللغوية التي سمحت لـ “المنظّرين” بالكتابة في التاريخ والتنظير حول طبيعة الحقيقة التاريخية والنصوص التاريخية والمعرفة التاريخية، ليشككوا في وجود الحقيقة ويعيدوا النظر في طبيعة النصوص ومنهج دراستها، وهي أمور تجعل من توجس المؤرخين التقليديين أمرًا مفهومًا، بل مشروعًا. إلا أن ذلك لم يدفعهم، كما أوضحت كارك، إلى الاشتباك مع النظريات الجديدة بدلاً من تجاهلها أو رفض الاشتباك النقدي معها مبدئيًا، فضاً عن الاستفادة منها.
ويقول الدكتور عمرو عثمان، قد تكون المشكلة الأكبر في طرح كارك عدم وضوح المقصود بالـ “المنعطف اللغوي” الذي يظهر في عنوان الكتاب ويمثل محور البحث فيه. ويضيف بأن القارئ يبحث من دون فائدة عن تعريف المنعطف في أي فصل من فصول الكتاب، وهو الأمر الذي قد يُفهم منه أن المقصود بالمنعطف اللغوي هو، ببساطة، الاهتمام باللغة في القرن العشرين، من دون أن يرتبط بتيار أو فلسفة أو نظرية لغوية معينة من تلك التيارات والفلسفات والنظريات الكثيرة الذي ظهرت في ذلك القرن والتي تناقشها كلارك نفسها في الكتاب.
وإذا كان الأمر كذلك، كان من الواجب، بكل تأكيد، أن توضح كلارك هذا الأمر بأسلوب مباشر، بل أن تناقش بعض الآراء التي تربط المنعطف اللغوي بتيارات معينة (مثل الفلسفة التحليلية، وربما بعد ذلك ما بعد البنيوية عمومًا أو تيار التأويل في ما يتعلق بالتأريخ تحديدًا). بيد أنه لو كان الأمر يتعلق بالاهتمام باللغة على العموم، فما الجديد في “المنعطف اللغوي”، لا سيّما أن كارك نفسها قد صرّحت بأنّ النظريات الحديثة تناقش قضايا فكرية ذات تاريخٍ طويل؟
ترتبط بهذه المشكلة الأخيرة مشكلة أخرى، وهي انتقائية كلارك في الاستفادة من النظريات اللغوية الحديثة. فعلى الرغم من اشتراك هذه النظريات في الاهتمام باللغة، فإن التناقضات بينها جليّة كما توضح كارك نفسها. يصعب ،إذًا، الحديث عن منهج نظري متماسك لكارك ،فهي تنتقي أفكارًا تقوم على افتراضات متباينة في نظريات مختلفة. ومع رغبة المؤلفة في إشراك المؤرخين في “المنعطف اللغوي”، ومن ثم إنهاء نظرة المنظّرين المتدنية إليهم واتهامهم بافتقاد العمق النظري والفلسفي عمومًا، فإن انتقائيّتها غير المبررة قد ترسّخ – هي نفسها – تلك النظرة السلبية إلى المؤرخين بوصفهم غير قادرين على هضم النظريات اللغوية الحديثة هضمًا كاملاً وتوظيفها توظيفًا منضبطًا وممنهجًا.
تنبيه بتحيزات مصرح بها
ومهما كان الأمر، فإن المتابع للنظريات الحديثة يعلم الجهد والوقت اللذَين يتطلبهما تأليف كتاب مثل كتاب كلارك. ولعل الإشارة إلى هوامش الكتاب، والتي تصل إلى أكثر من 30 صفحة بخط صغير الحجم، تكفي للبرهنة على الجهد الضخم الذي بذلته المؤلفة في قراءة نصوص يتّسم كثير منها بصعوبة شديدة ويحتاج إلى مرجعية أو نظرية أدبية يفتقر إليها كثير من غير المتخصصين.
وينبه الدكتور عمرو عثمان أنه يجدر بقارئ الكتاب، أن يظل واعيًا بتحيّزات كلارك وهي تحيّزات تصرّح هي نفسها بها (وأن يستفيد قدر الإمكان من الأجزاء الوصفية التحليلية التي يُفترض فيها قدر أكبر من الموضوعية، وإن كانت موضوعية تنفيها، من ناحية المبدأ، النظرياتُ التي تتحمس لها كلارك نفسها وتدافع عنها.
للتذكير مراجعة كتاب (التاريخ والنظرية والنصّ: “المؤرخون والمنعطف اللغوي”) للمؤلفة إليزابيث كلارك، منشورة في العدد 39 من مجلة “تبيّن” (شتاء 2022، الصفحات 125-134)، وهي مجلة فصلية محكّمة يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا وتُعنى بشؤون الفكر والفلسفة والنقد والدراسات الثقافية.