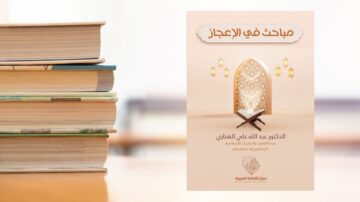في البداية يجب أن نعرض للبيئة التي مهَّدت لظهور نظرية الذكاء الوجداني ، فربما ساعد ذلك في تحديد الاستفادة الحقيقية منها.
لا يخفى على كل متعامل مع طفل ومراهق وشاب الأشكال المختلفة والمتعددة للتحديات المحيطة بالتربية؛ وذلك لسرعة التغير الشديدة وسرعة الحركة التي يتسم بها هذا العصر، فنحن نعيش اليوم في عصر صراع للحضارات كما يسمونه وصراع الثقافات واللغات والأديان، وما نحن ببعيد عن كل هذا.
ويكفينا النظر للتغيرات السريعة والمتلاحقة في نمط الحياة، وصعوبة التعايش بين الاختلافات، فالاختلاف في الدين يمثل صعوبة للتعايش في بعض الأماكن، والاختلاف في اللغة يمثل صعوبة أخرى، وهكذا عصر مليء بالتوترات والصراعات والبقاء فيه للأقوى، والأكثر ذكاء، والأسرع قدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات.
وتمثل العواطف والانفعالات جزءاً هامًّا جدًّا وأساسيًّا من البناء النفسي للإنسان. وقد أكدت الدراسات والأبحاث الحديثة بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظومة الوجدانية في تركيبة الإنسان معقدة ومركبة وشديدة المقاومة للتغيير، وهي تحدد معالم الشخصية الإنسانية منذ وقت مبكر في حياة الإنسان، وبيَّنت الدراسات أيضًا التي تناولت العلاقة بين الجوانب البيولوجية والسيكولوجية للوجدان أن كم الألياف العصبية وعددها المتجه من المراكز الوجدانية للمخ إلى المراكز المنطقية يفوق كثيرًا التي تسير في الاتجاه المعاكس. بمعنى أن تأثير الانفعال والوجدان على السلوك والتعلم يفوق كثيرًا تأثير العمليات المنطقية على السلوك والتعلم.
إذن الوجدان والتفكير متداخلان تداخلاً وثيقًا. وحتى يتمكن الطفل من اكتساب معلومة ما أو خبرة من الخبرات فلا بد أن تتوافر له الظروف الآمنة البعيدة عن التهديد والقلق حتى يزداد تركيزه وتزداد قدرته على استدعاء الخبرات السابقة، وبالتالي فهم الموقف والتعامل معه عقليًّا ومنطقيًّا.
وعندما تكون الخبرة مصحوبة بانفعال إيجابي كالفرح أو الإنجاز مثلاً يزداد إتقان المعلومة وحفظها وتخزينها في صورة واضحة يسهل استدعاؤها والاستفادة منها؛ وذلك لأن الناقلات العصبية في الدماغ البشري تفرز موادَّ كيميائية تعطي شعورًا بالراحة والمرح، وذلك مع الخبرة التي تعطي هذه الأحاسيس الإيجابية، فيسجل الدماغ هذه المعلومة، وكأنه يقول لنفسه: هذه المعلومة هامة احفظها وتذكرها واستخدمها مستقبلاً.
وتعتبر هذه المشاعر الإيجابية التي ترافق الخبرة بمثابة مكافأة ذاتية للدماغ، وهي التي تدعو العقل مستقبلاً لممارسة أشكال التفكير المختلفة كالابتكار والاستكشاف والإنجاز؛ لأن المخ في هذه الحالة يكون آمنًا.
إذا كانت الانفعالات المصاحبة للخبرة سلبية ومؤلمة كالتهديد والقلق والخوف، فإن المادة الكيميائية التي يفرزها الدماغ تجعل الفرد متحفزًا للرد بالمقاومة (مقاومة دخول المعلومة أو تعلم المهارة)؛ وذلك للمحافظة على نفسه، ويؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر والقلق، وبالتالي يتدنى الانتباه والتركيز والتعليم.
ومن هنا كان الذكاء الوجداني هو أساس التنمية العقلية والاجتماعية والمعرفية للطفل. وقد عرفه “دانيال جوليان” في كتابه الذكاء الوجداني بأنه: “القدرة على فهم الانفعالات، ومعرفتها، والتمييز بينها، والقدرة على ضبطها والتعامل معها بإيجابية”.
وقد أمكن تحديد مهارات الذكاء الوجداني التي يمكن تنميتها لدى الطفل فيما يلي:
– الاهتمام بتمييز الانفعالات (تسميتها هل هو فرحان – سعيد – خامل – غاضب – متوتر…).
– التحكم بردود الفعل العفوية (عدم التسرع بإعطاء رد الفعل).
– التعامل مع الضغوط الحياتية.
– تفهم انفعالات الآخرين ووجهة نظرهم.
– تفهم معايير السلوك المقبول وغير المقبول.
– تطوير نظرة إيجابية واقعية تجاه الذات.
ما الذي تنتجه هذه المهارات الوجدانية؟
يؤكد دانيال على أن تنمية هذه المهارات تسفر عن شخصية متزنة قادرة على تحمل المسئولية وتأكيد الذات، والمتفتحة والمتعاونة والقادرة على فهم الآخرين والقادرة على حل المشكلات، والقادرة على ضبط النفس في مواقف الصراع والاضطراب واتزان المشاعر والسلوك والفكر مثل التعرف، والقادرة على التواصل الفعَّال وتوقع النتائج المترتبة على السلوك.
الجديد في النظر لهذا الأمور القديمة الجديدة أنها تحولت لنهج “الخطوة خطورة”، بمعنى أصبح كل منها يتحول لسلسلة من المهارات التي يمكن لكل فرد التدريب عليها بسياسة الخطوة خطوة؛ فالذكاء، التفكير، الإبداع، حل المشكلات صار كل ذلك مهارات يمكن إتقانها جميعا.
ولكن كيف تحول الأمر؟
أسهمت دراسات الجهاز العصبي وتشريح المخ، وعلم النفس العصبي في التحول الكبير في النظرة للذكاء فقد أكدت قابلية المخ للتعديل الذاتي فينمو ويخبو من خلال التفاعل البيئي الثري، وهذا الثراء إنما يعني التنبيه والأمن.
وقد أحدثت هذه النتائج نقلة وتحول لمفهوم الذكاء من اعتباره قدرة عامة ثابتة (موروثة) إلى اعتباره إمكانية وطاقة دينامية نامية.
ظهرت بعض النظريات الحديثة ولعلَّ أهمها –بالنسبة لفكرة الذكاء الوجداني- الدراسات التي أفادت بأن الذكاء ليس أحاديًّا، بل متعددًا، وهذه النظرية (الذكاء المتعدد) توضح أن الفروق بين الأطفال ليست في درجة ما يملكون من ذكاء وإنما نوعية هذا الذكاء،
وقد توصل هوارد جاردنر إلى ثمانية أنواع من الذكاء:
1- الذكاء اللفظي (اللغوي).
2 – الذكاء التحليلي – الرياضي.
3 – الذكاء المكاني.
4- الذكاء الموسيقي – الإيقاعي.
5- الذكاء الحركي – الجسدي.
6 – الذكاء الاجتماعي (الخاص بالتعامل مع الآخرين).
7- الذكاء الانفعالي الذاتي (الشخصي).
8 – الذكاء البيئي.
ثم تأتي نظرية الذكاء الوجداني كالتقاء لبحوث ودراسات المخ التي أكدت أن المخ وجداني ينشطه الأمن ويحجمه التوتر، ونظرية جاردنر في الذكاء المتعدد الذي صار يتضمن أنواعًا من الذكاء الشخصي والتفاعل مع الغير.
وتشير بحوث الذكاء الوجداني أن 80% من إنجازات البشر مرجعها الذكاء الوجداني، بينما 20% مرجعها الذكاء التحليلي.
ويشمل الذكاء الوجداني خمسة أبعاد:
1. الوعي بالذات.
2. الدافعية الذاتية.
3. مقاومة الاندفاع.
4. التفهم وإدارة الوجدان.
5. العلاقات الاجتماعية.
إذن الأمر كله يصب في خانة التنمية الشخصية للتفاعل الإيجابي والتعايش مع الآخرين. وتجدر بنا الإشارة لنموذج السلوك الذكي الذي يتضمن 15 عملية عقلية معرفية ووجدانية -إذن العقل (معرفة ووجدان)-، وتتضمن هذه العمليات العقلية:
1- المثابرة.
2- مقاومة الاندفاع.
3- الاستماع بتفهم وتعاطف.
4- مرونة التفكير.
5 – التفكير في التفكير.
6 – السعي نحو الدقة.
7 – التساؤل.
8 – تطبيق الخبرات السابقة في مواقف جديدة.
9- التعبير بدقة ووضوح عن التفكير.
10- استخدام كل الحواس.
11 – الإبداع والخيال.
12 – الحماس للحياة.
13 – المخاطرة المحسوبة.
14 – المرح.
15- التفكير مع الآخرين.
علينا الآن أن نبحث سويًّا عن طرق لنعلم بها أبناءنا هذه السلوكيات خطوة خطوة. البداية بكل تأكيد هي:
– الحب للطفل.
– الاحترام للطفل.
– التقبل للطفل.
– بناء الثقة بالنفس والآخرين.
– إشاعة روح المرح والدعابة مع الطفل.
– بناء صورة إيجابية لدى الطفل عن نفسه.
– تشجيع الطفل على التعبير عن انفعالاته بدلاً من كبتها.
– ومحاولة الحوار الذي يشجِّع الطفل ليحكي باستفاضة عما يشعر به؛ وذلك لأنه أثناء هذا الحوار يدرك أبعاد مشاعره بوضوح أكثر، ويصبح لديه مع الوقت قدرة على التحكم فيما يثير لديه هذا النوع من الانفعال؛ لأننا في الحقيقة حين نتحدث نبدو كما لو أننا ننظر من الخارج لما نقول (أي لما نفكر – لما نشعر).
نساعد الطفل ليتعرف بـأمانة على نقاط قوته ونقاط ضعفه.
– الاستماع إلى الآخرين بفهم وتفهم، وذلك يسهم في تعميق الفكرة وصقلها، فالطفل الذي يعود ويتدرب على حسن الاستماع للآخرين يستطيع أن يبني أفكارًا جديدة على أفكار الآخرين، كما يستطيع توضيح وشرح تلك الأفكار، إضافة لأن الاستماع إلى الآخرين يخلص الطفل من تمركزه حول ذاته، فهو يبدأ في التعرف على مشاعر وأفكار الآخرين، ويبدأ في إدراك أن لهم من الأهمية مثل ما له، ولهم من الحقوق والواجبات مثل ما له، ويمكنه ذلك من زيادة وعيه بالمشكلات، ويفتح مداركه لوجهات نظر وبدائل أخرى. ويمكنه ذلك من دخول عالم الآخرين دون تحيز.
– ومن أكثر ما يفيد الطفل في تكوين نظرة إيجابية نحو الذات المعاملة الهادئة المتزنة، والتشجيع على ما يبديه من إيجابيات دون إفراط أو تفريط، كذلك مساعدة الطفل على إتقان مهارات مختلفة (رياضة – فنون – قراءة – ألعاب …).
– تعويد الطفل على تسجيله انطباعاته، آرائه، خبراته، انتقاداته والمشاركة من قبل الأهل في ذلك، وربما كان ذلك مفيدًا في نواحٍ عدة (التعبير الجيد – الوعي بذاته – فرص للنقاش – الفهم المتبادل – الشجاعة في إبداء الرأي – متابعة تطور التفكير والمعرفة والوجدان لدى الطفل – ربط الطفل بالكتابة وهي مهارة هامة جدًّا).
– تساعد الفنون على التطورات والنمو المتزن في حياة الطفل والأمر الهام هو التعبير في حد ذاته أي ممارسة الفن ذاته بغض النظر عن النتائج، فهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطره من أفكار ومشاعر وانفعالات. ولقد وجد علماء النفس علاقة بين أعمال الطفل الفنية والحاجات والرغبات اللاشعورية التي تؤثر في سلوكه وتوجهه؛ ولذا يسهم الفن في صحة الطفل العقلية والنفسية، ويرفع عنه الضغوط، ويعطيه فرصة لإظهار المعاني التي لا يمكن أن يعبر عنها عن طريق اللغة.
لنتأمل هذه الآية الكريمة معي: “وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” (النحل: 78). نحن نولد لا نعلم شيئًا، ولكن قد خلق الله -عز وجل- لنا أدوات التعلم: السمع، الأبصار، أما الثالثة فهي الأفئدة وهي جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب.
انتبه علماء الغرب الآن لمعظم التوترات النفسية وآثاره التي كادت تقوض مجتمعاتهم ما دعاهم للبحث عن حلول، فخرجت نظريات تعظم من أثر الوجدان والمشاعر في العلاقات والذي هو لدينا كمسلمين نسميه تزكية، ولسنا بحاجة لأن نعيره أسماء أخرى فهي الأخلاق التي تكفل للمرء التعامل الإيجابي مع الآخرين؛ لنصبح مجتمعًا كما أراد لنا رسولنا الكريم -ﷺ- “كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضًا”، ولعلنا ننظر للحديث الشريف “إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم” (أي العلم معرفة والحلم وجدان) بمهارات الخطوة خطوة؛ ولذا فهي نظرية قديمة حديثة.