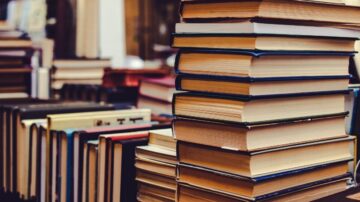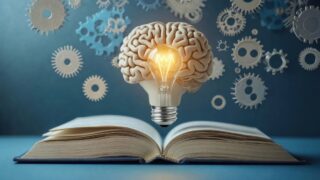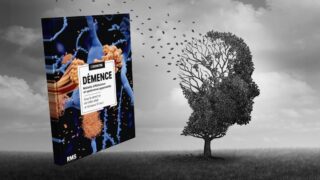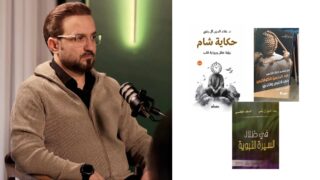من تتبع تاريخ الحركة الفكرية يلحظ أنه لم يكد القرن الأول للهجرة ينقضي حتى انكب المسلمون على التصنيف، ولم يتركوا بابا من أبواب المعارف إلا ولجوه، وبمضي الزمن أولعوا بجمع الكتب وسعوا لاقتنائها من كل حدب وصوب وبذلوا في سبيل ذلك أموالا طائلة، وتساوى في ذلك كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونساؤهم، فكان ذلك النواة الأولى فيما يعرف باسم “خزائن الكتب” أو المكتبات الإسلامية، وهذه المكتبات على ضربين، مكتبات عامة أسستها الدولة أو الملوك والأمراء في مختلف الأمصار، ومكتبات خاصة اقتناها أعلام المسلمين ومثقفوهم أو مؤسساتهم الوقفية العلمية، وفي السطور التالية أحاول التعريف بنشأة المكتبات الإسلامية ، وسيرة نفر من عشاق الكتب ومؤسسي المكتبات الأوائل، وثلة من المكتبات الإسلامية الذائعة.
نشأة المكتبات وانتشارها
كان ظهور المكتبات مصاحبا لنشأة الحضارة الإسلامية، ويدعم ذلك ما ذكره المؤرخون من أنه وجد في خزانة الأنبار عدة كتب بخطوط بعض الصحابة والتابعين، وقول محمد بن إسحاق (ت: 150ه): “كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة؛ جمّاعة للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة، تحتوي على قطعة من الكتب العربية في النحو واللغة والأدب والكتب القديمة، فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس بي وكان نفورا ضنينا بما عنده خائفا من بني حمدان؛ فأخرج لي قمطرا كبيرا فيه نحو ثلاثمائة رطل جلود فلجان، وصكاك وقرطاس مصر وورق صيني وورق تهامي وجلود آدم وورق خراساني، فيها تعليقات عن العرب، وقصائد مفردات من أشعارهم وشيء من النحو والحكايات والأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم”.[1]
وكلام ابن إسحاق يبرهن أن المسلمين شرعوا في وقت مبكر للغاية في استيراد لوازم المكتبات من أوراق وقراطيس وجلود من مختلف الأصقاع، ولم يكن هذا ممكنا لولا أن هذه المنتجات كانت تلقى رواجا من المؤلفين وعشاق جمع الكتب الذين شرعوا في اقتناء الكتب وتأسيس مكتباتهم الخاصة، وهكذا ظهرت المكتبات وانتشرت “انتشارا غريبا لم تألفه بقية الأمم قبل ذلك التاريخ وبعده” كما يشهد بذلك فيليب دي طرازي[2].
هواة الكتب وأصحاب المكتبات الخاصة
هكذا كانت النشأة الأولى للمكتبات أهلية مع اتجاه بعض الأفراد إلى اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات في المنازل، ولم تلبث الدولة ممثلة في الخلفاء والأمراء في إنشاء المكتبات العامة، وتغص المصادر وبطون الكتب بذكر بعض هؤلاء المولعين بالكتب الذين لم يخل منهم عصر، ومن هؤلاء:
- أبو عمرو زبان بن العلاء (ت:154 ه)، وهو أحد القراء السبعة وكان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارهم وعلومهم، ويقال أن كتبه كانت تملأ البيت حتى السقف لكنه تنسك فأحرقها في أخريات حياته.
- الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد (ت:207ه)، وهو واحد من أعظم مؤرخي الصدر الأول للإسلام، وكان من أكبر غلاة الكتب في أيامه، وقيل أن كتبه كانت تملأ ستمائة صندوق، ويقتضي حملها مائة وعشرين جملا.
- الموصلي، إسحاق بن إبراهيم النديم (ت: 235ه)، وهو أحد الذين تفردوا بالغناء والموسيقى وله اهتمامات باللغة والشعر، وعرف بما يمتلكه من نوادر الكتب؛ حتى روى عنه أبو العباس ثعلب حتى قال ” رأيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب كلها سماعه، وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منها في منزل إسحق ثم الأعرابي”.
- أبو بكر الصولي (ت: 335 ه)، أحد العلماء بفنون الأدب، وله عدة تصانيف، وأحرز شهرة واسعة في جمع الكتب وحسن تنضيدها، وقال عنه ابن شازان ” رأيت للصولي بيتا عظيما مملوءا بالكتب، وهي مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان كل صف بلون: فصف أحمر وآخر أخضر وآخر أصفر”.
- يعقوب بن يوسف (ت: 380 ه)، وهو أول وزراء الدولة الفاطمية، وكانت له خزانة كتب عظيمة بذل كثير من الأموال في تأسيسها لأنه كان يجمع من الكتاب الواحد بضع نسخ حتى يتمكن من مطالعته مرتادي مكتبته الكثيرين، وقد غالى في وصف خزانته المقريزي الذي امتدح ابن يوسف لأنه كان يشرف عليها بنفسه ويتعهدها بالرعاية.
- الوزير الأفضل بن أمير الجيوش (ت: 515 ه)، تولى إمارة الجيش في عهد المستنصر وكان مغرما بجمع الكتب حتى تجمع لديه منها خمسمائة ألف كتاب، ولما مات صودرت أملاكه فكان منها محبرة مرصعة بالجواهر قدرت قيمتها بأثني عشر ألف دينار.
- أسامة بن منقذ (ت: 615 ه)، وهو أديب وفارس عاش في كنف الأيوبيين، وكان جمّاعة للكتب واقتنى منها الكثير، وقيل أنها بلغت ما لا يعلم مقداره لأنه تعرض لضائقة مالية فباع منها أربعة آلاف كتاب فلم يؤثر فيها هذا البيع، وكان منكبا على القراءة يقرأ الخط الصغير كالشباب في شيخوخته.
- أحمد بن إسماعيل الحسباني (ت: 815 ه)، وهو أحد علماء دمشق في عصره، أكب على تحصيل الفقه وعلوم العربية واشتغل بالتأليف وكانت له مكتبة عظيمة جمع فيها من الكتب ما لم يكن لدى أحد غيره لكن هذه المكتبة بادت عام 803هـ في حريق هائل أسعره تيمورلنك مدة ثلاثة أيام متوالية احترقت معه جميع أسواق دمشق وحوانيتها ومكتباتها.
- عبيد الله جلبي (ت: 936 ه)، كان قاضيا بحلب اشتهر بالعلم وبذل أمواله في اقتناء المخطوطات التي ملك منها ما يقرب من عشرة آلاف مخطوط، ووضع لتلك المخطوطات فهرسا في مجلد ضمنه عنوان كل مخطوط وصاحبه وغير ذلك من التفاصيل، واستحضر إلى داره بعض المجلدين فجلدوا بعض المخطوطات ورمموا البعض الآخر.
- حاجي خليفة (ت: 1069ه)، صاحب (كشف الظنون) وكان يمتلك خزانة عدت من أعظم الخزائن جمعها من الشام والعراق والحجاز ومصر، ولولاها ما استطاع أن يضع سفره الخالد الذي حفظ لنا أسماء الكتب والعلوم والفنون.
يبدو من خلال هذا العرض الموجز أن المكتبات الخاصة أضحت ظاهرة شائعة قبل انتصاف القرن الثاني للهجرة، وما لبثت أن انتقلت من الطور البدائي المتمثل في حفظ الكتب في قماطر وصناديق داخل المنازل إلى أطوار أكثر تنظيما مع ظهور الإرهاصات الأولى للتصنيف مع الصولي، وأما الفهرسة والتجليد والترميم فالراجح أنها تأخرت بعض الشيء، من جانب آخر يبدو أن تأسيس المكتبات العامة حظي الخلفاء والأمراء على اختلافهم حتى عم العالم الإسلامي شرقه وغربه، وهو ما يضيق المقام عن الإحاطة به لذا سنكتفي بالإشارة إلى المكتبات العامة بكل من العراق والأندلس ومصر.
المكتبات العامة
اعتنى الخلفاء المسلمون بتأسيس المكتبات العامة لنشر المعرفة، وبدا هذا الاهتمام جليا منذ العصر العباسي الأول وتواصل عبر الحقب اللاحقة، وفيما يلي نقدم بيانا ببعض المكتبات الذائعة موزعة حسب التوزيع الجغرافي، ونستهل بمكتبات حاضرة الخلافة الإسلامية في الشرق.
– مكتبات بغداد: اختص الخلفاء العباسيون عاصمتهم بعناية خاصة وأنشأوا بها عددا من المؤسسات الثقافية لم تحظ بمثلها مدينة أخرى وفي مقدمتها (دار الحكمة) التي أقامها هارون الرشيد، وهي أرفع المكتبات الإسلامية شأنا وأقدمها زمنا، وكانت في بادئ الأمر مكتبة يشتغل فيها المترجمون لنقل المؤلفات الأجنبية من مختلف الفنون إلى العربية، ولما تولى المأمون زاد في عدد كتبها وخصص لها مخصصات عظيمة حتى لم يشاهد في بلد من البلدان مثلها وعين لها قيما (خازنا) لإدارة شئونها، وكان هدفه من وراء ذلك تسهيل المطالعة والتأليف والدرس.
ومن مكتبات بغداد الشهيرة مكتبة المدرسة النظامية التي أسسها نظام الملك وأوقف عليها أوقافا حتى بلغت نفقاتها نحو الستين ألف دينار، وممن تردد عليها الإمام الغزالي الذي كان طالبا بالنظامية. ومكتبة المدرسة المستنصرية وضمت كتبا لم يجتمع مثلها في مكان، وخصص لكل فن قسم منها، وبلغت فهرستها عدة مجلدات، وتعين بها خازن ومشرف لهذا الخازن ومناول للكتب وخصصت لهم مخصصات عينية يومية ورواتب مالية شهرية[3]، وخزانة الدار الخليفية التي أسسها الخلفاء العباسيون وأنفقوا عليها أموالا كثيرة لتجهيزها بالمخطوطات حتى ذاع صيتها ويروى أن الخليفة الناصر لدين الله عين مبشر بن أحمد أحد مشاهير الأدباء ليتولى انتقاء الكتب للمكتبة، وكان يعقد بالخزانة دروسا لتدريس كتب الفلسفة والمنطق والطب والحكمة. وخزانة الملك المستنصر وهو آخر خليفة عباسي بويع في بغداد وأنشأها في السنة الثانية من حكمه، وجلب لها الخطاطون المهرة لنسخ الكتب النادرة [4].
-مكتبات الأندلس : مثلما كانت بغداد مركزا لـ الثقافة الإسلامية في الشرق كانت قرطبة عاصمة الأمويين بالأندلس مركزا للثقافة في الغرب، حيث اشتملت على نحو ثمانمائة مدرسة وستمائة مسجد وسبعين مدرسة خاصة وكان بها مكتبة عامة تضارع في ضخامتها مكتبة الإسكندرية القديمة، وهي مكتبة المستنصر بالله في قصر الزهراء التي استحسنها ابن خلدون ووصفها بقوله ” وكان [المستنصر] يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار، ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه، وبعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني، وكان نسبه في بني أمية، وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين، فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق، وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم، وأمثال ذلك. وجمع بداره الحذّاق في صناعة النّسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد، فأوعى من ذلك كلّه، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده، إلاّ ما يذكر عن الناصر العباسيّ بن المستضيء، ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر …ونهب ما بقي منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة”[5]
– مكتبات القاهرة : أخذت القاهرة تشق طريقا لتصبح مركزا للثقافة الإسلامية منذ عهد الفاطميين، وأول من أظهر منهم اهتماما بالعلم العزيز بالله الذي حبب إليه جمع المخطوطات، واقتنى منها عددا طائفة عظيمة أفرز لها جانبا من قصره ودعاها “خزانة الكتب” ولم تلبث أن ذاع صيتها وأصبحت من أشهر المكتبات الإسلامية، وكان العزيز شغوفا بالإكثار من نسخ الكتاب الواحد فكان يشتري نسخا من الكتاب الواحد وكان يستأجر النساخون لنسخ الكتب الوحيدة، فكانت بالخزانة ثلاثين نسخة من كتاب العين للفراهيدي، وعشرون من كتاب تاريخ الطبري، ومائة نسخة من الجمهرة لابن دريد، واستمر عدد النسخ في الازدياد حتى بلغت نسخ تاريخ الطبري وحده ألفا ومائتين عند انقراض عهد الفاطميين، وبلغت نسخ المصاحف ألوفا. ولم يكن الحاكم بأمر الله بأقل شغفا من العزيز فقد أسس مكتبته التي اشتهرت باسم ” دار العلم” وأفرد لها مكانا مخصوصا وأوقف عليها أوقافا كثيرة، ورغم ذلك أغلقت هذه المكتبة.
إقرأ أيضا :
المدارس في الحضارة الإسلامية : أنواعها وخصائصها ومستواها العلمي
ولم يكن الاعتناء بتأسيس المكتبات حكرا على الفاطميين فقد أنشأ الأيوبيين ومن بعدهم المماليك مكتبات شهيرة، مثل: مكتبة المدرسة الفاضلية التي أنشأها القاضي الفاضل، ومكتبة المدرسة الكاملية التي أنشأها الملك الكامل ناصر الدين، ومكتبة المدرسة البهائية، ومكتبة المدرسة الظاهرية، ومكتبة القبة المنصورية ومكتبة المدرسة الناصرية، مكتبة المدرسة الطيبرسية وغيرها كثير.
الخلاصة، أن ظهور المكتبات صاحب ظهور الإسلام ذاته، وأن عموم المسلمين شرعوا في تأسيس مكتباتهم قبيل أن تفطن الدولة إلى ضرورة ذلك، ولعب العامل السياسي دورا حاسما في اندثارها فقد أحرق المغول مكتبات العباسيين في العراق، ونهب البربر محتويات مكتبات الأندلس، وقضى الأيوبيون على مكتبات الفاطميين.
[1] أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم، الفهرست، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ص 59-60.
[2] فيليب دي طرازي، خزائن الكتب العربية في الخافقين، 91/1 .
[3] محمود شكري الآلوسي، تاريخ مساجد بغداد وآثارها، بغداد: مطبعة دار السلام، 1927، ص 88.
[4] فيليب دي طرازي، المرجع السابق، ص 105.
[5] نقلا عن: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق إحسان عباس، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، بيروت: دار صادر، 1997، 386/1.
تنزيل PDF