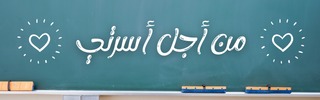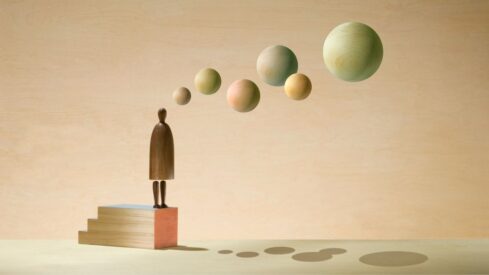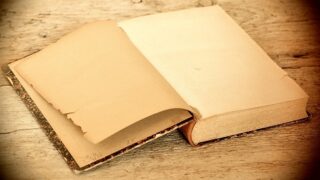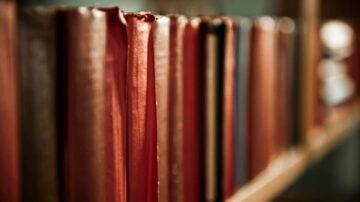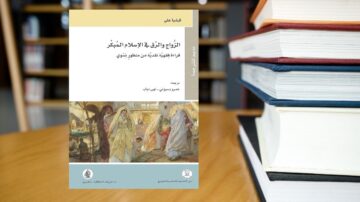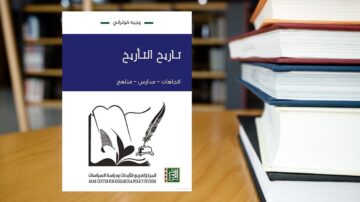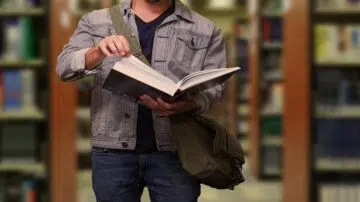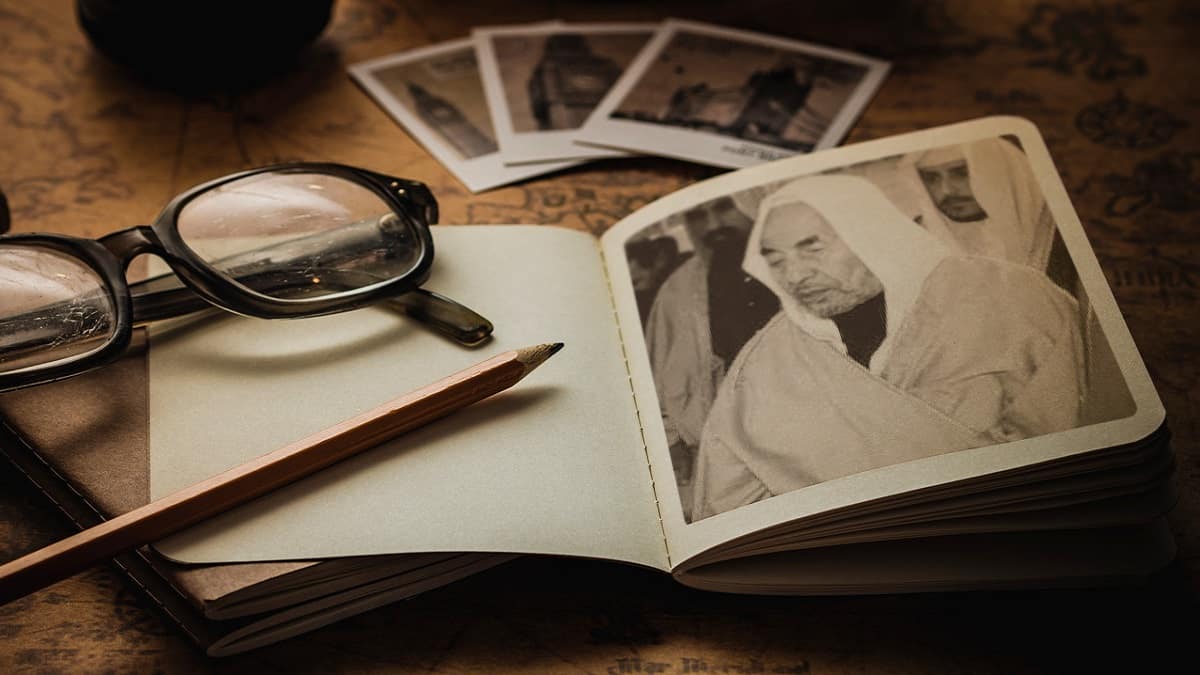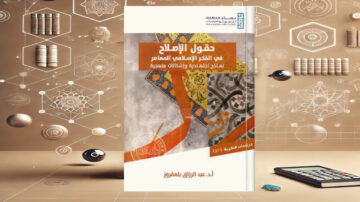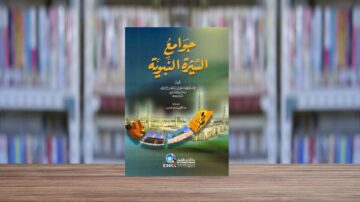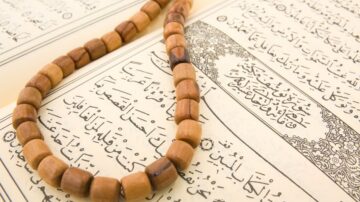ليست الأخلاق هي تلك الصِّفات التي يجب أن تظهر في السُّلوك، ولا حتىَّ في الفضاء الاجتماعي فيما يذهب النّاس ويجيئون، إنّها لا تنحصر هنا فقط؛ بل إنّ ثمَّة منطقة في الإنسان لم تمسسها الأخلاق بشكل فعلي وتأسيسي، وأقصد بذلك منطقة الذَّات المُفَكِّرة أو الأنا الباحثة عن المعرفة والمُنْهَمِمَة بالبحث العلمي في مجالاتها وميادينها، لذلك؛ فإنَّ القيم الأخلاقية قد انحصرت في السُّلوك وفي الفضاء العام، ونسي الإنسان الباحث عن المعرفة أنّ هذه القيم شرط في قوة المعرفة وفي التحقّق بالمعايير العلمية التي تثمر في البُحوث النّوعية وتؤثر في مجرى الأحداث.
وإذ بدا لنا، أننا نتقصَّدُ في هذه الإشارة، لفت النّظر إلى أخلاق التفكير، فإنَّنا نصرف سعينا إلى الإبانة عن ماهية هذه الأخلاق المتعلقة بتقنيات الاستدلال ومناهج البحث، وكيف يجب أن ينغرس الفكر في بحثه؛ ضِمن المعاني الأخلاقية؛ التي تعدُّ أقوى من الدُّربة المتكرِّرة على فنون البحث العلمي، ولمّا كانت أقوى؛ فهي ليست بمنتهى اليُسْرِ والبَساطة، لأنّها مُتعالقة ومتواجدة في عمق العقل وفي باطن القلب الإنساني؛ الذي جرى اختزاله خطأ في المشاعر والانفعالات، بسبب تبنّي النَّماذج الاختزالية والانفصالية في إرادة الاسْتِكْناه للاجتماع الإنساني من خلال علوم الإنسان.
العلوم غرضها هو التَّوجيه لما يجب أن يكون، من فهم حقيقي وتوظيف إيجابي
إنَّ أخلاق التفكير هي الأصل في وصايا البحث العلمي، التي تظهر في أهمية الموضوعات الجديرة بالبحث، وفي مكاشفة الأبحاث السَّابقة، وأهمية المنظور الموضوعي، ومطالب الطُّرق المعهودة والمسالك المحسوسة في أمور التَّهميش والاقباس وغيرها من المواصفات المشروطة؛ كي نستطيع أن نصنّف اجتهادًا من الاجتهادات؛ أنّه علمي أو نوعي. فهذه المواصفات في عمقها هي وصايا أخلاقية ومعانِ روحية رافعة وحافزة، ترتقي بالتَّفكير ومناهج البحث من الفَوْضَى والعبثية إلى النِّظام والمقصدية، فكما أنّ الأخلاق ترفع السُّلوك من الاعتياد إلى الارتقاء، ومن اللاَّمعنى إلى المعنى، كذلك الأمر في شؤون العلوم وكيفية الإبداع فيها.
لأنَّ العلوم وإن كان غرضها ونقطة انطلاقها هي الواقع وقوانينه، فإنَّ سيرها وغرضها إنّما هو التَّوجيه لما يجب أن يكون، من فهم حقيقي وتوظيف إيجابي، لما بين أيدينا من ممارسات أو وقائع، أي أنّ غَرضها هو قيمي توجيهي، فالعٌلوم الطَّبيعية أو الرياضية أو الإنسانية، أخطأت عندما فرضت الموضوعية بأسلوب طائفي واختزالي؛ فَفَضْلًا عن أنَّ الموضوعية مستحيلة وغير ممكنة؛ بصورة كلية، فهي خطوة من خطوات الحركة والبحث، مِيزَتُها أنّها معبر أو عبور من مصدر الوقائع – الذي يشترط مبدأ المسافة بين الوعي والعالم – إلى كيف يجب أن نُدرك الوقائع؟ وكيف يجب أن نفهم الوجود الطَّبيعي والإنساني؟ بالانتقال من الإدراكات الخاطئة أو اللاَّمنتظمة، إلى الإدراكات الحقيقية أو المنتظمة، فهي بهذا المعنى؛ أبحاث في القيمة وفي حفز العقل، على الحركة؛ من الشَّيء الذي يرغب فيه إلى الشَّيء الذي يجب أن يرغب فيه.
وهنا، نتبيّن الخلل المنهجي الذي غالط به التَّفكير الوضعي العقول، فهو وبحركة انتقالية لاشعورية طَابق بين الموضوعي والواقعي، بينما الموضوعية كما أشرنا هي شرط جزئي، لأن السُّؤال العلمي ليس غرضه التَّطابق مع الواقع، وإنما تشكيل أنساق معرفية علمية تعبر عن الصُّورة الإدراكية المُثْلَى لهذا الموضوع أو ذلك. إذن، فإن القول الجدير بالإقرار هنا، إنّ العلوم بأصنافها، هي قول في القيمة، وقول فيما يجب أن يكون، وما الذي يجب أن نرغب فيه حقا؟ وليس المرغوب كما هو سائد من أفكار عامة أو تاريخية أو علوم ذات سلطة مرجعية غير حقيقية.
وضمن هذا الخط الفكري والفلسفي الذي بات يتأسّسُ على مقولة: إن القيمة تستوعب سؤال العلم وبالتّالي فإن ثمة أخلاقًا للتَّفكير سابقة على إعمال العقل في الأشياء، كتب: باسكال إنجل 1954 ( Pascal Engel ) كتابًا هامًا هو”رذائل المعرفة: محاولة في أخلاق التفكير” ( les Vices du savoir Essai D’éthique intellectuelle )
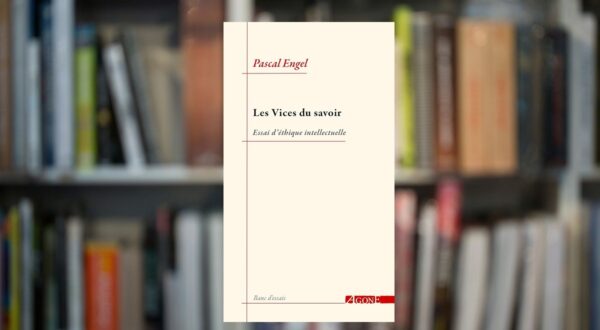
اعتبر فيه أن من جذور الخلل في أنظمة المعرفة المعاصرة – التي أورثت الفهم الآلي للكون وأرّخت لظاهرة الانفصال – بين التفكير والأخلاق -، إنّما هي معايير المنهج والبرهان التي صاغها رونيه ديكارت 1596/1650 ( René Descartes ) ورسّخ القول في تاريخ العلم؛ إنّها معايير معرفية برهانية، لا تتجذّر في نماذج مخصوصة؛ أو تتقيّد بأيّة اعتبارات أخلاقية خارج نطاق هذا الخطاب في المنهج؛ فالبداهة والتَّحليل والترَّكيب والإحصاء، أفعال عقلية باردة، ليس فيها حرارة الإرادة ولا شُعلة المعرفة؛ لقد تحوّلت هذه الشَّرائط المنهجية إلى حقائق منهجية ومعايير مُقْفَلة؛ فكانت النتائج هي بداهة نسيت تعقيد الواقع وتركيبه، ومدى الحاجة إلى التَّفاعل مع الأعماق العاطفية والوجدانية الفسيحة، وتحليل؛ أدَّى دوره، الذي يعادل في مدلوله؛ معاني التَّقسيم والتجزيء للعلوم، فكانت علومًا منفصلة جافّة ليس فيها دم الحياة، غير واعية بالتَّرابطات الخفية التي يتركَّب منها الكائن؛ بينما الحقيقة أنّها الأساس المكين في وحدته وتكامل مكوّناته.
وهكذا بقية المبادئ العقلية المنطقية البرهانية غير المتجاورة أو المتواصلة مع الاعتبارات الأخلاقية، لأجل هذا دعا “انجل” إلى إنشاء خط فكري يتولّى جَبْرْ هذه المشكلات وهذه السّلبيات العلمية، ورفعه إلى منزلة فرع معرفي؛ موضوعه الأحكام الأخلاقية الفكرية، باعتبارها فرعًا معرفيًا معياريًا يدرس قواعد التّفكير ومعاييره عامة بمنظور علمي- أخلاقي، يقول إنجل “وهنا نلتقي بالأحكام الأخلاقية للفضائل في التَّصنيفات الكلاسيكية، نجد أن الحكمة والحب والحقيقة والتّواضع الفكري والنّزاهة والمثابرة وغيرها من الفضائل، تعود إلى منافع العقل، وتلك التي لها علاقة بالحياة الأخلاقية عامة”[1].
فصل القيمة عن المعرفة أو العكس، لم يجلب إلى مشاريع التّنمية سوى القصور والتخلف
لنقل إذن، أنّ أبحاثنا العلمية كي تتحقَّق بالجودة، – علمًا أنّ الجودة مقولة أخلاقية -، لابد لها من تعليم أخلاق التفكير، قبل التفكير، ومن تنشئة العلوم على الفضائل؛ لأنها باعثة على حيوية التَّفكير وعلى قوة المثابرة من أجل الحقيقة، وهي الأكثر ضمانًا لأبحاث علمية موصوفة بالمشروعية والمصداقية.
أما إذا بقينا أُسَرَاءْ المفهوم الديكارتي للمنهج، بمعناه البرهاني المنفصل عن الاعتبارات الأخلاقية، فإنَّنا سنكون ليس فقط غير جدراء بالبحث العلمي وقوته، بل إننا نستمر في فعل النسيان لمنطق الروح العلمية في الثقافة العربية التي ترتكز على مبدأ: القيمة أسبق من المعرفة، والقيمة هي الرافع والحافز لارتياد آفاق علمية جديدة نجتاز بها الحدود المعرفية المرسومة. لقد انطلقت شعلة المعرفة في الثقافة العربية بسبب اعتبارات روحية وأخلاقية، فكانت حركة عُمرانية واسعة في التاريخ، استطاعت أن تتحقّق بالتّكاملية بين العلم والقيم، وكانت القيم هي الحافز الأسنى والرَّافع الأقوم لاستمرار العلوم وإنشاء المعرفة الجديدة، إنها الدّافع النّبيل في مراكمة التفكير العلمي وكتابة المتون الفلسفية والعلمية والفقهية التي لا زالت حروفها مصدرا للعقلانية والبحث والتّشريع. إن فصل القيمة عن المعرفة أو العكس، هو تفكير غريب عن كرتنا الأرضية ولم يجلب إلى مشاريع التّنمية سوى القصور والتخلف.