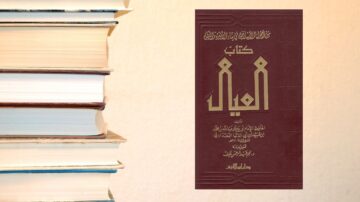الأسرة هي أول مؤسسة اجتماعية أنشأها الإنسان وأكثرها أهمية، ولا تدانيها في الأهمية أي مؤسسة مستحدثة، ولذلك أولاها علماء الإسلام عناية وأفردوا لها المصنفات في وقت مبكر، ومن هؤلاء الإمام الحافظ ابن أبي الدنيا (ت: 281 هـ) الذي وضع مصنفا بعنوان (العيال) تناول فيه المباحث الأسرية في عصره، وفيما يلي تعريف بالإمام ابن أبي الدنيا وكتابه الرائد.
الحافظ ابن أبي الدنيا: سيرته ومصنفاته
هو أبو بكر، عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي، كان من موالي بني أمية، وهو كوفي الأصل ولد في بغداد حاضرة الخلافة في جمادى الأول (208 هــ) وعاش بها، عاصر فيها ثلة من خلفاء بني العباس ابتداء من الخليفة المأمون وحتى المعتضد.
تلقى العلم على يد شيوخ عصره وهو دون العاشرة بتشجيع من أبيه المحدث الثقة محمد بن عبيد بن سفيان، وأقدم شيخ له سعيد بن سليمان سعدويه الواسطي، وسمع من : علي بن الجعد ، وخالد بن خداش ، وعبد الله بن خيران، أبو القاسم عبيد ابن سلام وطبقتهم. وبرز في علم الحديث إذ كان من الحفاظ، لكن مروياته كان عليها مآخذ إذ يروي الإمام الذهبي أنه ” يروي عن خلق كثير لا يٌعرفون، وعن طائفة من المتأخرين.. لأنه كان قليل الرحلة ، فيتعذر عليه رواية الشيء ، فيكتبه نازلا وكيف اتفق”[1]، ورغم ذلك فقد كان عالما موسوعيا وامتدحه علماء عصره وأثنوا على علمه وتبحره في العلوم المختلفة.
ويبدو أن سعة علمه وتعدد معارفه لم تكن خافية على الخلفاء لذلك عمل مؤدبا لغير واحد من أبناء الخلفاء كما ذكر الخطيب البغدادي، وقيل إنه كان مؤدب الخليفة المعتضد وابنه المكتفي، وهنا نلحظ أنه لم يكن لينفر من التقرب للخلفاء على عادة علماء عصره الذين كانوا يخشون التقرب من الخلفاء والأمراء.
كان ابن أبي الدنيا غزير التصنيف، وهو من أكثر مصنفي عصر التدوين تأليفا، له تآليف “نافعة شائعة مفيدة”، ذكر ابن كثير “أنها تزيد عن مائة مصنف[2]، وأحصى له الإمام الذهبي ما يربو عن مائة وستين مصنفا ذكرها مرتبة على حروف المعجم[3]، وليس أدل على كثرة مصنفاته من وجود مخطوط تراثي يدور حول أسماء مصنفاته لمؤلف مجهول[4]، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1974م إلا أنه أضاف إليه مصنفات أخرى استكملها من الفهرست وكشف الظنون ووفق إحصاؤه بلغ عدد مصنفاته 198.
وهذه المصنفات تقع ضمن التصنيف الحديثي فهي عبارة عن أحاديث وآثار ذكرها ابن أبي الدنيا متصلة بموضوعها، وهذا الاتجاه نحو التصنيف الحديثي يمكن تفهم دواعيه إذ عاش المصنف في عصر التدوين، وفيه بلغ علم الحديث الذروة وتبعه بقية العلوم الأخرى، من جانب آخر تقع هذه المصنفات ضمن حقول معرفية مختلفة، وأكثرها يقع ضمن:
- الزهد والرقائق، من مثل: القناعة، الزهد والتوكل، محاسبة النفس، العزلة، القبور وغيرها.
- التاريخ، ومنه تاريخ الخلفاء، التاريخ، تغير الزمان، أخبار ضيغم، أخبار الثوري، أخبار قريش، مقتل عثمان، مقتل الحسين.
- الفضائل: فضائل القرآن، فضل العشر، فضل رمضان، فضائل علي، فضل لا إله إلا الله.
- الفقه: الجهاد، الفتوى، الأمر بالمعروف، العقوبات.
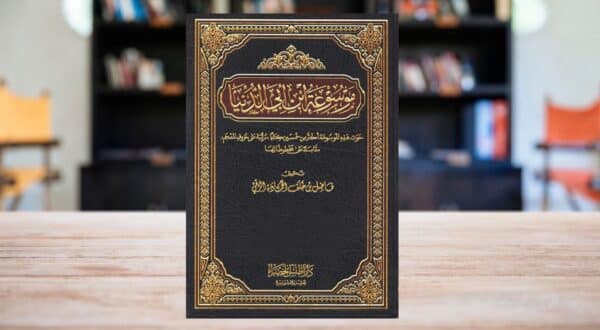
وإذا كانت تلك أبواب التصنيف معروفة وشائعة في عصره فإن المصنف انفرد بأبواب لا نجدها عند غيره وله فيها قصب السبق، وهي تنتمي إلى فئة التصنيف الاجتماعي ومن أمثلتها: كتبه “الجيران” و ” العمر والشيب” و ” العيال” اللذان لا نكاد نجد لهم نظيرا لدى معاصروه ولسنا نبالغ إن قلنا لدى من أتوا من بعده، وفي السطور التالية نتطرق إلى كتابه الأشهر “العيال” الذي حقق وطبع منذ أكثر من عقدين.
أهمية كتاب العيال
(كتاب العيال) لـ ابن أبي الدنيا هو أحد المصنفات المهمة في مجال التربية الإسلامية، لأسباب عدة:
- أولها أن المصنف عاش في القرن الثالث الهجري الذي عرف باسم “عصر التدوين” أي عصر تدوين المعرفة الإسلامية على اختلافها وبلغت فيه وفي القرن الذي يليه ذروة نضجها واكتمالها،
- وثانيها جمع المصنف بين التخصص النظري في علم الحديث وبين الخبرة التربوية العملية حيث اشتغل مؤدبا للأطفال في قصور الخلفاء، وبهذا الجمع قدم عملا موسوعيا.
- وثالثها كونه أول مصنف حول (الأسرة أو العائلة) ضمن المكتبة التراثية إذ قمنا بالبحث في كتب الببلوجرافيات الإسلامية المتقدمة والمتأخرة مثل الفهرست ومفتاح السعادة وكشف الظنون ولم نعثر على كتاب واحد يدرس موضوع الأسرة ويقاربه مقاربة كلية على نحو كتاب العيال، وإنما وجدنا مصنفات تعالج زاوية بعينها، إذ هناك كتب عدة تعالج موضوع فقد وممات الأبناء، وأخرى تتناول الجوانب الفقهية للأطفال مثل: شهادة الصبيان في الدعاوى القضائية وعباداتهم من حج وصلاة وثالثة تختص برياضة الصبيان (تربيتهم) وتأديب الأبناء العاقين وهكذا.
- ورابعها أنه أتي من أوله إلى آخره مسندا موصولا، والسبب في ذلك كونه وضع في عصر ازدهرت فيه علوم السنة واستقر تنظيمها.
بنية الكتاب ومنهجه
يحتوي الكتاب على (674) نصا موزعة على 35 بابا، اشتملت على كل ما يتعلق بالأسرة والعائلة في ذلك الوقت، فكان ابن أبي الدنيا يورد الأحاديث المرفوعة أولا ثم أقوال الصحابة فالتابعين، ثم يتبع ذلك بالشواهد الشعرية والنثرية مما قاله الثقات من الشعراء، وقد تطرق فيه لموضوعات كثيرة بعضها يختص بالزوجة ووجوب الرأفة بها ومداراتها وحقها على زوجها، وما يجوز لها من مال زوجها.
كما ناقش كيفية معالجة وقت فراغ الزوجة واقترح شغله بالأعمال المفيدة كالحياكة، وبعضها الآخر يتصل بالأبناء ومن أبوابه (العدل بين الأبناء والتسوية بينهم) و(العطف على البنين والمحبة لهم)، (تنقيز الولدان ومداعبتهم) ثم أفرد أبوابا للذكور تتصل باللعب وأخرى للإناث تتصل بالإحسان إليهن وتزويجهن، كما ناقش بعض المسائل المتصلة بتعليم الأبناء ومنها انتقل للجوانب الفقهية مثل حج الصغار وشهادتهم القضائية.
أما من حيث المنهج فقد تميز منهج ابن أبي الدنيا ببضع خصائص من قبيل:
- جودة الترتيب والتصنيف، فكما أسلفنا توزعت المادة النصية للكتاب على 35 بابا، والترتيب سمة عامة للحفاظ إذ يقوم عملهم على توزيع النصوص ضمن فئات وتقسيمات محددة بعد التثبت منها متنا وسندا.
- الإسناد، روى ابن أبي الدنيا النصوص والآثار والشواهد الشعرية مسندة إلى قائليها، وقد أوردها مبدوئة بصيغة الأداء “حدثني” و”حدثنا” وهي أرفع صيغة عند ابن الصلاح، لتضمنها سماع التلميذ من شيخه، وقصده إياه بالتحديث، فهي أقوى دلالة في التعبير من ” سمعت” ومن “أخبرنا”.
- عدم إيراد الحديث في موضعين بإسناد واحد، وإنما كان يورده من طريق آخر لأسباب منها، أن يخرج الحديث من حد الغرابة، وكذلك يفعل في الطبقة التي تليه والتي بعدها إلى مشايخه، ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة، يشتمل كل منها على معان متغايرة فيورده في كل مرة بطريق غير الأولى فيرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، والحسن إلى الصحيح.
- الدقة، كان الحافظ ابن أبي الدنيا دقيقا في أداء ما سمعه من مشايخه، فنلاحظ أنه يؤدي كما سمع، فإذا أراد أن يعرف برجل ما في السند كان يضعه بين فاصلتين ليفصل بينه وبين النص الذي سمعه، وليدفع بهذا التعريف الالتباس والوهم في السند.
- تجنب الشرح والتعليق والنقد، حيث أورد شيخنا النصوص كما سمعها دون توضيح لمعنى أو حل غامض وما إلى ذلك، ويبدو لنا أن تلك من آثار منهجية الحديث التي تأثر بها[5].
الخلاصة، يعد كتاب العيال فاتحة التصنيف الإسلامي في المجال الاجتماعي والأسري، وصدوره في القرن الثالث الهجري يحمل رسالتين، أولهما أن مؤسسة الأسرة باعتبارها نواة البناء الاجتماعي كانت تلقى اهتماما وعناية من العلماء المسلمين ولم ينصرفوا عنها نحو معالجة قضايا السياسة والحكم أو القضاء وغيره، وثانيهما أن علماء المسلمين استشعروا في وقت مبكر الخطر الذي تهدد الأسرة وقيمها مع اتساع الدولة والتواصل مع أمم وأعراق أخرى غير إسلامية من خلال الترجمة والاستعانة بالخبراء الأجانب ضمن الجهاز الإداري للدولة.