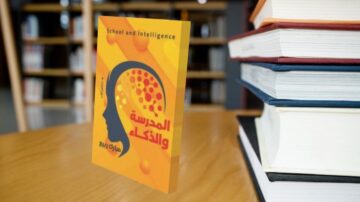“المدرسة والذكاء” دراسة تقع في متنها في 537 صفحة، توزعت – إلى جانب المقدمة والخاتمة – على خمسة أبواب موزعة على 19 فصلا. وقد أكدت المقدمة على نقد مدى مواكبة المدرسة العربية للتطور. صاحب الدراسة هو مبارك ربيع، وقد صدرت الدراسة عن دار النشر : المدارس للنشر والتوزيع-الدار البضاء-المغرب-2022.
المدرسة ورهان الحداثة
أما الباب الأول من دراسة “المدرسة والذكاء” (باتجاه مدرسة للذكاء)، فتناول في الفصل الأول (المدرسة ورهان الحداثة): العلاقة بين المدرسة والتطور، لينتقل إلى مفهوم الحداثة بصفته نتيجة لإرهاصات سبقته وأسست لدور العقل والعلم التجريبي واستقلال الحقائق العلمية عن الحياة الدينية دون نفي بالضرورة الايمان الروحي.
ويشير الكاتب إلى علاقة الحداثة التربوية (مؤسسات التعليم) والحداثة المجتمعية والتأثير المتبادل بينهما، ثم ينتقل إلى المدرسة المغربية ومدى اتساقها مع الحداثة، مشيرا إلى تأثير المدرسة الفرنسية في هذا الجانب مع نقد للمدرسة الفرنسية.
من أجل بيداغوجيا مقتصدة
الفصل الثاني: من أجل بيداغوجيا مقتصدة: العلاقة بين العملية التربوية وبين بعدين اقتصاديين هما: النفقات والمردود. ويناقش مراعاة مراحل النمو (تراتيبية المنهاج الدراسي) أو العامل الإرادي (الوعي بالقدرة الذاتية) والفاعلية التعليمية (توليد الانتباه والتركيز) وتقصير وقت التعليم (بتوظيف التكنولوجيا) إلى جانب عرض مشكلات تعليمية مثل الانقطاع عن الدراسة، تغيب المعلمين، اكتظاظ الصفوف بالأعداد الكبيرة من الطلاب و الاكتظاظ المعرفي (تعدد اللغات، وكثرة الاختبارات، وطبيعة الامتحانات.
الذكاء وظيفة مدرسية
الفصل الثالث: الذكاء وظيفة مدرسية: بعد تعريف الذكاء يعدد أنماطه (اللفظي اللغوي-المنطقي الرياضي-البصري-المكاني-الموسيقي الايقاعي- الجسدي الحركي- العلائقي) وينبه الكاتب إلى بعض آثار التكنولوجيا على العملية التربوية (تكريس المطلقية المعرفية، الخمول الذهني)، ثم يكشف مواضع القصور في التعليم العام والخاص.
الباب الثاني: عبر القيم -الفصل الأول باتجاه بيداغوجيا القيم، تعريف القيم ودينامياتها وثباتها النسبي وتأثير التكنولوجيا عليها نحو قيم إنسانية مشتركة ثم عرض دور القيم في البعد التربوي من خلال تاثير التكنولوجيا.
وفي الفصل الثاني تناول مؤلف كتاب “المدرسة والذكاء” العلاقة بين المدرسة والديمقراطية مع التأكيد أن الديمقراطية ليست فقط أمرا سياسيا، بل يؤكد على أن الديمقراطية تتمظهر في المجتمع من خلال جوانب عديدة ومن هنا ياتي دور المدرسة في تكريس هذه القيمة. ويؤكد أن العلوم كلها (اجتماعية وطبيعية) تنطوي على أبعاد ديمقراطية يمكن تكريسها في المدرسة عبر الممارسة لا التلقين.
في الفصل الثالث: من دراسة “المدرسة والذكاء”(المدرسة والعدالة التشاركية)، ويعرف بشكل عام مفاهيم العدالة والعدالة الانتقالية (تجاوز أخطاء الماضي) والعدالة التوزيعية مركزا على إشكالية مفهوم النقطة الوسطى بين طرفي الخصومة، ثم ينتقل لتطبيق كل ذلك على المدرسة.
في الباب الثالث (في النموذج البيداغوجي)-الفصل الأول (توجهات ومبادئ)، وبعد تعريف النموذج البيداغوجي، يتابع الأبعاد الخاصة بالنموذج من تخطيط، وممارسة وبخاصة انعكاسات التكنولوجيا على مدى ديمومة صلاحية النموذج واستفادته من النماذج العالمية الأخرى من بيئات مغايرة، في الفصل الثاني (المجتمع التربوي) والذي يتمثل في المؤسسات التربوية ثم يقارن بين حال هذه المؤسسات والمنشود منها، ثم يتابع التحولات القيمية في هذه المؤسسات، والتي تتبدى في بعض المظاهر مثل الخطاب المتداول في اللغة – التذمر و الانفعال- التنمر الالكتروني، الانتحار، العدوانية و التبريرية.
في الفصل الثالث (الانتاج التربوي) ويقصد به التراكم المعرفي في ميدان التربية والتكوين مع التركيز على ما يجب أن يكون، ثم يستعرض منشورات المغرب في هذا الميدان واهم الموضوعات المتداولة في هذه المنشورات ثم نقدها من حيث مناهجها ومضمونها وراهنيتها.
المدرسة والمعرفة
الفصل الرابع :الفضاء اللغوي مع التركيز على تفاعل اللغات وعدم قداستها، ثم امكانية تعددها في المجتمع الواحد ناهيك عن ثنائية الشفوي والمكتوب، سواء كان التعدد عفويا أو طبيعيا أو تعددا ضروريا (للتعامل مع الآخر)، أو اختياريا (من باب المثاقفة) ثم يطبق هذه النماذج على الحالة المغربية، في الفصل الخامس (المدرسة والمعرفة) جاعلا من مفهوم الإدراك بأنه “عتبة المعرفة”.
في الفصل السادس (المعرفة التطبيقية) والتي تستوجب مراعاة الظروف المحيطة في نطاق التعامل مع العلوم الطبيعية بشكل خاص، وهو مدخل لتفسير الفجوات في المعرفة التكنولوجية والتي تشكل المدرسة أحد حواضنها.

في الفصل السابع (المعرفة الانسانية) من دراسة “المدرسة والذكاء” ويناقش آليات تطور المناهج العلمية وتبايناتها تبعا لتباين الميادين المعرفية بخاصة في التعامل مع الظواهر من منطلق الحتمية والاحتمالية- الفصل الثامن (المعرفة الفنية)، وهي معرفة حدسية يتم التعبير عنها بلغة رمزية لكن لها بعدا تربويا يقوم به المربي أو المعلم من خلال تطوير المعرفة الجمالية والذكاء الجمالي (الإبداع) لينتقل إلى دور المدرسة ودورها في المعرفة الجمالية، وفي كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي
الباب الرابع –عبر تكنولوجيا تعليمية – الفصل الأول – باتجاه تكنولوجيا تعليمية وظيفية- ويؤكد هنا على أن ظاهرة التعليم عن بعد فتحت المجال للاستفادة من الطاقات الفكرية والتطبيقية للنخب العربية في الخارج ،ثم يناقش علاقة التكنولوجيا بالعنف المدرسي (التنمر الالكتروني) داعيا إلى التركيز على ما أسماه “الذكاء الوجداني” بهدف ضبط هذا العنف.
لتنمية الذكاء التكنولوجي
وفي الفصل الثاني من دراسة “المدرسة والذكاء” (الطريقة البيداغوجية) يتم التركيز على سؤال كيف؟ أي الخطة التفصيلية لتنمية الذكاء التكنولوجي ثم ينتقل إلى أهمية التعامل مع “الخطأ ” باعتبار معرفة الخطأ هي معرفة، و توظيف “اللعب” لفهم البعد البيداغوجي في الخطأ الذي وصفه “نيتشه” “العلم المرح”.
في الفصل الثالث (الزمن البيداغوجي) يتناول اندماج كلي للجهد البشري مع الفعالية التكنولوجية، الباب الخامس (أخيرا وليس أخرا – الفصل الأول (المتعلم قبل كل شيء) ويتم مناقشة دور الوالدين والمربين (مع التنبيه لجوانب قصورهم) مع التركيز على نفي مفهوم الحتمية وكيفية التعامل مع منظومة القيم العائلية والتراتبية والغيرية، الفصل الثاني- المعلم أولا حيث يحاول الباحث تحديد دور ومسؤولية المعلم، وشروط أداء وظيفته البيداغوجية من خلال اللاسلطوية، أما الخاتمة ففيها تأكيد أن بوابة عبور الفاصل بين مجتمعاتنا والمجتمعات المتطورة هي المدرسة والاهتمام بها، وهي مسؤولية جماعية.
منهجية كتاب المدرسة والذكاء
الجانب الأول:
أزعم أن هذه الدراسة (المدرسة والذكاء) تجميع لبحوث ومحاضرات ومقالات تتناول موضوعات تربوية نفسية، ولم تكن بحثا له خطة بحثية جرى تحديد موضوعها المركزي بداية ثم تحديد الخطوات المتسلسلة لإنجاز البحث، فموضوع الدراسة هو المدرسة من جانب والذكاء من جانب آخر، لكن موضوع الذكاء لم يحظ إلا بحوالي 35 صفحة من أصل 537 صفحة، بل إني عانيت كثيرا عند عرض مادة كتاب “المدرسة والذكاء”، لأن الموضوعات متناثرة مما يجعل من الصعوبة الأيجاز وربط الموضوعات ببعضها، ويكفي النظر في عناوين الفصول لنجد ان الذكاء يظهر في عنوان الباب الأول (كعنوان).
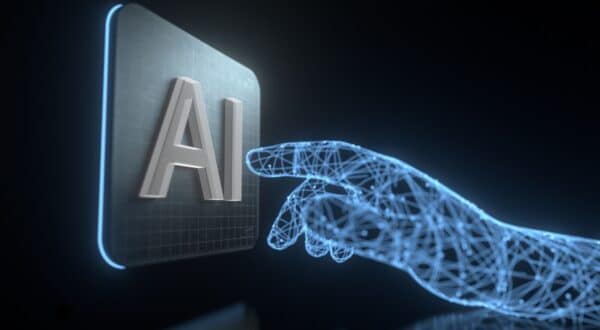
وفي الفصل الثالث من نفس الباب، وما تبقى يكاد أن يشمل كل الموضوعات ذات الصلة بدور المدرسة في المجتمع بغض النظر عن مدى الصلة بموضوع الذكاء، وهذه الوضعية لم تجعلني قادرا على تحديد المنهجية المستخدمة في الدراسة، فكل فصل يناقش جانبا معينا، لكن الرابط الواضح والمحدد بين الفصول تعذر علي إدراكه.
الجانب الثاني:
تعود أغلب المؤشرات الكمية المستخدمة في دراسة “المدرسة والذكاء” إلى عشر سنوات أو أكثر خلت (انظر مثلا الصفحات التي تظهر فيها هذه المؤشرات: 33 (التحضر)، 35 (الأمية)، 38 (الحضري والقروي) 39(شهادات المعلمين)- 40(التمدرس)- 80 (التكلفة المهدورة)-84(الانقطاع عن الدراسة)-85 (الاكتظاظ العددي)-و (تغيب المعلمين)..الخ، فهل يعقل أن هذه المؤشرات العديدة (9 مؤشرات) لم يجر تحديث أي منها أو بعضها ولم يتم قياسها من مؤسسات رسمية أو من بحوث أكاديمية أو من رسائل جامعية خلال 10-15 سنة؟
ويتعزز ذلك بالعودة لمراجع كتاب “المدرسة والذكاء” التي تعود معظمها تقريبا الى نفس الفترة 10 الى 15 سنة ماضية، مما يعني فقدان المواكبة لأدبيات الموضوع، وسأعطي مثالا على انعدام المواكبة، فمثلا مؤشر الانقطاع عن الدراسة فيه بيان رسمي من وزير التربية وبالتفاصيل لعام 2021-2022. ولو كان المجال يتسع لأوردت أمثلة أخرى على كل المؤشرات السابقة والتي أصابها تغير كبير، لكن الباحث بنى تحليلاته على بيانات تعود للعقد الماضي.
قيم مستقبلية لمدرسة المستقبل!!
الجانب الثالث: في صفحة 171- 176 من دراسة “المدرسة والذكاء” نجد العنوان “قيم مستقبلية لمدرسة المستقبل“: لم أجد ربطا واضحا ومحددا بين العنوان والمضمون، فإذا استثنينا الفقرتين الأولى والثانية، فإن الباقي لا يوضح ما هي “قيم المستقبل ولا ما معنى مدرسة المستقبل”، ولو عاد الكاتب لدراسة Valerie Hannon وعنوانه Future School (2022) لاكتشف أن ما كتبه لا يعدو “نصا عاما للغاية”، ولا يتضمن أي استشراف بالمعنى العلمي لملامح مدرسة المستقبل .
الجانب الرابع:- تكاد الدراسة (المدرسة والذكاء) تنحصر في مرجعيتها بخاصة في مجال المقارنة في النموذج الفرنسي (رغم اعتبار الباحث هذا النموذج أقل تطورا من غيره- (انظر ما يؤكد ذلك في الفقرة الأخيرة صفحة 36- وآخر صفحة 242 وأول صفحة 243)، فكان من الأولى للباحث أن يختار نموذجا متطورا لنتعرف على الهوة بين النموذج المغربي والعربي وبين التطور العالمي.
الجانب الخامس: حول موضوع اللغة في المدرسة (صفحة 309) يعيد عرض مناقشة مضى عليها “عقود ” حسب النص (الفقرة الثانية)، أي أن الباحث متشبث بعرض الموضوع استنادا لمعطيات لم تعد قائمة، فموضوع التعريب الذي يثيره الباحث لم يعد بالحدة قياسا للفترة (منذ عقود) التي يشير لها الباحث، ناهيك أنني لم أتمكن من إيجاد أية صلة بين موضوع التعريب وبين الذكاء، بل لم يرد مصطلح الذكاء نهائيا (عنوان الدراسة) من صفحة 309-316.
الجانب السادس: تجنب الباحث البعد السياسي في دور المدرسة التنموي أو في تطوير آليات الذكاء، انظر حول هذا الموضوع:
Ben Levin– Curriculum Policy and The Politics of What Should be Learned in Schools- Stroh & Roumeliotis-2007.
مناقشة الكتاب
تقع دراسة “المدرسة والذكاء” في صلب العلوم التربوية النفسية، ووحدة التحليل فيها هي المدرسة بذاتها وبتفاعلاتها المجتمعية وبوظيفتها التربوية والتعليمية، وتحاول الدراسة أن ترصد دور المدرسة في تطوير وظيفتها التنموية من خلال نموذج تربوي (بيداغوجي) يقوم على المعلم (المربي) والطالب (المتلقي) والمجتمع الوطني (وهو المغرب) والبيئة العالمية، أما الخيط الرابط بين هذه الأبعاد كلها فهو بشكل رئيسي التكنولوجيا بخاصة الذكاء الاصطناعي بتجسداته المختلفة.
وتحاول “المدرسة والذكاء” الإطلال ولو برفق على بعض المقارنات بين النموذج البيداغوجي المغربي وبين بعض النماذج مثل الياباني والفرنسي ليصل لبعض الاستنتاجات حول المشترك في النماذج البيداغوجية وبعض ملامح الخصوصية لكل منها ،وكل ذلك لتطوير الذكاء بأشكاله المختلفة لدى الطالب المغربي.
ومع أن متن كتاب “المدرسة والذكاء” يقع في 537 صفحة، إلا أنني أعتقد أن سمة “الورم” تغلب على سمة “السمنة” في هذا الكتاب، فالكتاب يكرر أفكاره كثيرا ولو بصياغات مختلفة، فمشاكل المدارس والمعلمين والطلاب والعلاقة بين هؤلاء والمجتمع وضيق ذات اليد في مخصصات المدارس المالية وثنائية الريف والحضر ومشكلات التعدد اللغوي وكيفية انعكاس كل ذلك على النموذج البيداغوجي في المدرسة المغربية تكاد تُطل في الجزء الأكبر من الكتاب بمضمون متكرر ولكن بصياغات مختلفة.

الجانب الآخر في هذه دراسة “المدرسة والذكاء” أن مؤشراتها الكمية في معظمها تعود لعقد كامل وأكثر، وهو ما يعني إغفال إيقاع التغير السريع في المجال التكنولوجي والزيادة الديموغرافية وانعكاسها في أعداد الطلاب في الفصل الواحد بشكل يفوق الواقع الذي تشير له المؤشرات الكمية المعتمدة في الدراسة،ويكفي الاشارة الى ان الفترة بين زمن المؤشرات المعتمدة وبين زمن نشر الدراسة عرفت المغرب (مجتمع البحث) زيادة سكانية بحوالي 7 ملايين نسمة، ناهيك عن اتساع انتشار التكنولوجيات الحديثة وبتسارع شديد (وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات والأتمتة في حقول عديدة…الخ)، وهو ما يجعل الدراسة متخلفة زمنيا في بياناتها التي تؤسس عليها النتائج،وهو ما يستدعي تحديث البيانات.
من العسير الإشارة لإضافات علمية يمكن توصيفها في إطار الجديد أو التجديد، دون انكار أن بعض “القبسات” تدل على باحث لماح في حدود معينة، وهو ما يتضح في معالجته لجوانب الابداع الفني أو ما أسماه بيداغوجيا الخطأ.
وما لفت انتباهي أن الباحث في دراسته هذه عن “المدرسة والذكاء” اختار للمقارنة نموذجين هما الياباني (بشكل محدود) أولا ثم اختار النموذج الفرنسي بتوسع اكبر رغم أنه يقر بأن هذا النموذج لا ينتمي لمجموعة النماذج البيداغوجية التي تتصدر نماذج الدول المتطورة، وهو أمر يبدو أنه نتيجة أن هذا النموذج هو الأقرب لمعارف الباحث وليس الأجدى للمقارنة مع النموذج المغربي، وهو ما جعل المقارنة غير ذات أهمية بيداغوجية، فلو اتسعت دائرة المقارنة بين المغرب مع دول من بيئات مختلفة وامكانيات متباينة ونماذج بيداغوجية متعددة لاستثمار منهج المقارنة لكان البحث أجدى.