قال الدكتور علاء الدين آل رشي، الباحث السوري، إن مالك بن نبي وضع للشباب دورًا مركزيًّا في عملية النهوض الحضاري، باعتبارهم طاقة متجددة تحتاج إلى توجيه سليم، ودعا إلى تحرير العقول من التبعية، وبناء وعي فكري وثقافي يُمكّنهم من صناعة المستقبل؛ لأن الرهان على الشباب هو رهان على أمة بأكملها، ونجاحهم في قيادة عملية التغيير هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمة لمكانتها الحضارية.
وأوضح الباحث السوري أن احتواء الشاب نفسيًّا وفكريًّا هو الضمان لعدم انحرافهم، وأن التعامل الصحيح مع الشباب يبدأ بالاعتراف بهم كقوة فاعلة، وليس مجرد متلقٍ سلبي؛ ولابد من فتح قنوات الحوار معهم، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، فلا شيء يُفسد نفس الشاب أكثر من التهميش أو الإنكار.
ود. علاء الدين آل رشي، باحث سوري مهتم بدور الشباب وتطويره، وأشرف على سلسلة أفكار رواد الإصلاح والتغيير في العالم العربي والإسلامي، وله عدة مؤلفات تتصل بالجوانب الفكرية والتربوية؛ منها: “في ظلال السيرة النبوية”، “امنح زواجك الحب الدافئ”، “من أجل النجاح”، “من تعاليم عبد الرحمن الكواكبي في التنوير والتحرير”، “التأزم الفكري في العالم العربي والإسلامي” (بالاشتراك مع د. عبد الكريم بكار)، “حكاية شام (رواية)”.. فإلى الحوار:
يمثل الشباب مرحلة مهمة من حياة الإنسان، وثروة كبرى للمجتمع.. نريد توضيح هذا؟
الشباب مرحلة وسطى بين الطفولة الغضة والكهولة الناضجة، وهو نبع الحياة الدافق بالحيوية، واللحظة التي يستوي فيها الإنسان على عرش قوته الجسدية، ورؤيته الفكرية الآخذة في التفتح. فما الشباب إلا تلك الفترة التي يتوهج فيها العقل ويسمو فيها الخيال، قبل أن تُكبل الأقدام بثقل السنون أو تحجب البصيرة بأغبرة الزمن.
فإذا كان الطفولة براءة صافية والشيخوخة حكمة متأملة، فالشباب هو تلك القوة الطامحة، المتوهجة بالرغبة في التجديد والتغيير، المغلفة بالفضول والجرأة على الحياة. إنها الثروة الكبرى التي لا يدرك قيمتها إلا أولئك الذين عرفوا كيف تُستثمر هذه المرحلة، لتبنى بها المجتمعات وتُرفع بها صروح الأوطان.
والشباب هم العمود الفقري للأمة، وطاقتهم هي وقود التقدم والنهضة. إنهم حملة مشاعل الفكر، ورواد الابتكار، وجنود السواعد العاملة. هم قادة المستقبل، ومفكروه، وصناع القرار.
فالشباب الذي يمتلك الوعي الكافي يتحول إلى قوة جبارة، قادرة على إحداث التحولات الكبرى في المجتمع، سواء أكان ذلك في مجالات العلم والتكنولوجيا، أم في ميادين العمل والاقتصاد، أم في جبهات الفكر والثقافة.
أما حين يُغيب دور الشباب أو يُهمل، فإن ذلك يكون بمثابة تعمد هدر الحياة نفسها، لأن الزمن الذي يضيع في إهمالهم لا يمكن استعادته.
إن الشاب الذي لا يجد سبيلًا لتحقيق طاقته ومعرفة ذاته، سرعان ما يتحول إلى قوة معطلة أو ربما هادمة.
العقل الشاب يتميز بالمرونة وسرعة الاستيعاب، فهو ينظر إلى الأشياء بعيون جديدة لا ترهقها قيود التقليد. يمتلك الشاب نزعة فطرية للبحث والسؤال، ورغبة دائمة في التجربة والاكتشاف. نفسيًّا، الشاب هو مزيج من الحماس والاندفاع، لكنه في الوقت ذاته هش أمام الإحباط، سريع التأثر بالبيئة المحيطة.
من هنا، تأتي أهمية توجيه طاقات الشباب في المسارات البناءة. إن احتواء الشاب نفسيًّا وفكريًّا هو الضمان لعدم انحرافه. ينبغي أن نعترف بأن الشباب ليسوا مجرد أدوات تنفذ الأوامر، بل عقول يجب أن تُحترم وطاقات تحتاج إلى الرعاية.
الشاب يمتلك نزعة فطرية للبحث والسؤال ورغبة دائمة في التجربة والاكتشاف
يبدأ التعامل الصحيح مع الشباب بالاعتراف بهم كقوة فاعلة، وليس مجرد متلقٍ سلبي. لابد من فتح قنوات الحوار معهم، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم. لا شيء يُفسد نفس الشاب أكثر من التهميش أو الإنكار.
إن على المؤسسات التعليمية والثقافية أن تلعب دورها في صقل عقول الشباب وتوجيه فكرهم. توفير بيئة محفزة تشجع على التفكير والابتكار، بدلًا من مجرد الحفظ والتلقين، هي الخطوة الأولى نحو بناء شخصية الشاب الواعي.
إن ذائقة الشباب الفنية والفكرية لا تُصنع قسرًا، وإنما ترتقي بتهيئة المناخ الملائم. فالثقافة الجيدة والفنون الراقية ليست رفاهية، بل غذاء للروح والفكر. علينا أن نفتح أمامهم آفاق الأدب والشعر والفنون الحقيقية، وأن نُبعدهم عن الابتذال الذي يفسد الذوق العام.
إن دور المثقف والمفكر هنا عظيم، إذ عليه أن يكون مرشدًا لا ناصحًا متعاليًا، ورفيقًا في رحلة التنوير لا جلادًا يحاكم الأفكار.
الشباب هو العمر الذي تُبنى فيه الأحلام وتُزرع فيه بذور المستقبل. علينا أن نعطيه حقه من الرعاية، ليعطينا حقنا من الإنجاز.
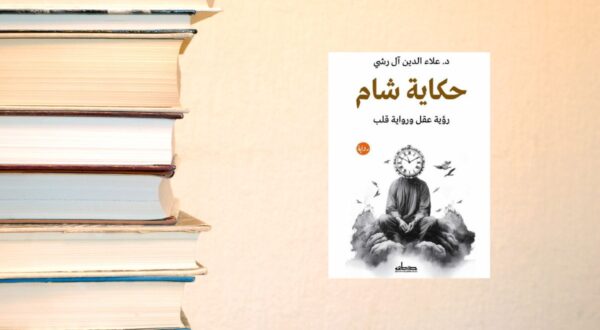
الدور المجتمعي للشباب.. كيف تتصورونه؟ وكيف نحقق ما يحتاج إليه من استعداد وتأهيل؟
الدور المجتمعي للشباب هو تلك الحركة النابضة التي تربط بين الفرد ومحيطه، فهو ليس مجرد اندفاع نحو العمل أو المشاركة، بل هو شعور عميق بالمسؤولية تجاه البناء والإصلاح، بحيث يصبح الشاب عنصرًا فاعلًا يُضيف ولا يُهمل، يبتكر ولا يُقلد، يبني ولا يهدم.
إن المجتمع، كالسفينة، لا تسير بسلام إلا إذا كان هناك من يتحمل أعباء قيادتها، ويواجه تقلبات أمواجها. والشباب هم الربان الأحق بهذه القيادة، إذا ما تأهلوا لحملها واستعدوا لتحمل مسؤولياتها. ولكن، كيف يتحقق هذا التأهيل؟ وكيف يُبنى الاستعداد لهذه المهمة العظيمة؟
إن أول خطوة في تأهيل الشباب هي غرس الشعور بالانتماء والالتزام تجاه المجتمع. حين يشعر الشاب أنه ليس غريبًا عن بيئته، بل جزء من نسيجها الحي، تتهيأ نفسه تلقائيًّا لحمل المسؤولية. غير أن هذا الشعور لا ينشأ من فراغ؛ إنه ثمرة تربية طويلة تبدأ من البيت وتنضج في المدرسة وتُصقل في ميدان الحياة.
التربية هنا الحضور المستمر للنموذج هي القدوة الحية التي يراها الشاب فيمن حوله. كيف نطلب من الشاب أن يتحمل المسؤولية، إذا كان الكبار من حوله ينفضون أيديهم منها؟ إن الشباب يتعلمون بالعين أكثر مما يتعلمون بالأذن، ويرون المثال أكثر مما يسمعون الكلمات.
أما من ناحية القابلية الذهنية، فيجب أن نُعد عقول الشباب لتقبل الأفكار الكبرى. لا يمكن للشباب أن يتحملوا مسؤولية مجتمع، وهم لم يتعلموا بعد كيف يطرحون الأسئلة الصحيحة، أو كيف ينقدون الظواهر السلبية بعقل واعٍ لا باندفاع أعمى. الفكر المستنير هو أول المؤهلات التي تُبنى بها شخصية الشاب المسؤول.
حجر الزاوية في بناء شخصية الشباب هي الجمع بين الحكمة والاختصاص والإخلاص. والزمن الذي نحياه اليوم يتطلب من الشباب مؤهلات لم تكن مطلوبة من قبل. ففي عصرنا هذا، لم يعد الاكتفاء بالمعلومات العامة كافيًا؛ بل صار لزامًا على الشاب أن يملك أدوات معرفية عميقة.
التأهيل الحقيقي للشباب هو ذلك التوازن بين العلم والأخلاق، بين الفكر والمهارة، بين الحماس والرؤية. حين نُقدم للشباب هذا المزيج المتكامل، نصنع جيلًا مستعدًا لحمل هموم المجتمع، وقادرًا على تحويل الأحلام إلى واقع
أولًا: المؤهل العلمي والتقني: إن امتلاك الشاب للعلم الحديث والتقنية المتقدمة، لم يعد ترفًا، بل ضرورة حتمية. العالم يتسابق بخطوات متسارعة، ومن يتخلف عن هذا الركب يضيع في هامش الحياة. إن التعليم الجيد لا يصنع فقط شبابًا مثقفين، بل يصنع قادة قادرين على صناعة مستقبل مشرق.
ثانيًا: المهارات العملية والحياتية: الشباب اليوم بحاجة إلى ما هو أبعد من الكتب والمقررات؛ يحتاجون إلى مهارات تُعينهم على التكيف مع التحديات: مهارة التواصل، فن القيادة، القدرة على اتخاذ القرار، وحسن إدارة الوقت. هذه المهارات هي الأساس الذي تُبنى عليه الشخصية العملية القادرة على الإنجاز.
ثالثًا: القوة الأخلاقية والوجدانية: مهما بلغ الشاب من علم ومعرفة، فإنه لن ينفع مجتمعه إن لم يُحكم بوصلته الأخلاقية. إن القيم مثل الأمانة، الصدق، والعدالة، هي أعمدة لا غنى عنها لكل من يتولى مسؤولية.
إن التأهيل الحقيقي للشباب هو ذلك التوازن بين العلم والأخلاق، بين الفكر والمهارة، بين الحماس والرؤية. حين نُقدم للشباب هذا المزيج المتكامل، نصنع جيلًا مستعدًا لحمل هموم المجتمع، وقادرًا على تحويل الأحلام إلى واقع.
على كل فرد منا واجب تجاه الشباب: أن نؤمن بهم، ونفتح لهم الأبواب، ونمنحهم الفرص، لأن الأمة التي تضيع شبابها، تضيع نفسها.
شبابنا يواجه الكثير من التحديات.. ما أبرز هذه التحديات الفكرية والاجتماعية؟
لا شك أن شبابنا اليوم يقفون في مواجهة تحديات كبيرة، بعضها يُثقل الفكر، وبعضها الآخر يُعكر صفو المجتمع. لقد أصبح الشاب في عصرنا هذا كالسائر على حبل مشدود، يتأرجح بين طموحاته وآماله من جهة، وبين عراقيل الواقع وضغوطه من جهة أخرى.
وعلى صعيد التحديات الفكرية، فإن أبرز ما يواجه شبابنا اليوم هو الصراع بين الفكر المتجدد والفكر المتكلس، بين الانفتاح المحمود والانجراف الذي يفقدهم هويتهم. فقد أضحى الشاب محاصرًا بموجات متلاحقة من المعلومات، لكنه نادرًا ما يجد من يُعلمه كيف يُميّز بين الغث والسمين. وهنا نشير إلى أبرز هذه التحديات:
1- فوضى الأفكار: في زمن تتدفق فيه الأفكار عبر وسائل الإعلام الحديثة، صار من السهل أن يقع الشاب فريسة للتيارات المتطرفة، سواء كانت تيارات تدعو إلى التشدد والانغلاق، أم تيارات تسلبه هويته وثوابته تحت شعار الحرية والتحرر. إن التحدي الأكبر هنا هو غياب “التفكير النقدي” الذي يُمكن الشاب من تمحيص الأفكار قبل تبنيها.
2- الانبهار بالآخر: إن بعض شبابنا باتوا ينظرون إلى كل ما يأتي من خارج حدودهم الحضارية باعتباره نموذجًا أعلى، دون أن يدركوا أن الاقتباس بلا وعي قد يُفقدهم أصالتهم. التحديث لا يعني القطيعة مع الهوية، بل يعني المزج الواعي بين التراث والانفتاح.
3- غياب القدوة الفكرية: يحتاج الشباب إلى رموز ملهمة ترشدهم في طريقهم، ولكن في زمننا هذا، قلَّت الشخصيات الفكرية التي تجمع بين الحكمة والبصيرة، وبرزت نماذج سطحية تُقدم نفسها عبر المنصات الحديثة، فتشوه وعي الشباب وتُضيّع بوصلتهم.
وأما على صعيد التحديات الاجتماعية، فهي لا تقل خطورة عن الفكرية، إذ تُحيط بالشباب ظروف تجعلهم في حالة اضطراب بين ما يطمحون إليه وبين واقعهم الذي يعيق تقدمهم. ومن أهم هذه التحديات:
1) البطالة وقلة الفرص: إن قلة فرص العمل وضعف الاهتمام بتأهيل الشباب عمليًّا، تجعلهم يشعرون بالعجز والإحباط. هذا الإحباط قد يقود البعض إلى الهجرة أو إلى الانحراف بحثًا عن طرق بديلة لتحقيق الذات.
2) التفكك الأسري: الأسرة هي الحاضنة الأولى لتكوين شخصية الشاب، لكن مع ضعف الروابط الأسرية وانتشار التفكك، بات الشاب يواجه الحياة بلا سند أو توجيه.
3) المبالغة في العادات والتقاليد: بعض المجتمعات تُثقل كاهل الشباب بتقاليد جامدة لا تتماشى مع العصر. هذا الجمود يجعل الشاب في صراع دائم بين التمسك بالموروث والبحث عن ذاته في عالم متغير.
4) ضغط الصورة الاجتماعية: لقد صار الشباب اليوم أسرى لمقاييس زائفة تفرضها منصات التواصل الاجتماعي؛ صورة الجسد، المظهر المثالي، والنجاح السريع. هذا الضغط يُشعر الشاب بالفشل، ويبعده عن الأهداف الحقيقية للحياة.
إن مواجهة هذه التحديات تبدأ بتعزيز وعي الشباب وتزويدهم بالأدوات الفكرية والاجتماعية اللازمة. فالعلم هو الحصن الحصين أمام فوضى الفكر، والأسرة الواعية هي الأساس في تربية شباب متزن نفسيًّا وفكريًّا. إننا بحاجة إلى مؤسسات تعليمية وثقافية تعيد بناء الشاب لا على أساس المعلومات فقط، بل على أساس القيم والأخلاق والقدرة على التفكير الواعي.
لا يجوز أن نترك شبابنا يواجه هذه التحديات وحده، بل ينبغي أن نقف إلى جانبه، نسانده لا نُعاتبه، نُرشده لا نُحبطه، حتى يصبح قادرًا على حمل راية المستقبل بثقة وثبات.
ما دور مؤسسات التربية والتعليم والتوجيه في مساعدة الشباب للتغلب على هذه التحديات؟
الحديث عن دور مؤسسات التربية والتعليم والتوجيه في مساعدة الشباب للتغلب على التحديات، يكاد يبدو حديثًا عن “المفروض” بدلًا من “الموجود”. ذلك أن مجتمعاتنا، مع الأسف، تعاني من اختطاف فكري وإداري يجعل مؤسساتها هياكل شكلية فارغة من معناها الحقيقي. كيف نُطالب الشباب بالتغلب على التحديات، ومفاتيح الحل نفسها ليست بين أيديهم، بل بيد دول وقوى تُسيطر على كل شيء، وتُوجه مسار الحياة وفقًا لأجندتها الخاصة؟
إنه لمن البداهة أن نقول: لا إصلاح للشباب قبل إصلاح مؤسسات المجتمع. فقبل أن نتحدث عن الدور التربوي والتعليمي لهذه المؤسسات، يجب أن نعالج أولًا “شرعية وجودها” و”فاعليتها”، لأن المؤسسة التي أُقيمت على أساس فاسد لا تُخرج إلا أفرادًا مُشوهين، وأجيالًا بلا بوصلة.
ولكن مع ذلك، دعني أضع “الحلول المثالية” على ورق، كما لو أن هذه المؤسسات قائمة حقًا بمعناها العلمي الحقيقي. إن المؤسسات التربوية والتعليمية ليست مجرد قاعات ومناهج، بل هي مصنع العقول ومربط القلوب.
أولًا: دور التربية والتعليم في بناء الوعي الفكري:
يجب أن تكون المدرسة والجامعة مكانًا لغرس مهارات التفكير النقدي عند الشباب. عليها أن تُعلمهم كيف يُميزون بين الحق والباطل، بين الفكرة البناءة والخرافة، بين الأصالة والانسياق الأعمى. إن المناهج يجب أن تتجاوز التلقين إلى الإبداع، ومن الجمود إلى المرونة الفكرية. لا يكفي أن نملأ عقول الشباب بالمعلومات، بل يجب أن نمنحهم أدوات التفكير والقدرة على السؤال والبحث.
ثانيًا: دور التوجيه والإرشاد في مواجهة التحديات النفسية:
إن التحديات التي تواجه الشباب ليست فكرية فحسب، بل هي أيضًا نفسية واجتماعية. من هنا يأتي دور التوجيه التربوي والمهني، الذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية. يحتاج الشاب إلى من يسمع له، ويُرشده دون أن يفرض عليه، ويُهيئ له طرق الحياة المختلفة حتى يجد مساره الصحيح.
ثالثًا: تعزيز الهوية والانتماء:
الشاب بلا هوية كالشجرة بلا جذور، تُقتلع بأبسط ريح. إن للمؤسسات دورًا عظيمًا في ترسيخ الهوية الحضارية للشباب، لا بمعنى التقوقع والانغلاق، بل بمعنى التوازن بين التمسك بالأصل والانفتاح على العصر. إن تعليم التاريخ الحقيقي للأمة، وربط الشباب بقيمهم وأمجادهم، هو الحصن الذي يحميهم من الذوبان أو الانسلاخ عن أنفسهم.
رابعًا: ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل:
من أهم ما يجب على مؤسسات التعليم أن تفعله هو إعداد الشباب للحياة العملية. إن تعليمًا بلا تأهيل، وشهادة بلا مهارة، لن تُخرج إلا جيوشًا من العاطلين الذين يئنون تحت ثقل البطالة. يجب أن تواكب المناهج احتياجات العصر، وأن تكون مخرجات التعليم مرتبطة بحاجات المجتمع الحقيقية.
خامسًا: بناء القيم الأخلاقية والإنسانية:
لا فائدة من علم بلا أخلاق، ولا من مهارة بلا قيم. إن المؤسسات التعليمية يجب أن تكون منارة تربوية تُغرس فيها قيم الأمانة، الصدق، والعمل الجماعي. هذه القيم هي الدرع التي تحمي الشاب من الانحراف والتخبط.
ولا يكفي أن نُطالب المؤسسات بالقيام بدورها، بل يجب أن نعيد بناء هذه المؤسسات من جذورها. فالإصلاح لا يبدأ من الأسقف، بل من القواعد. إننا بحاجة إلى مجتمعات تُقيم مؤسساتها على أساس العدل والشفافية والحرية، لأن المؤسسات المختطفة لا تُربي جيلًا، بل تُخرّج أتباعًا.
إن إصلاح الشباب وإعدادهم لحمل راية المستقبل، لا يُمكن أن يتحقق ما دامت بُنية المجتمع نفسها تحتاج إلى إعادة تأهيل. علينا أن نبدأ من هنا، ومن ثمّ ننتظر الثمار.
خبرات الشباب العملية بالحياة.. كيف تتكون؟ وما السبيل لترشيدها؟
إن الخبرات العملية للشباب ليست شيئًا يُكتسب صدفة، ولا هي نتاج اندفاع عشوائي، بل هي بناء يتطلب أساسًا فكريًّا متينًا، وعملًا دؤوبًا يضع أقدام الشاب على أرض صلبة. فالتجارب العملية في الحياة ليست مجرد مهارات مكتسبة من محاولات النجاح والفشل فحسب، بل هي انعكاس لمزيج من الفهم العميق للواقع، وربط الحاضر بجذور الماضي، مع رؤية استشرافية للمستقبل.

والخبرة في الحياة هي كالبناء الذي يبدأ بلبنة صغيرة، ثم يُشيد تدريجيًا. تبدأ الخبرات من المواقف البسيطة التي يُواجهها الشاب في بيئته اليومية: تفاعل مع أسرته، تجربته في دراسته، اندماجه في العمل التطوعي أو سوق العمل. ولكن السؤال الأهم هنا: على أي أساس تُبنى هذه الخبرات؟
إن التحدي الذي نواجهه اليوم هو أن الكثير من الخبرات العملية للشباب أصبحت قائمة على “المزاج” و”المُشاهدة السطحية” لمظاهر الحياة، مما يُعرضها للتشوه والانحراف. لقد غزت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حياة الشباب، حتى أصبحت مصدر إلهامهم الوحيد، بل صارت “الميديا” تُصور لهم التجارب كأنها لقطات خاطفة لا تحتاج إلى فكر أو جهد.
فإذا لم تُبنَ الخبرات على الفكر العميق والوعي الناضج، تحوّلت إلى خبرات مُفرغة، كزهرة بلا جذور، ما تلبث أن تذبل مع أو عاصفة.
ولا شك أن ترشيد هذه الخبرات العملية للشباب يتطلب حاضنة فكرية وثقافية عميقة، تُوجه مسار الشباب، وتُعيد ضبط البوصلة التي يقيسون بها تجاربهم. هذه الحاضنة تتشكل عبر:
1- بناء وعي متوازن:
يجب أن نغرس في الشباب القدرة على الربط بين الماضي والحاضر، بين التراث والانفتاح، ليكونوا أبناء زمانهم دون أن يُخاصموا جذورهم. إن العقل الذي يفهم تاريخه، يُصبح قادرًا على قراءة حاضره وفهم تعقيداته دون أن يُخدع بالمظاهر الخادعة أو الأوهام الزائفة.
2- مناهج تعليمية منفتحة:
إن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه شخصية الشاب. والمناهج يجب أن تكون أدوات للفكر لا قوالب جامدة، تُعلمه: كيف يُفكر، لا: ماذا يُفكر. مناهج تُعلمه أن يُحلل، ويستنتج، ويُبدع، دون أن يفقد احترامه لماضيه أو تجاهله لحاضره.
3- التجربة العملية الموجّهة:
لا تتشكل الخبرات من الكتب وحدها، بل من العمل والاختبار اليومي. ولكن التجربة العملية يجب أن تكون موجّهة لا عشوائية. ينبغي أن يتوافر للشباب مرشدون فكريون، يعلمونهم كيف يتعلمون من الفشل قبل النجاح، وكيف يُصوبون خطواتهم من كل خطأ يقع فيه الإنسان.
4- التقليل من تأثير الإعلام المضلل:
لا بد من تنوير الشباب بضرورة التحقق من مصادر المعلومات، والابتعاد عن التأثر الأعمى بما يُعرض في الميديا. إن تدفق المعلومات بشكل متضارب وغير دقيق يُشوش العقل، ويُفسد التجارب العملية، فيعيش الشاب في دوامة من التيه المعرفي.
5- توفير مساحات حقيقية للتجربة:
يحتاج الشباب إلى من يُتيح لهم الفرص لتطبيق ما يتعلمونه، سواء في ميادين العمل أو في مشاريع تطوعية تُكسبهم مهارات حياتية تُثري خبراتهم.
التواصل بين الأجيال قانون الحياة.. والتجارب الإنسانية ليست ملكًا لجيل
إن الخبرات العملية ليست مجرد مجموع ما يفعله الشاب، بل هي نتاج رؤية واضحة، وفكر سليم، وتجارب مُرشدة. ولذا فإن ترشيدها يتطلب منا أن نبني عقولًا تُدرك قيمة الماضي دون أن تُغلق الأبواب على الحاضر، وتُفهم الحاضر دون أن تُغرق في سطحياته. عندها فقط يُصبح الشاب قادرًا على مواجهة الحياة بوعي ناضج، ويدٍ تبني ولا تهدم، وفكر يُضيء ولا يُضل.
التواصل بين الأجيال لتبادل الخبرات وتكامل الأدوار.. كيف ترونه؟
إن التواصل بين الأجيال هو قانون الحياة الذي لا يُمكن كسره دون أن تنهار أركان المجتمع، لأن الخبرة تُبنى بتراكم الزمن، والحكمة تُستخلص من التجارب المتوالية. الشباب وحده لا يكفي، والحكمة وحدها لا تُجدي؛ فلا الحياة تسير بالاندفاع الأعمى، ولا الماضي يُعيد بناء نفسه دون أن تمتد إليه أيدٍ جديدة تعرف كيف تُكمله لا أن تُكرره.
لكننا، مع الأسف، في زمن أصبح فيه “الفجوة بين الأجيال” مقصودة، بل سياسة مُتبعة. يُزهَّد الشباب في حكماء الأمس، ويُزرع في عقولهم فكرة أن كل ما هو قديم يُمثل حجر عثرة في طريق التقدم. بحجة التحرر، يُهدم الاحترام، وبحجة رفض الأصنام، يُهان أصحاب التجارب. يُدفع الشاب إلى الظن أنه يبتكر العالم من جديد، وأنه لا حاجة له لحكمة من سبقه أو لمقام من يكبره.
غير أن الحقيقة أبسط وأعمق من كل هذا الزيف. فالتجارب الإنسانية ليست ملكًا لجيل دون آخر، بل هي تراث مشترك يُسلم فيه الكبير رايته للصغير، ليُكمل الطريق لا ليبدأ من الصفر. التلاقي بين الأجيال هو التوازن الضروري الذي يجمع بين حكمتين: “حكمة الماضي المتأنية” و”وعي الحاضر المتجدد”.
إذن، كيف نُعيد التواصل بين الأجيال؟
لا بد لنا أولًا من الاعتراف بأن التجارب لا تُنسخ بل تُبنى. إن رفض الماضي بحجة التحرر لا يعني التجديد، بل يعني قطع الجذور التي تُغذي الحاضر وتُثبته في أرضه. يجب أن يتعلم الشاب أن هناك فرقًا بين احترام الماضي وتقديسه، وبين هدمه وإقصائه.
إن الحكمة التي يحملها الكبار ليست أوثانًا تُعبد، بل تجارب مر بها الزمن وصقلتها الأيام، لتكون سراجًا يهتدي به السائر في ظلام الحاضر. فلا الشاب اليوم يُطالب باستنساخ ما مضى، ولا الكبير يفرض زعامته على جيل يريد أن يصنع حاضره. بل المطلوب هو هذا “التكامل في الأدوار”، حيث يضع الكبير حكمته في يد الشاب، ويضع الشاب وعيه في خدمة المستقبل.
إن بناء التواصل بين الأجيال يحتاج إلى وعي دقيق، وبناء التلاقي على أسس علمية وواعية؛ أهمها:
1) الشباب والاحترام الواعي: ينبغي على الشباب أن يُدركوا أن الاحترام للكبار لا يعني القبول الأعمى بكل ما يقولونه، بل هو احترام للتجربة الإنسانية التي لا تُشترى ولا تُختصر. أن يستفيدوا من الحكمة دون أن يُعطلوا عقولهم، وأن يُكملوا الطريق بتجارب مُحدثة لا بإنكار ما سبق.
2) الكبار والدور الإرشادي: على الجيل الأكبر أن يفهم أن الزمن تغير، وأن دوره اليوم هو “الإرشاد لا السيطرة”، و”التوجيه لا الهيمنة”. الحكمة لا تُفرض، بل تُقدّم برفق وتواضع، ليجد فيها الشاب سبيلًا يُضيء له ما التبس.
3) تكامل الأدوار لبناء المستقبل: إن أي واقع نريد تأسيسه بدقة، لن يتحقق إلا بالتقاء الرؤيتين: رؤية الماضي الذي يُعطينا الأسس، ورؤية الحاضر الذي يُعطينا الأدوات. التقدم لا يعني القطيعة، بل يعني البناء على ما هو ثابت والانطلاق بما هو مُتجدد.
إن القطيعة بين الأجيال ليست علامة على التحرر، بل على الانكسار. إنما الأمم ترتقي حين يضع الشاب يده في يد من سبقه، ليصوغ معًا “مستقبلًا مستنيرًا”. إن رفض الأوثان لا يعني هدم التجارب، ورفض الزعامات الموهومة لا يعني دفن الحكمة. إنما السبيل هو التلاقي، حيث يبني الشاب وعيه الجديد على أساس الماضي، ليُقيم صرحًا جديدًا يُعانق فيه حكمته وتجربته. فالحياة لا تبدأ من جديد، بل تُكمل نفسها على أيدي من يُحسنون البناء.

لمفكر الحضارة مالك بن نبي اهتمام خاصة بالشباب في عملية النهوض والتغيير.. نريد إلقاء الضوء على ذلك؟
كان مالك بن نبي، مفكر الحضارة الفذ، مدركًا تمام الإدراك أن الشباب هم العنصر المحوري في أي عملية نهوض وتغيير، بل هم طليعة الأمة ووقودها. فقد رأى أن مشكلات الحضارة لا تُحل إلا عبر بناء الإنسان القادر على فهم دوره ووعيه بمكانته، والشباب هم أنسب الفئات لتحمل هذه المهمة لأنهم يتمتعون بمرونة الفكر وحيوية الهمة.
أكد مالك بن نبي أن الشباب هم “المحرك الأساسي” للعمل الحضاري، لأنهم يُمثلون الطاقة الخام التي تحتاج إلى توجيه فكري وثقافي. وكان يرى أن مشكلة الأمة ليست في قلة الموارد أو القدرات، بل في غياب “الفكر الحضاري” الذي يُحفز الشباب ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم. لذا، فإن بناء الفرد الواعي المثقف كان حجر الأساس في مشروعه للنهوض الحضاري.
عوائق أمام الشباب
وقد بيَّن مالك بن نبي أن ثمة عوائق أمام الشباب، تتمثل في:
يرى ابن نبي أن القابلية للاستعمار تبدأ في العقول، فالشباب الذين يفقدون الثقة بأنفسهم وبأمتهم يتحولون إلى مجرد تابعين. إن تحرير العقول من هذه القابلية هو الخطوة الأولى ليصبح الشباب مؤهلين للنهوض.
2- الفراغ الفكري:
يحذر ابن نبي من الشباب الذي يُترك بلا مشروع فكري، لأن ذلك الفراغ يجعله عرضة للأفكار الهدامة أو المضللة التي تُفقده دوره في البناء وتُحوله إلى عنصر سلبي في المجتمع.
3- الانبهار بالغرب:
انتقد ابن نبي انبهار بعض الشباب بالنماذج الغربية دون وعي أو تمحيص، معتبرًا أن ذلك يُفقدهم شخصيتهم الحضارية ويُعطل مسارهم في التغيير. الحل برأيه هو الاقتباس الواعي الذي يُحافظ على هوية الأمة.
مسألة الشباب وبناء الوعي الحضاري
وأما فيما يتصل بمسألة الشباب وبناء الوعي الحضاري:
فيرى مالك بن نبي أن إعداد الشباب للنهوض يبدأ بتزويدهم بـالثقافة الواعية، وهي ليست مجرد تراكم للمعرفة، بل بناء فكري متكامل يُرشد الشاب إلى دوره ومسؤوليته في المجتمع. وركائز هذا الوعي تتلخص في:
1) تكوين شخصية الشاب الواعي:
لابد للشاب أن يتجاوز مرحلة التقليد ليصل إلى مرحلة الإبداع. فلا يمكن لشباب الأمة أن يقودوا عملية النهوض وهم عالة على غيرهم، يستهلكون ما ينتجه الآخرون دون القدرة على الإضافة.
2) ربط الفرد بمشروع جماعي:
شدد ابن نبي على أهمية انتقال الفرد من “الفكرة الفردية” إلى “الفكرة الجماعية”، حيث يصبح الشاب جزءًا من مشروع أمة يسعى إلى التغيير الحضاري لا إلى تحقيق ذاته فقط.
3) العمل والإنتاج:
ربط ابن نبي بين الفكر والعمل، فالشباب يجب أن يتحولوا إلى عناصر إنتاجية تُضيف إلى المجتمع وتُعيد بناءه. الفكر وحده بلا عمل يُصبح حبرًا على ورق، والعمل بلا فكر يُصبح جهدًا ضائعًا.
4) التكامل بين الماضي والحاضر:
من أبرز أفكار ابن نبي أن عملية النهوض لا تنفصل عن تاريخ الأمة وتراثها، لكن هذا لا يعني التمسك الأعمى بالماضي. فالشباب مطالبون بفهم تراثهم بوعي، والاستفادة منه لبناء المستقبل. إن الماضي يُلهم الحاضر، لكن الحاضر هو ميدان التغيير الحقيقي.
إن مالك بن نبي قد وضع للشباب دورًا مركزيًّا في عملية النهوض الحضاري، باعتبارهم طاقة متجددة تحتاج إلى توجيه سليم. دعا إلى تحرير العقول من التبعية، وبناء وعي فكري وثقافي يُمكّنهم من صناعة المستقبل. فالرهان على الشباب هو رهان على أمة بأكملها، ونجاحهم في قيادة عملية التغيير هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمة لمكانتها الحضارية.

