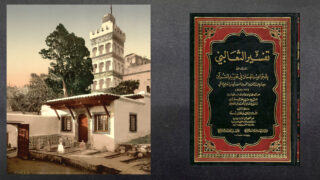على فترة من الزهو الاستعماري الفرنسي للجزائر، وبعد أماد من النصر الميكانيكي على الجزائريين المغلوبين المحروبين، والذين ذبلت أجسادهم وتناقصت أعدادهم بفواعل الإبادات العسكرية، والمجاعات والطواعين والأوبئة، وبعد أن استوى العود الفرنسي واستقام نصره الظاهري، أبت الأرض الجزائرية المعطاءة المباركة إلا أن تدفع من رحمها أفذاذا أحيوا الأمة بعد موات، وأعادوها لهويتها بعد فوات، وتلك رحمة الله التي أذنت ببقاء هذه الأمة الإسلامية ولو تكالب عليها من بأقطارها، كما جاء في الحديث الصحيح:”وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأنْ لا يُسلِّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمدُ، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُرد، وإني أعطيتك لأمَّتك أن لا أهلكهم بسنةٍ عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم منْ بأقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويسبي بعضهم بعضًا” [مسلم،2889]
فما انصرم القرن الاستعماري الأول أي القرن التاسع عشر الميلادي حتى أخرج الله في آخره أطفالا شبوا عن الطوق، وعانقوا العلم، وتمرّسوا بالقرآن وهيئتهم العناية الإلهية ليحملوا كلال الأمة ويبعثوها من جديد، ومن هؤلاء الرجال ابن باديس، والإبراهيمي، والعربي التبسي، وأحمد بن مصطفى بن عليوة، وأحمد توفيق المدني، وإبراهيم بيوض، ومحمد العيد آل خليفة، والطيب المهاجي، وغيرهم من رجالات الجزائر الأبرار.
ووقفتنا اليوم مع رجل فذ جاوز القنطرة في العمل للإسلام وهو الشيخ مبارك بن محمد الميلي الهلالي الجزائري الذي حلت ذكرى وفاته التاسعة والسبعين، حيث ولد الرجل بضواحي مدينة ميلة عاصمة الشرق الجزائري الأولى أيام الفتح الإسلامي المبارك، والتي أقيم بها أول مسجد في الإسلام بالجزائر على يد التابعي الجليل أبي المهاجر دينار سنة (59ه)، والذي يعد المسجد الثاني بالغرب الإسلامي بعد مسجد عقبة بن نافع بالقيروان.
أبصر مبارك الميلي النور يوم (22 ذو الحجة 1314ه الموافق 23 ماي 1897) ونشأ في أسرة فقيرة، حيث كان يتيم الأب، فرعاه جده وعماه، وألزموه خدمة الأرض، وحفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم الدينية في قريته الأولى، ولكنه غالب قدره ورام الاستزادة، فتوجّه إلى مدينة ميلة أين تتلمذ على يد الشيخ محمد بن معنصر الميلي، الذي حاطه بعنايته، وزوجه ابنته، واستمر يرعاه في دراسته في قسنطينة، وقد توفي شيخه مغدورا سنة (1928م)
كما قيض الله له أحد أثرياء ميلة وهو الشيخ مصطفى بوالصوف والذي افتداه من نظام الخدمة العسكرية الإجبارية، واستمر يؤازره بالنفقة وهو يعاني مشقة الدراسة في الزيتونة، والتي نال من جامعها المعمور شهادة التطويع، ثم عاد لقسنطينة ليباشر التدريس بها سنة (1925) تحت إشراف الشيخ عبد الحميد ابن باديس، وفي سنة (1926) انتقل إلى بوابة الصحراء الجزائرية أي مدينة الأغواط ليفتتح بها مدرسة للتعليم العربي الحر، التي سمُيت بمدرسة الشبيبة، وبقي هناك سبع سنوات كانت خيرا وبركة، وأسس هناك أيضا ” الجمعية الخيرية الإسلامية” لتكون ظهيرا للعمل التعليمي العربي الذي تكرهه فرنسا وتحاربه بكل قوة وحيلة لتعطيل مسيرة النهضة الجزائرية.
يقول علي مراد:” أقام بالأغواط سبع سنوات حيث طبع حياة هذه الواحة بعمق، وخلال هذه الفترة عمل على نشر تعليم عربي عصري استهوى الشبيبة، وسعى إلى تبسيط المذهب الإصلاحي بتصميم نادر، ونشره في وسط تقليدي شديد الارتباط بالزوايا الطرقية”.
أسهم مبارك الميلي بقوة في بناء وتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي وهبها قوته وكهولته، وعلمه، وماله، وليله ونهاره، وحله وترحاله، حتى أتى عليه المرض مبكرا، فقضى ولم يمض له إلا أربعة عقود ونيف، شأنه شأن شيخه عبد الحميد بن باديس الذي قضى بعد واحد وخمسين عاما فقط.
وبعد مدينة الأغواط عاد إلى مدينته ميلة ليباشر عمله التعليمي والإصلاحي، وتولى التحرير والكتابة المستمرة في جرائد جمعية العلماء المتوالية وهي السنة النبوية، ثم الشريعة المحمدية، والصراط السوي، والتي نُكبت تباعا بالوأد والتعطيل من الإدارة الفرنسية الظالمة، وأخيرا رأس مبارك الميلي تحرير الجريدة الباسقة السيارة أي جريدة البصائر، والتي تعد أعمدتها قطعا نادرة في الكتابة الأدبية والمقالة الصحفية شأنها شأن مجلة الرسالة المصرية لعبد الحميد الزيات عليه رحمة الله.
ومن قبل فقد أسهم ومنذ نشأة الصحافة الإصلاحية في أواسط العشرينيات بالكتابة في صحفها كالمنتقد والشهاب للتين أسسهما عبد الحميد بن باديس، حيث كانت له مقالات ومطارحات في مختلف القضايا التي أهمّت النخب الفكرية، وخاصة ما تعلق بنقد الميراث الطرقي في الجزائر، كما كتب في صحف مشرقية منها مجلة الرابطة العربية المصرية، ومجلة المنهل التي تصدر بالمدينة المنورة.
وقد ظل مبارك الميلي رجلا جامعا بين الفكر والعمل، فبالإضافة لأعماله العلمية والتعليمية في مدارس الجمعية، ونواديها، وخاصة النادي الإسلامي بمدينة ميلة، ودروسه المستمرة بجامعها الذي أسسه بذاته، فقد أشرف على إدارة مالية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وجال وهاد الجزائر ونجودها وسهلها ووعرها خطيبا مصقعا داعيا للإنفاق على التعليم العربي الحر، بل وتقحّم الأسواق الشعبية مخاطبا العامة بما تفقه، وله في ذلك المواقف والنوادر العجيبة المذكّرة بسيرة الدعاة الأفذاذ أمثال حسن البنا عليه رحمة الله.
وبعد فاجعة وفاة الإمام عبد الحميد بن باديس في (16أفريل 1940) والتي ترافقت والنذر المتصاعدة للحرب العالمية الثانية تولى الميلي الإشراف على الجمعية بقسنطينة، ورافقها في أحلك الظروف، أين غُلت الأقلام وأُغلقت المدارس، وناء كلكل الأحكام العرفية على الجزائر، فسوّد وجه النهار وآخره، وطمس الليل من شفقه إلى غسقه، ولم تكن تلك الأحكام الجائرة التي اتخذتها فرنسا ذريعة لكسر كل صوت حر إلا تعويضا عن هزيمتها المذلة أمام الألمان النازيين، ولم تمض خمس سنوات من هذه الهموم المتوالية حتى أتت على الرجل المعطاء فتوفي في (25 صفر 1364هـ الموافق 9 فيفري 1945م) بعد معاناة مستمرة مع مرض السكري.
يعتبره ولده محمد أحد أركان الثالوث الأقوى والأكثر فاعلية في الإصلاح، وهم ابن باديس والإبراهيمي والميلي، فهم يشكلون حقيقة النواة المذهبية للحركة الإصلاحية، وهو باكورة المدرسة الباديسية في الشرق الجزائري، فهو الرأس المفكر للحركة الإصلاحية وفيلسوفها، لأنه انفرد بوضع وثيقتين أساسيتين وهما إعادة الاعتبار للتاريخ الوطني بكتابه” تاريخ الجزائر في القديم والحديث”، وقد أشاد ابن باديس بهذا الإنجاز الرائد الذي أعاد للجزائر هويتها التاريخية التي حاولت فرنسا طمسها بمختلف السبل، فكتب مقرضا مهنئا:” الحمد لله أخي مبارك سلام ورحمة، حياك الله تحية من علم وعمل وعلم، وقفت على الجزء الأول من من كتابك “تاريخ الجزائر في القديم والحديث” فقلت لو سميته “حياة الجزائر” لكان بذلك خليقا، فهو أول كتاب صوّر الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية، بعدما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك، وقد نفخت في تلك الصورة من روح إيمانك الديني والوطني ما سيُبقيها حية على وجه الدهر، تحفظ اسمك تاجا لها في سماء العلا، وتخطّه بيمينها في كتاب الخالدين.
أخي مبارك! إذا كان من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بمن أحيا أمة كاملة؟ أحيا ماضيها وحاضرها، وحياتها عند أبنائها حياة مستقبلها”.
وأما الوثيقة الثانية، فهي رسالة” الشرك ومظاهره” والتي أعاد بها الاعتبار للمذهب السلفي في الاعتقاد، وانتقد فيها المظاهرة الفلكلورية المصاحبة للتصوف وهو منها برئ، وكان للرسالة أصداؤها وآثارها الكبيرة في تقويض عديد المنكرات الأخلاقية والموبقات الشركية التي قعدت بالأمة دهورا عن الرقي والنهضة، فرحمه الله وعلماء الجزائر والأمة جمعاء وتقبلهم في الصالحين.