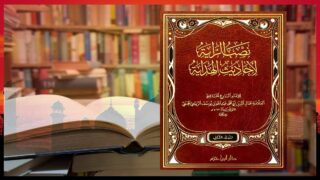كانت أرض الكوفة زمن الإمام أبي حنيفة النعمان نموذجا للاحتدام المعرفي الذي لا يهدأ، خاصة بعد أن شابت بساطةَ الدين ضروبٌ من “الكلام”، وألوان من الجدال العقلي التي شوشت أذهان الناس. فكان الكوفي خارج بلدته بحاجة إلى تحديد موقعه ضمن خارطة مشتعلة، كما حدث مع الإمام أبي حنيفة بمكة إثر لقائه بعطاء بن أبي رباح لأول مرة، حيث سأله: من أين أنت؟
قال: من أهل الكوفة.
قال عطاء: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم شيعا؟
فرد الإمام : نعم
فسأله: من أي الأصناف أنت؟
قال : ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يُكفر أحدا بذنب.
فيقول عطاء: عرفت فالزم !
إدراك أبي حنيفة للبلقنة التي طالت حتى مسائل الاعتقاد، خاصة وأنه جرب المناظرة مع الفرق المختلفة، دفعه لأن يختط لنفسه منهجا متفردا، سواء في تكوينه العلمي أوفي مجالسه، بل حتى في علاقته مع طُلابه. ويرجع الفضل لهذا المنهج في انتشار فقه أبي حنيفة الذي شرّق وغرّب، كما يقول الدارسون. أما الكثرة فليست مزية في حد ذاتها إن لم تكن رديفة للنوعية الفريدة من حملة العلم.
امتاز أبو حنيفة بشخصية قادرة على استيعاب معطيات بيئته الاجتماعية، والتفاعل معها تأسيسا لمشروع فقهي يتسم بالمرونة، وتوسيع مجال حركة الفقيه بما يخدم مصالح الناس وطرق تعاملهم. فبالإضافة إلى ما تمتع به من صفات خلقية، وكفاءة علمية يكشفها منهجه في تقرير مسائل الاجتهاد، فإن امتهانه للتجارة مكّنه من خبرة واسعة في معاملة الناس وإدارة النقاش بصبر وتحمل، في جو محتقن كثر فيه الحُساد والوشاة.
كانت مجالسة أبي حنيفة حصيلة جهد لم يقتصر على التدريس وإلقاء المسائل، بل شمل أيضا تتبع أحوال الطالب وتدبير معاشه. فكان يُخصص من تجارته إعانات مالية للطُلاب الذين يتلمس بحدسه صدق إقبالهم على العلم، ويحثهم على التفرغ لطلبه مقابل سد حاجاتهم المعيشية.
يقول تلميذه أبو يوسف يعقوب:« كنت أطلب الحديث وأنا مُقل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام، فقال لي: يا بني لا تمدن رجلك معه، فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، واخترت طاعة والدي، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال- حين رآني-: ما خلّفَك عنا؟ قلت: طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي صُرة فيها مئة درهم وقال: أنفق هذا، فإن تمّ فأعلِمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي مئة أخرى، وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام، كأنه كان يُخبر بنفادها، حتى بلغتُ حاجتي من العلم».
ولم يقتصر الأمر على طُلابه، بل كان يشجع كل من يلمس فيه استعدادا لتعلم الحديث والفقه، ويجتهد في تأكيد الحاجة إليه وتعزيز صلته بدقائق الحياة اليومية. زاره مكي بن إبراهيم وهو أحد شيوخ البخاري، وكان تاجرا، فقال له الإمام: أراك تتجر والتجارة إذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير؛ فلِم لا تتعلم العلم ولم لا تكتب؟ يقول مكي: فلم يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه شيئا كثيرا.
بعد تخليص الطالب من هَم المعاش، يُمهد الإمام سبيل التعلم بأسلوب فريد، يتجاوز التلقي السلبي المعتاد إلى المشاركة في بناء الدرس، وتذكية التنافس بين الطُلاب لحل المسائل وتقليب النظر في النوازل. فكان يعرض المسألة عليهم ويتجادل معهم في حكمها، ثم يدلي كل برأيه بعد نقاش وجدال يعلو ضجيجه أحيانا داخل المسجد. وفي الختام يعرض الإمام خلاصة الرأي الذي أفضى إليه ذلك، فيرضاه الجميع. أما الفائدة من هذا الأسلوب فيُوضحها الشيخ محمد أبو زهرة بالقول:« والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والمتعلم معا، وفائدتها للمعلم لا تقل عن فائدتها للتلميذ. وإن استمرار أبي حنيفة على ذلك النحو من الدرس جعله طالبا للعلم إلى أن مات، فكان علمه في نمو متواصل، وفكره في تقدم مستمر.»
زيادة على التثقيف المزدوج للطالب والمعلم، فإن المسألة الفقهية التي يتم تقريرها على هذا النحو، يكون من الصعب نقضها وتجاوزها. يقول وهبي سليمان غاوجي، أحد كُتاب سيرته المعاصرين: « إنها- لعمر الله- دراسة منهجية حرة شريفة، يظهر فيها احترام الآراء، ويشتغل فيها عقل الحاضرين من التلامذة، كما يظهر علم الأستاذ وفضله. فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من العسير نقدها فضلا عن نقضها، والله الهادي الموفق إلى الخير.»
من خصائص مجالسته إذن اجتماع العقول، والاستعداد الذهني المجرد عن كل شاغل. لذا كان الإمام يُنبه طلابه إلى اجتناب الظروف التي لا يتحقق فيها مقصد التعلم. يحكي أحد تلاميذه، واسمه توبة، أن الإمام نصحه قائلا: لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماش، ولا تسألني وأنا أحدث الناس، ولا تسألني وأنا قائم، ولا تسألني وأنا متكئ، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل.
وحدث يوما أن توبة تبعه وهو يمشي في الطريق، فجعل يسأله ويُدون ما قال. فلما لقيه بالمجلس في الغد كرر عليه المسائل فغير الإمام الأجوبة، فأعلمه بذلك فقال: ألم أنهكَ عن السؤال وعن الشهادات في دين الله إلا في وقت اجتماع العقول؟
ومن خصائص مجالسته أن يوفق بين حث الطالب على العلم، ورسم مستقبل مشرق لمن يشكون وضعا اجتماعيا هشا. فكان بذلك يضمن للفقه والحديث قاعدة من التلاميذ ، خاصة وأن أرض الكوفة تتنازعها أهواء الفِرَق والانقسامات الفكرية، مما يؤثر على اهتمامات الشباب ويعيق مسيرة التعلم. فإذا بلغ أحدهم مستوى لائقا من النضج العلمي قال رحمه الله: قد وصلتَ إلى الغنى الأكبر! ثم يوجه الأنظار إلى كفاءة طلابه والمهام التي تتناسب مع ميولهم بالقول : هؤلاء ستة وثلاثون رجلا، منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، وستة يصلحون للفتوى، واثنان- أبو يوسف وزفر بن هذيل- يصلحان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى !
إذا كان فقه أبي حنيفة مجهودا فكريا يصح الاتفاق والاختلاف معه، فإن عطاءه الإنساني وحضوره المجتمعي لا يُمكن أن يُقابلا بغير الإشادة والاحتفاء. فهو الدليل على أن التفقه بالنصوص لا يُنضج شروط التقدم والرفعة، مالم يصحبه إنصات لنبض المجتمع، وانسجام مع إكراهاته وطموحاته. لذا حين أخبِر شعبة بأن أبا حنيفة مات، استرجع وقال : لقد طفئ عن أهل الكوفة ضوء نور العلم، أما إنهم لا يرون مثله أبدا !
تنزيل PDF