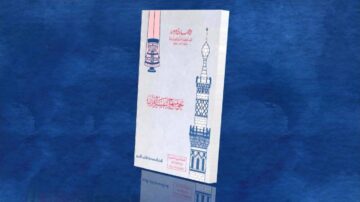يناقش الدكتور محمد الصادق عرجون، عميد كلية أصول الدين سابقاً بجامعة الأزهر، من خلال كتابه القيم (نحو منهج لتفسير القرآن) جملة من القضايا التي تحث الباحثين والمشتغلين بالدراسات القرآنية على ضرورة التعامل مع تفسير القرآن الكريم بمنهج صحيح صريح يهدف إلى “بيان الهداية القرآنية وبيان معنى الآيات بياناً يعتمد على دلالة الألفاظ في أسلوبها محاطة بسياج محكم من الأصول التي نزل بها هذا القرآن المجيد”، لكي يظل واقعنا الفكري العلمي متماشياً مع ما يقتضيه خلود القرآن العظيم باعتباره كتاب الإنسانية كلها والدستور المحكم الذي يرسم لها طرائق حياتها ويربي أفرادها تربية قرآنية.
إن الناظر في كتاب “نحو منهج لتفسير القرآن” الذي نحن بصدد الحديث عنه سيجد أن مؤلفه عرجون حاول أن يُعبّر عن الوضع الذي يعتقد أن الدراسة القرآنية ينبغي أن تكون عليه، فحذّر من خطر أطروحات التجديد المنحرفة وإخضاع الآيات القرآنية للنظريات المهزوزة والتعسّف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثة، وطالب بالعودة إلى رحاب الهداية القرآنية الإلهية وتقديم دراسة إسلامية قرآنية متحررة لا متحللة تصل حاضرنا الناهض بماضينا الأول المجيد وتقوم بغربلة كتب التفاسير عامة لإخراج تفسير واحد يقتصر فيه على بيان هداية القرآن بياناً شاملاً جامعاً يُغني الأمة الإسلامية عن التفكير الكسيح والتراجم المحرفة للقرآن الكريم.
الدراسة القرآنية
لا يسعى الصادق عرجون من خلال كتابه القيم (نحو منهج لتفسير القرآن) إلى استعراض مناهج تفسير القرآن الكريم الموجودة اليوم بين أيدي المسلمين التي تحدث عنها أئمة التفسير من جهابذة المنقول والمعقول، لأن هذا الأمر بالنسبة له لا ينبغي أن يكون هدفاً لبحث يسعى إلى “إبراز فكرةٍ تضع القرآن الكريم أو تنبه على وجوب وضع القرآن الكريم في موضعه الأصيل من الدراسات الإسلامية”، وإنما يسعى إلى مناقشة واقع الدراسة القرآنية ومعرفة ما ينبغي أن تكون عليه من أجل الانتقال بها إلى فضاء أرحب وأكثر عمقاً واتصالاً بالهداية القرآنية الإلهية لا النظريات المهزوزة والاتجاهات المنحرفة.
ولهذا نجد عرجون يؤكد في البداية على أن القرآن العظيم “كان ولا يزال هو المنبع الأصيل الذي فاضت وتفيض منه روافد العلوم ومعارف العربية”، ولكن العناية التي حظي بها هذا الكتاب العزيز على أيدي غطارفة الباحثين من أئمة الإسلام وأعلام الأمة لم تكن على درجة واحدة، ففي مجالات العبادات والبحوث اللغوية -مثلاً- كانت العناية واضحة ومتشعبة، أما في مجالات أخرى كالعقيدة فقام بعض المفسرين بإقحام حصائل الفكر البشري وألقوا بها في خضم الدراسة القرآنية على أنها تفسير، وقد “كان لإقحام هذه الحصائل الفكرية على حمى القرآن أثرُها المعوق على تبيين الهداية الإلهية بطريقة القرآن الخاصة في البرهنة على قضايا العقيدة ودحض شبه المبطلين.
ومن هنا يتوصل عرجون إلى أن إغراق الهداية القرآنية في خضم الحصائل الفكرية كان سبباً في مشكلة فكرية تاريخية يصعب الخلاص منها تتمثل في تحميل الإسلام “عبْءَ حصائل الفكر البشري ذي اللون الغريب كل الغرابة عن مفاهيم الهداية الإسلامية وجعلها من عمل الإسلام ومعارفه وأفكاره”، وهو بذلك يشير إلى حاجتنا إلى فلسفة إسلامية قرآنية خالصة؛ فما يعرف عندنا بـ”الفلسفة الإسلامية” بالنسبة لعرجون فلسفة أجنبية على الإسلام “تأسلمت” على أيدي مجموعة من المفكرين المسلمين كان ينبغي أن يصرفوا الجهد الذي بذلوه في ميدان البحث الفلسفي مع أرسطو في جهود صادقة ومستقلة في ميدان الهداية الإلهية لكي تكون “لنا معشر المسلمين اليوم فلسفة إسلامية حقيقية تنبع من أصولنا ومنبع هدايتنا القرآن العظيم”.
وهكذا فقد ذهب عرجون إلى أن الدراسة القرآنية في مراحل التاريخ الإسلامي كانت “تقليداً لما ورثناه من قرون الفُرقة الإسلامية”، لأننا لم نستطع التحرّر من قيود الاستعباد الفكري والتقليد المستسلم والعزة الإسلامية التي أتاحها لنا القرآن الكريم ودعانا إليها، والذين حاولوا أن يتحرروا من تلك القيود المخذِّلة لم يكن يملكون من العلم الصحيح والعقل الرجيح “ما يعصمهم من الوقوع في مزالق التقليد الأهوج لقوم هم أبعد ما يكون عن الإسلام ومفاهيم هدايته”، فوقعوا في فخ مذاهب ونظريات أقرب إلى التعسف والتحريف منها إلى التفسير والتحرير.
لقد وقف الصادق عرجون وقفة خاصة مع تيارات التجديد ليقول إن بعض الأفاضل الأكابر الذين أجادوا في بيان هداية القرآن في بعض بحوثهم “جرفهم تيار التجديد، فانزلقوا في منحدر التأويل المتعسف، وحاول بعضهم إخضاع آيات القرآن” لنظريات مهزوزة يعوزها الاستقرار العلمي، وضرب مثالاً على ذلك يتمثل في أن بعض المفسرين يقول في تفسير قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} إن القرآن الكريم “قرر أن الأرض كانت جزءاً من السموات وانفصلت، وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دلّ عليه العلم.
ولكن عرجون أعرب عن استغرابه من الجزم بهذا التفسير الذي يرى أنه “يجعل من القرآن كتاب نظريات تجريبية تخضع لتطورات الكشوف العلمية التي تُبطل اليوم ما كان بالأمس من الحقائق المقررة، وتُصحح اليوم ما كان بالأمس من الأساطير الباطلة”، فيتساءل قائلاً: أين قرر القرآن أن الأرض كانت جزءاً من السموات ثم انفصلت عنها إثر حادث كوني؟ ثم قال إن القرآن يحتوي على آية واحدة هي التي يتشبث بها أصحاب النظرية الانفصالية وهي قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} ولم يقرر أبداً النظرية الانفصالية بين الشمس والأرض، وقد روي أن ابن عباس عندما سئل عن معنى {السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا} قال: “كانت السموات رتقاً لا تمطر وكانت الأرض رتقاً لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات”.
الهداية القرآنية
وينتقل الصادق عرجون من الحديث عن مكانة القرآن في مناهج دراستنا الإسلامية وما سببه إغراق الهداية القرآنية في خضم الحصائل الفكرية من تقليد واستسلام إلى الحديث عن خلق الملائكة وتفسير رتق السموات والأرض وفتقهما وتفسير سورة الفيل من خلال تفسير الشيخ محمد عبده الذي يعتبره نموذجاً للمفسر الذي كان شعلة مضيئة في إنارة الطريق لتجديد تفسير القرآن والعودة به إلى بيان الهداية القرآنية، حيث أشاد في البداية بتفسير محمد عبده لسورة الفيل ثم استدرك عليه رأيه بخصوص انتشار داء الجدري والحصبة في جيش الفيل معتمداً على ابن الأثير في تاريخه الكامل، فقال: “وحديث الجدري والحصبة في هذا المقام حديث مقحم متهافت ما كان ينبغي أن يعول عليه مثل الشيخ على جلالة قدره في تفسير القرآن الكريم.
وفي سياق حديثه عن موقف الشيخ محمد عبده من خلق الملائكة، أشار عرجون إلى ظاهرة التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثة التي يرى أنها مذهب لكثير من “المجددين” في تفسير القرآن الكريم، ثم ذكر أن الشيخ محمد عبده -على مكانه من الفضل والعلم- كان يسلك في بعض الأحيان “الطريقة التي تبدأ ببيان الهداية القرآنية بياناً لا يستطرد ولا يتعسف في التأويل، ثم يبدو له أن يتولج إلى مداخل التأويل الذي يبعده عن اختياره لمذهب السلف”.
ولكي يقدّم عرجون دليلاً على حالة التولج إلى مداخل التأويل التي تصيب محمد عبده في بعض الأحيان، توقف مع تفسيره لخلق الملائكة الذي ذهب في شطره الأول إلى رأي السلف والخلف ثم انتقل إلى عالم التأويل المليء بالمنعرجات الخطيرة، وهنا نجد عرجون يقول إن هذا النوع من التولج إلى مداخل التأويل “هو الذي يُخشى أن ينفذ منه (المتقرمطون) إلى تحريف كلم الله عن مواضعها ابتغاء فتنة الجماهير من عامة المؤمنين”.
ويختتم عرجون حديثه عن منهج الهداية القرآنية بالتأكيد على أن الثروة الضخمة التي أخرجها أئمة الإسلام قديماً وحديثاً في تفسير القرآن تؤكد العناية الفائقة التي حظي بها هذا الكتاب الحكيم، ولو “أتيح لعلماء المسلمين اليوم أن يجمعوا في مكتبة قرآنية جميع ما أخرج من التفاسير لينتقى منها تفسيرٌ واحدٌ يقتصر فيه على بيان هداية القرآن بياناً شاملاً يجمع ضروبها لكان للأمة الإسلامية منها تفسيرٌ جامعٌ لما تتطلبه البشرية في حاضرها بل أكاد أقول في مستقبلها”.
دراسة متحررة
وفي المحور الذي يحمل عنوان (في سبيل دراسة متحررة لا متحللة)، يحثنا الصادق عرجون على عدم الاستسلام لليأس أمام المهمات الجسام التي يستحقها علينا دستور الإسلام (القرآن)، فنجده يدعو المشتغلين بالدراسات القرآنية إلى تقديم “دراسة إسلامية متحررة لا متحللة، دراسةٍ تصل حاضرنا الناهض بماضينا الأول المجيد، دراسةٍ تعتمد على أن النبع الفياض -بالأفكار والعلوم والمعارف والحقائق القوية الهادية إلى الله تعالى المحققة لسعادة البشرية حيثما كانت في ظل راية الإسلام- هو القرآن الكريم”.
ويطالب الصادق عرجون الذين يَحْملون عبءَ الدراسات القرآنية -لكي يعصموا أنفسهم من مزالق التقليد الأعمى ومنعرجات التجديد المنحرف- بأن يجعلوا القرآن الكريم “هادياً ومنبعاً لقيام بحوث تنهض بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتمدهم بمطالب الحياة حتى لا تكون بهم حاجة إلى غيرهم”، ويتم ذلك بالعودة إلى الهداية القرآنية الإلهية وتوسيع وتطوير دائرة البحوث حول المجالات القرآنية التي “ظلت مغلقة لم تفتح أبوابها إلا بمقدار ما يدخل الهواء للتنفس وحفظ الحياة”، مثل الآيات المتعلقة بالعقيدة والمجتمع البشري ثم الآيات الكونية.
ولعل من المفارقات أن هذه المجالات تأخذ مكانة كبيرة في الخريطة القرآنية، فالعقيدة هي أصل الأصول والآيات الكونية ساقها القرآن الكريم في مواطن عديدة لإيقاظ العقول الإنسانية كي تنهض بواجبها في كشف الحقائق الكونية وتفرد الخالق بالتقديس، وتثبت أن القرآن لا ينبغي أن يعرض في تفسير آياته للهزات التجريبية فيقال إن النظرية الفلانية مذكورة في القرآن الكريم، وإنما يجب أن يقال إن الآيات القرآنية الكريمة لا يمكن أن تُصادم علماً مقطوعاً بحقيقته مهما اتسعت دائرة المعارف والعلم والاختراع.
أما الآيات القرآنية التي تحدثنا عن سنة التدافع بين البشر فقد عرضها لنا القرآن من خلال آيتين “أبان فيهما أن من سنن الله الاجتماعية أن يدفع بأهل الحق والخير والإصلاح أهل الباطل والشر والفساد”، حيث تقول الآية الأولى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}، في حين تقول الآية الثانية: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}.
وقد استعرض عرجون رأيين في تفسير هاتين الآيتين لإمامين من أئمة التفسير هما الطبري والقرطبي واكتشف أن من المظاهر المنتشرة في بعض التفاسير أنها أحياناً “تذكر الرأي السديد الموفق ثم تغيبه في كِسَف من سحب الآراء والروايات التي تستجلبها أدنى المناسبات اللفظية أو المعنوية”، فيبدو الرأي السديد شاحباً هزيلاً أمام الرأي الخاطئ، ولعل هذا هو ما حصل للإمامين الطبري والقرطبي في تفسير آية المدافعة.
غربلة التفاسير
ويبدو أن تأرجح بعض التفاسير القرآنية بين الجادة ومتاهات الروايات دون تحقيق صحة السند وسلامة المعنى هو الذي دفع الصادق عرجون إلى المطالبة بغربلة كتب التفاسير والتصريح بأن علماء الإسلام لو قاموا بتوجيه جهودهم وعنايتهم في هذا العصر إلى غربلة كتب التفاسير “وأخرجوا منها للناس كتاباً واحداً في ربع أو خمس أو عشر حجم أحدها ثم قاموا بطبعه وترجمته وتوزيعه في أرجاء العالم بثمن وبغير ثمن لأغناهم هذا وأغنى العالم الإسلامي عن التفكير الكسيح هنا وهناك (…) وعن هذه التراجم المحرفة للقرآن ولكان فيه أعظم دعاية وتبليغ للإسلام”.
ولا بد من القول هنا إن عرجون لا يغمط أئمة كتب التفسير حقهم بل يعترف بجهودهم العظيمة في مجال التفسير فيقول إنهم قاموا “بواجبهم نحو القرآن ونحو الأمة في عصورهم بأكثر مما في طاقتهم، وبذلوا من الجهد والفضل والتفكير فوق ما يستطيعه البشر”، ولكنه يؤكد على ضرورة زيادة البذل فيقول إننا “مطالبون أشد المطالبة بالقيام بعمل جاد لخدمة القرآن وإتاحة فهمه للناس، بروح تقدر الواقع وتقف معه، ولا تتهرب منه، وتفهمه وتفهم طرائق علاجه”.
وفي هذا المضمار يؤكد عرجون على ضرورة أن نبدأ العمل على مشروع جاد خادم للقرآن فوراً وأن لا نتكاسل ونعلل تقاعسنا بعدم القدرة على تحقيق طفرة في هذا الميدان سريعاً، لأن “الآمال والنظريات إذا لم يحاول العاملون في توجيه الدراسات القرآنية تحويلها إلى حقائق واقعية فلن يكون لها أثرها الإيجابي في هذه الدراسات”، وهكذا يتوصل عرجون إلى أن غربلة كتب التفاسير من أجل النهوض بعبء تفسير القرآن لا يمكن أن يقوم بها فرد مهما كان شأنه، وإنما تقوم بها “طائفة من العلماء المتخصصين في فهم الحقائق الإسلامية الأصيلة فهماً عميقاً وطائفة من العلماء المسلمين المتخصصين في جميع العلوم والمعارف الإنسانية التي عرض لها هذا الكتاب الكريم.
وقد ذهب عرجون إلى أن النهوض بعبْءِ التفسير يتطلب “إنشاء مجمع قرآني دائم يستهدف تفسير القرآن تفسيراً ينهض بالمسلمين نهضة تضعهم في مكانهم من حياة الفكر الإنساني طليعة للمشاركة في بناء الحضارة العالمية على دعائم الإيمان والعدل والإخاء”، على أن يقوم هذا المجمع القرآني بوضع منهجين لتفسير القرآن العظيم يهدف الأول إلى “وضع تفسير دراسي يعمد إلى بيان الهداية القرآنية وبيان معنى الآيات بياناً يعتمد على دلالة الألفاظ في أسلوبها محاطة بسياج محكم من الأصول التي نزل بها هذا القرآن المجيد”، في حين يسعى المنهج الثاني إلى “وضع تفسير للقرآن تبين فيه الهداية القرآنية الإلهية التي أودعها الله هذا الكتاب الحكيم”.
ويؤمن عرجون بأن هذا التفسير إن كتب له الظهور سيكون “بمثابة دائرة معارف قرآنية تسد لدى العالم الإسلامي فراغاً يشعر به كل مسلم”، خاصة أن المجمع القرآني الذي يقترح يمكن أن يقوم أيضاً بإخراج كتاب يستقصي “الإسرائيليات والأغاليط الفكرية التي حُمِّلها القرآن الكريم للتنبيه عليها حتى لا يقع في حبائلها المسلمون”.