يمثل “سؤال الفلسفة”؛ من حيث أهميتها، ومجالاتها، وقدرتها على الإسهام فيما يواجهنا من تحديات.. أحدَ الأسئلة المهمة المعاصرة..”إسلام أون لاين” التقى الأكاديمي المصري، الدكتور سيد عبد الستار ميهوب، أستاذ الفلسفة الإسلامية؛ ليبحر معه في بعض القضايا المتعلقة بـ”سؤال الفلسفة”، بدءًا من سؤال حاجتنا إلى الفلسفة في واقعنا المعاصر.. إلى دورها في الإصلاح الفكري المطلوب.. وكيفية الانتقال بها من الجدل والتنظير والتجريد إلى الواقع والإشكاليات الحالّة.. وليس انتهاء بإلقاء الضوء على السجال الغزالي- الرشدي (القديم/ المتجدد)، والتعامل الخاطئ من البعض مع التراث الرشدي، بجانب تجلية الدور المهم الذي اضطلع به الشيخ مصطفى عبد الرازق في إعادة تأسيس الدرس الفلسفي في العصر الحديث.
الدكتور سيد عبد الستار ميهوب، أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، ووكيل أسبق للكلية. وقد تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، وعمل أستاذًا في جامعتي الإمام والملك خالد بالسعودية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وله عدة كتب في العقيدة عند أعلام المعتزلة والأشاعرة، وفي مناهج البحث عند الفلاسفة والعلماء، كما كتب في الفكر السياسي في الإسلام، وشارك في كتب تذكارية عن أعلام العرب والمسلمين.
من مؤلفاته: “أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكلامية والفلسفية” (رسالة دكتوراه)، “القرآن والنبوة عند القاضي عبد الجبار”، “الإمام ناصر الدين البيضاوي ومنهجه في التفسير”، “الدلالات الذوقية للعبادات عند أبي حامد الغزالي”، “الحب الإلهي والجمال عند ابن القيم“، “الدلالات الأخلاقية في فكر زكي نجيب محمود”، “هؤلاء المثقفون وفكرهم الإصلاحي”.. فإلى الحوار:
كيف ترون حاجتنا إلى الفلسفة في واقعنا المعاصر؟
الفلسفة، بوجه عام، منهج تفكير.. وسيلة لا غاية، ما يعني أن أهميتها تقاس بـ”نية” المجتمع في التقدم الذي يقام على “عقل” يفكر، فـ”قيمة” تحْكُم، فـ”سلوك” يُفعّل. والملاحَظ، تاريخيًّا، أنه بشيوع “التفلسف” يتقدم المجتمع على صُعد التعليم فالثقافة.
فالفلسفة مهمة (من الأهمية والمَهمة) في الواقع العربي/ الإسلامي المعاصر، الذي يتفق الجميع على تأخره بشكل أو بآخر، كمدخل لإشاعة التفكير الإيجابي المفيد للفرد والمجتمع؛ فمواطن يفكّر- نقدًا، فإعادة قراءة لمعارفه نحو غدٍ أفضل- يعني تأسيس، أو إعادة بناء، مجتمع صحي.
ما الدور الذي يمكن للفلسفة أن تؤديه في الإصلاح الفكري المطلوب؟
التفكير جزء من خاصية العقل، وهذا- بدوره- فصلُ الإنسانِ (أي جوهره) على الحقيقة بحسب الكليات الخمسة؛ وبما أن الإنسان هو المنوط به “إدارة” الكون باعتباره “سيدًا في الكون” لا “سيد الكون”، فلا بد أن يحسن “توظيف” عقله؛ وهذا هو دور الفلسفة حيث إنها “المعمل” الذي يصيغ عملية التفكير نظريًّا بتأسيس “ذهنية” تجيد بالاتجاه الصحيح؛ من خلال ترقية “كيفية” التفكير، والتي تنتهي بالوعي الإيجابي، سواء بالواجبات أو بالحقوق؛ ما يعني تنشئة “فرد” صالح على المستوى الشخصي، والعام الأول (=الأسرة)، والعام الأخير (=المجتمع).
الانتقال بالفلسفة من الجدل والتنظير والتجريد إلى الواقع والإشكاليات الحالّة.. كيف يكون؟
هنا نشير إلى أهمية تأسيس “عمل” فلسفي أكثر مما نؤسس، أو نعيد، التنظير الفلسفي؛ بمعنى طرح “القضايا” (=المشكلات) ذات التعلق بالمجتمع، ويقوم السادة المأمول فيهم “تفكير فلسفي” بعمل “ورشة” تدرس كل قضية/ مشكلة على حدة، ثم تصيغ الحلول التي تُعرض، ولو كانت كثيرة.
وهذه الحلول ينظر فيها لنخرج بحل لهذه القضايا، أو أكثرها، بعيدًا عن عَقْد “المؤتمرات” التي تناقش الماهيات الميتافيزيقية التي “قُتلت بحثًا”؛ وحتى بفرضية “جديد” بحثها، فإنها لن تفيد في حل مشكلات مجتمعات مأزومة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعلميًّا، تبحث عن “حلول” لا عن “جدل” بيزنطي حول عدد أجنحة الملائكة بينما العدو يدق، أو يدك، الأبواب.
التجديد الفلسفي.. ما مفهومه؟ وكيف يتم؟
نحدد، أولاً، مصطلح “التجديد”: التجديد المطلوب هنا هو الذي يعتمد الأصول الأساس في الفكر الفلسفي، بصرف النظر عن أية انتماءات عرقية أو أيديولوجية. وهناك فارق أساس بين “التجديد” و”الإصلاح”؛ وبما أن السؤال محل الطرح يتناول “التجديد” فهذا أدق تعبيرًا عن المراد؛ فـ”الإصلاح” يقتضي قيام نقص، بدرجة أو بأخرى، في القضية محل النظر؛ ما يعني التسليم بوجود “خلل” بشكل ما، وهذا يستلزم معالجة ربما بدأت من الصفر حتى لتطال المسلمات في الفكر، أو في التاريخ، الفلسفي.
هذا على غير الحال مع “التجديد”، خاصة التجديد في مجال الفكر الفلسفي، الذي هو مجموعة إجراءات، لها أكثر من ضابط، باتجاه إضافة جديد للقديم بما يلبي حاجة العصر الذي نعيشه.. وكأننا بصدد عملية “تراكمية” لا تنكر، بشكل كُلي، القديم، لكنها لا تتركه، وحده، يحدد قسمات الحلول المنتظرة لقضايا لم يعشها فكر ذاك القديم. لذا ستبقى للقديم غيرِ المراد حاضرًا قيمةُ “الاحترام”، بينما القديم المرادُ حاضرًا ستكون له قيمةُ “الاعتبار”.
ولو شئنا تناول “التجديد الفلسفي” في قسمه الإسلامي، للزمتْ الإشارةُ إلى خطأ كثير من التصورات التي صارت كمسَلّمات في التاريخ الفلسفي ذات التعلق بالفكر الإسلامي؛ ولعل أبرز من مثّل هذا الخطأ فلاسفة مثل الفرنسي فيكتور كوزان (1792م : 1867م) في (تاريخ الفلسفة)، ومواطنه إرنست رينان (1823م : 1892م) في (ابن رشد ومذهبه) و(تاريخ اللغات السامية)، والألماني تنمّان (ت 1819م) في (المختصر في تاريخ الفلسفة).. فرأوا أن “الفلسفة الإسلامية مجرد انعكاس باهت لفلسفة اليونان”.
بل حتى التصوف الإسلامي “مجرد محاكاةٍ دينيةٍ للرهْبنة المسيحية”. وبمد الحبل على استقامته تكونت “مدرسة” استشراقية ترى الإسلام، دينًا وثقافةً وحضارةً “حقلاً معرفيًّا تتجلَّى فيه مجموعة العقائد اليهودية والمسيحية”، فكان لا بد من “إصلاح” يُعنى بما جعله محمد إقبال همًّا كبيرًا له، حين قال: (إني أود أن أستأصل تلك الفكرة الخاطئة التي تزعم أن الفكر اليوناني شكّل طبيعة الثقافة الإسلامية).
فكأننا، ونحن نؤسس لتجديد فلسفي عام وإسلامي خاص، نشدد على ضرورة “إعادة قراءة” لكثير من الفروض والمسلمات، عبر “التعقب”؛ لنرى فِعْلَها في التصورات ومن ثم الأحكام؛ ولذلك حري بالمهمومين بقضايا الأمة الفكرية النظر في جهود، ومناهج، شخصيات لها مقامها مثل مصطفى عبد الرازق ومدرسته بشقيها الأصولي والليبرالي.
ما الإشكالية الأساسية التي تجعل التفكير الفلسفي ينحرف بعيدًا عن الدين ويدخل معه في خصومه؟
لو أُذِنَ لي: فإن “الانحراف”، بفرضية حدوثه، قام بين فكرين: فكر فلسفي وفكر ديني. وأنا أتناول الجانب ذا التعلق بالفكر الفلسفي والفكر الديني في الإسلام تحديدًا؛ حيث لا خصومة حقيقية بين “الفكر” و”الإسلام” الدين! نعم، قد ينحرف الفكر الفلسفي “بعيدًا عن الدين”، ليس بسبب من “الفكر” باعتباره فكرًا، ولا بالإسلام دينًا؛ لكن بفعل “أفراد” محسوبين إما على هذا القطاع أو ذاك.
وتكمن العلة في “جرأة” بعض الفقهاء على رمي المفكر/ الفيلسوف بالزندقة. ولنراجع في ذلك “رمي” من أسماهم دي بور بـ”علماء الإسلام الحقيقيون” الفيلسوف الفارابي بالزندقة. فكان أن “وُسمَ بها إلى الأبد”، ما دفع بعض الفلاسفة إلى الرد، ربما في كتابةٍ بها قدر غير يسير من الخشونة، كقول الكندي في رسالته إلى المعتصم: (لدرانة الحسد المتمكن من أنفسهم البهيمية، والحاجب بسجف سجوفه أبصار فكرهم عن نور الحق، ووضعهم ذوي الفضائل الإنسانية، وكانوا منها في الأطراف الشاسعة، التي قصروا في نيلها بموضع الأعداء الواترة ذبًّا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها عن غير استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين). لكن يبقى الأمر على غير ذلك في صورته الكلية؛ فالكتابة الأعلى اعتبارًا في هذا الحقل انتهت إلى (تلاشي القول إنّ الإسلام، وكتابه المقدّس، كانا بطبيعتهما سجنًا لحرية العقل وعقبة في سبيل نهوض الفلسفة).
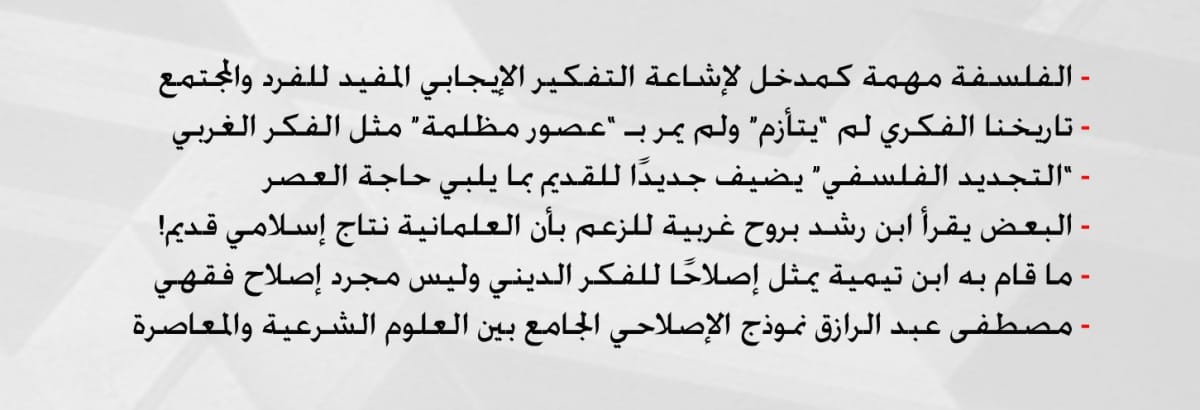
إذًا، هناك عامل، أو بالأصح عاملان، أحدهما ذو تعلق بالفلاسفة، والآخر ذو تعلق بالفقهاء؛ فالذي هو للفلاسفة، أن الدارس سيجد للفلاسفة جهدًا مشكورًا في التوفيق بين الشريعة (=الدين) والحكمة (=الفلسفة) في بيان لطيفٍ راقٍ لا عنفَ فيه ولا تكبّر؛ لكن هذا لا يمنع وجود “أساليب” للبعض فيها مهاجمة للدينيين بشكل أو بآخر، بدرجة أو بأخرى؛ كقول أحدهم (منكرو الفلسفة هم أهل الغربة عن الحق وإن تتوّجوا بتيجان الحق من غير استحقاق، لضيق فطنتهم عن أساليب الحق). والذي هو للفقهاء ، فإن الدارس لا يعدم “آراء” لبعض “علماء الدين” الذين هم ذوو منزع “في أكثره خصومة للفلسفة في غير هوادة ولا رفق”؛ كقول أحدهم (الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة).
وفي الخطابين زيادة عن حد القبول والرفض معًا، وربما كان ذلك، كما يرى شيخنا مصطفى عبد الرازق، بسبب (أن هذا الصنف ممّن لم يتذوقوا طعم الفلسفة ولم يتنسموا ريحها، وفي كلامهم من الخلط ما يدلّ على أنّهم لا يتكلمون عن علم فيما عالجوا من أمور الفلسفة). ما سبق يعني أن هناك “إشكالية” في تجسير العلاقة بين الفلسفي والديني؛ تكمن في ضبابية رؤية بعض أفراد هذه الكتيبة لأفراد الكتيبة الأخرى على صُعد الفكر والحِجاج من ناحية، والعقيدة والشريعة من ناحية أخرى؛ وهذا المنهج ربما كان نجاحه أضأل من فشله بسبب اختلاف “منظور” كل فريق.
والأحرى النظر إلى الحقلين لا باعتبارهما متناقضين بل مختلفين؛ وقد بدا ذلك في تراثنا: جهود سلفنا لتأسيس علاقة العقلي بالدين مثل (المغني) للقاضي عبد الجبار، و(الإرشاد) للجويني، و(درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية، و(رسالة إلى المعتصم) للكندي، و(فصل المقال) لابن رشد الحفيد، ولا ننسى ما كتبه ابن حزم؛ حيث يرى أن المؤلفات المنطقية فيها البر الكثير، ما يؤهل أصحابها لطلب الثواب والأجر من الله تعالى: “هذا العلم [يقصد علم المنطق] كالرفيق الصالح، والخدين الناصح، والصديق المخلص الذي لا يسْلمك عند شدة، فهو يفتح كل مستغلق، ويوضح كل غامض في جميع العلوم”.
ولما رأى الرجل أن سبب الرأي السيئ في المنطق إنما يكمن في “تعقيد العبارة وعمق الأسلوب”، كتب هو في المنطق بلغة سهلة وأسلوب واضح؛ ليتسنى للناس، ككل، معرفة قيمة هذا العلم؛ فكان كتابه (التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية)، وانتهى فيه إلى نفع المنطق في كل العلوم ابتداءً بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، كذا في الفتيا وتبين الحلال والحرام، وانتهاءً بكتب النحو واللغة والطب والهندسة، مرورًا بعلوم العقيدة والملل والمذاهب.
انقسم كثير من الباحثين بين غزاليين ورشديين.. هل من رؤية جامعة تستفيد من العَلَمين الكبيرين؟ وما حقيقة ما بينهما من خلاف؟
بالضرورة، قراءة المقروء، شخصًا كان أو موضوعًا حال كان المطلوب الحكم عليه، في إطار “عصره” و”مراحل” تطور فكره إنْ وجِدَتْ. فالغزالي ليس “غزالي واحد”، بل الرجل مر بمراحل عدة عبر “تغيير” فكره من/ إلى (=كنتُ/ أصبحتُ) بحسب ما رآه هو مناسبًا له: “رأيت رجلاً [أي الغزالي] من أهل العلم قد نهضت به فضائله، واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طولَ زمانه، ثم دخل غمار العمال [=الصوفية]”. وكان- كما يقول- زكي نجيب محمود- طالتْ قامته حتى رآه المسافر من بعيد كالنخلة الفارعة، والذي ألقى بظله على العصور التالية له. هو طود شامخ راسخ أخلص النظر والقول، لم يكتب ما كتب ليملأ الصحف بزخرف اللفظ، ولا ليُلهي قارئه بقدرةٍ يتظاهر بها أمامه ليتعالم في كذب؛ بل كتب ما كتب مخلصاً صادقاً.
وكما انتهى الغزالي إلى “التصوف” منهجًا للوصول، فقد انتهى، على مستوى رؤيته للفلسفة، إلى أنها “خداع وتلبيس وتخييل”. ربما جانب الغزالي الصواب في كتابه (مقاصد الفلاسفة) يشرح فيه مذاهب الفلاسفة.. أخطأ الغزالي خطأ كبيرًا جدًّا؛ إذ جاء حكمه على الفلسفة عبر فلسفة ابن سينا، ظنًّا منه أن شروح ابن سينا على أرسطو هي الأدق، مع أن هذا غير صحيح بالمرة.. ثم وضع كتابه (تهافت الفلاسفة)، ورد عليه ابن رشد بـ(تهافت التهافت) مبينًا عدم حسن فهم الغزالي للفلسفة في غير موضع.
حاول الغزالي في كتابه هذا “تفنيد مزاعم الفلاسفة، وإبطال دعاواهم، وإثبات ضعف عقيدتهم في مذاهبهم التي قرروها متأثرين بفلاسفة اليونان؛ ليبين للناس عدم وفاق الفلسفة للدين، فينصرفوا عن أهلها، ويُزجر من يخوض في علومها؛ إذ قلّ من يخوض فيها إلا وينخلع من الدين”.
ويرى الغزالي أن” مجموع ما غلط فيه الفلاسفة يرجع إلى عشرين أصلاً، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها؛ هي: إنكار بعث الأجساد، قصر علم الله على الكليات، والقول بقدم العالم، وتبديعهم في سبعة عشر”. وقد رمى الفلاسفةَ بالغباوة والحمق والزيغ وسوء الظن بالله والغرور والادعاء والاعتداد بالعقل (!!!).
وعلى الطرف الآخر، فإن ابن رشد مازجَ بين المنهجين: منهج النقل كما عند علماء الشريعة، ومنهج العقل كما هو عند الفلاسفة، لكنه أفسح- من منطلق إسلامي- المجال للنقل: “الحكمة والشريعة، أو الدين والفلسفة أختان رضعتا لبانًا واحدًا؛ فالحكمة هي صاحبة الشّريعة، والأخت الرّضيعة لها، وهما المصطحبتان بالطّبع، المتحابّتان بالجوهر والغريزة”. و”العقل يفحص عن كل ما جاء به الشرع، فإن أدرك استوى الإدراكان، وكان ذلك أتم في المعرفة، وإن لم يدركْ أُعلمَ بقصوره عنه، وبقي إدراكه بالشرع فقط”. و”ليس الإجماع مستقلاً بذاته من غير الاستناد إلى واحد من الطرق الشرعية المعتبرة؛ لأنه لو كان كذلك لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي ﷺ، إذ كان لا يرجع إلى أصل شرعي”. و”إنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له”.
فجزء من الإشكالية رؤية منسوبي أحد الفريقين الفريقَ الآخر على باطل؛ لكن لو علمَ هؤلاء كيف هو جيد “التنسيب” الذي هو، ثقافيًّا، إيمان القائل بأن كلامه “نسبي” من حيث احتمالية إصابة/ حوْز الصواب على يد غيره!!! فالحق “لم يصبه الناس في كل وجوهه، ولا هم أخطأوه في كل وجوهه؛ بل أصاب منه كل إنسان جهة”؛ كذلك “تسليمية” الإمام الشافعي باحتمالية قيام الصواب/ الحق عند مخالفه: “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
وكيف ترى جهود ابن تيمية بين الغزالي وابن رشد؟
لم يكن ما قام به ابن تيمية مجرد “إصلاح فقهي”، بل يمكن الصعود به ليكون “إصلاح الفكر الديني” بنفس القدْر الذي يمكن تحري “اتحاد” التجربة العقلية/ الفلسفية بالتجربة الروحية/ التصوف عند الرجل؛ بحيث يصح الاعتماد على “المنهج” في “لم الشمل” المشتت للمفكرين والفقهاء في سبيل الأمة والدين والله.
لم يقف ابن تيمية “تشدد” الغزالي، في مرحلته الأخيرة، ضد الفلسفة منهجًا وموضوعاتٍ؛ كما لم يقف موقف ابن رشد في السير بالعقل مدى، ربما، فاق ما خُلق له هذا العقل.
قد صح ما بيّنه ابن القيم، بحق شيخه، من ضرورة “تجاوز” منهجية نقد الرجال (=الجرح والعدل)، وكانت تأسست على فكرة “النقد الخارجي”، إلى ما يمكن تسميته بـ(النقد الداخلي) القائم على فكرة ذات معايير عقلية؛ مثل التناسق مع “وقائع التاريخ”، والتناسق مع القرآن الكريم، والتناسق مع سلوك الأنبياء، وغير ذلك مما يتقوم بدليل العقل الذي لم ينكره فقيه.. بله ابن تيمية ومدرسته.
مثّل ابن تيمية “الوسطية” بين الموقف الغالي في “النقل” والآخر الغالي في “العقل” بمنهج قام على أسئلة منهجية، كان الدافع لها (درء تعارض العقل والنقل). ولعل الأسئلة التي يمكن للباحث أن يقول بها على لسان كتابات الرجل:
– كيف الطريق لبناء معرفي لا يتعارض فيه “صحيح” المنقول مع “صريح” المعقول؟
– ما معيار “صحة” المنقول؟ وما معيار “صراحة” المعقول؟
– ما الأدوات التي ستميز “صحيح المنقول” من “كل المنقول”؟ وهل سنعود للتأكيد على أهمية “العقل” في هذا الحقل، وهو حقل نقلي، من حيث ضرورة الأخذ في الاعتبار مجموعة من الشروط العلمية ذات تعلق شديدٍ بالمنطق الـ”عقلي”؟
هكذا وقف ابن تيمية “أطول” من الغزالي، لكنه “أقصر” من ابن رشد بالنظر لغلبة “العرَضي” في الاعتماد على المنهج الفلسفي في بيانه للقضايا محل إجاباته؛ كذلك نظرته لـ العقلانيين باعتبارهم “ضحايا” العلوم التي يدرسونها؛ لكن يحسب للرجل أنه بقدر ما نقد الفلاسفة، فإنه “فتح الباب” لابن خلدون ليؤسس منهجًا يأخذ بالعقل باتجاه الدراسات الدينية، علاوة على أن ابن تيمية لم يتحرج من الكلام في أن “بعض” “علماء النقل” ليسوا بعيدين عن المثالب؛ لا العقلية فقط، بل حتى الأخلاقية.
لماذا يقرأ البعض ابنَ رشد بروح غربية، حتى ليرونه داعية لـ”العقلانية” المخاصمة للدين، أو على الأقل المفارقة للدين؟
هذه قراءة “العلمانيين” العرب/ المسلمين، وهي إفراز لدعوة التنوير الغربية لكن بثوب عربي دونَ الاعتبار بالخصوصية/ الهوية (بلحاظ أن التنوير هو الحاضنة التاريخية للعلمانية).
والسبب الدافع لهذا الموقف، سواء من الشخص (=ابن رشد)، أو من الموضوع (=العقلانية المخاصمة للدين)، أن ابن رشد يمثل “آخر” رجال الفلسفة الإسلامية في شكلها الأرسطي المشائي؛ وبالتالي يمكن، حال صحت نظرة هؤلاء، الاعتماد على موقفه لتمرير إشكالية الاعتماد على العقل بصرف النظر، بشكل كلي وصريح، عن كل ما هو “قيمي” مفارق سواء كان أدوات أو غايات مرجعيات!
فقد حاول مفكرو الغرب، لتمرير دعوتهم للذهنية العربية/ المسلمة، تناول العقلانية العربية/ الإسلامية بأساس برجماتي؛ مع أن هذه العقلانية بقدر ما هي لا تفصل الدين عن المجتمع، فهي لا تقدم العقل على الشرع تقديم تشريف، من حيث إن الوحي (=الشرع) معصوم؛ فصار المفكر المسلم يعتمد الشرع ابتداءً، ثم يأخذ بدليل العقل، إضافةً إلى أن العقلية الإسلامية لم تجعل العقل “مخترعًا” لشيء في الشريعة؛ فـ”العقل يفحص عن كل ما جاء به الشرع، فإن أدرك استوى الإدراكان، وكان ذلك أتم في المعرفة؛ وإن لم يدركْ أُعلمَ بقصوره عنه، وبقي إدراكه بالشرع فقط”.
وبدراسة التاريخ الفكري للغرب نجد أن تاريخنا الفكري لم “يتأزم” كما كان الحال مع الفكر الغربي، فالفكر الإسلامي لم يمر بـالعصور الوسطى “المظلمة”، ولم يمر بعملية “سيطرة” “رجال الدين” على كل مناشط العقل الإنساني، كما كان الحال في “محاكم التفتيش” و”الكثلكة” و”صكوك الغفران”؛ فكان من اعتمادات الفكر الإسلامي “الأنبياء أطباء أمراض القلوب؛ وإنما فائدة العقل أن عرّفَنا ذلك، وشهد للنبوة بالتصديق، ولنفسه بالعجز عن إدراك ما يدرك بعين النبوة؛ وهو معزولٌ عما بعد ذلك إلا عن طريق ما يلقيه الطبيب إليه.
إذاً، تأتي قراءة ابن رشد “غربيًّا” كمدخل للكلام في “علمانية” الرجل؛ فيكون الأمر “بضاعتكم رُدت إليكم”! فالعلمانية، بهذه القراءة، لن تكون إلا نتاجًا عربيًّا إسلاميًّا قديمًا!!! وهذا بأنْ زعم أصحاب هذه القراءة أن الفكر الإسلامي، ممثلاً في ابن رشد، فصلَ بين الحقيقتين الدينية والعقلية. لكن الثابت، تاريخيًّا، أن المفكر المسلم لم يفرق بين ما جاء به الشرع وما توصل إليه العقل؛ فالاثنان يهدفان لسعادة الإنسان، فتصبح الغاية واحدة وإن اختلفت الوسائل المؤدية إليها. أقام المفكر المسلم رؤيته على أربعة أسس هي:
–أنه لا يوجد، أتمّ إقناعاً وتصديقاً من الشريعة للجميع.
–أن الشريعة تقبل النصرة إلى أن تنتهي إلى حد لا يقف على التأويل فيها، إن كانت مما فيه تأويل، إلا أهل البرهان.
–أن الشريعة تتضمن الحق لأهل الحق على التأويل الحق.
–أنه لا سلطان فوق سلطان الدين.
إلى أي مدى انطلقت الفلسفة الإسلامية، بعد أن أعاد تأسيسها في العصر الحديث الشيخ مصطفى عبد الرازق؟
يمثل الشيخ مصطفى عبد الرازق نموذج الإصلاحي الذي هو عالم بالعلوم الشرعية، ثم هو، من ناحية المعاصرة، قد أخذ العلم على يد نخبة من كبار أساتذة الفلسفة الفرنسيين، وفي مقدمتهم يأتي لالاند؛ ولذلك فـ إصلاحية الرجل للفلسفة تمثلت ليس من “الداخل” فقط، بل من الخارج أيضًا؛ فكان جهده كبيرًا لتنقية “التصور” من مغالطات صارت كـ مسلمات في العقلية الغربية التي أفرزت تعصبًا عنصريًّا على يد بعض المستشرقين (“إرنست رينان” ومواطنه “فيكتور كوزان” والألماني “تنّمان” نماذج) الذين لم يروا في الفلسفة الإسلامية أكثر من “انعكاس” لفلسفة يونان. حتى علم الكلام، وهو إنتاج إسلامي قح، صار استنساخًا لـ المنهج الجدلي عند رجال الكنيسة الغربيين في القرون الوسطى. لذلك نثمّن إعادة “وضعية”/ “مكانة” الفلسفة الإسلامية على يد الشيخ عبد الرازق الذي لم يألُ جهدًا في بيان “الأصالة” التي لهذه الفلسفة؛ وذلك عبر منهجين: النقض والبناء.
فبدأ بـ نقض تصورات رينان، ومدرسته بشأن الفلسفة الإسلامية، بل والعقلية العربية بوجه عام؛ ثم تناول “مقام” العقل في الإسلام عبر الكلام في علم “أصول الفقه“؛ الذي كان الشيخ أول المنادين بإدراجه ضمن “المباحث الفلسفية” في الفلسفة الإسلامية: “إنَّ المسلمين الذين استجابوا لداعي إعمال الفكر والعقل، وأقبلوا على الاجتهاد في مجال الفروع أو الأحكام؛ ما لبثوا أن تكونتْ لديهم عناصر علمٍ إسلاميٍّ أصيلٍ؛ ألا وهو علم أصول الفقه؛ الذي هو في الأساس علمٌ فلسفيٌّ يعدُّ جزءًا أساسيًّا من أجزاء الفلسفة الإسلاميَّة.
ولا يجانبنا الصواب إذا أشرنا إلى انتماء مدرسة عبد الرازق إلى مدرسة محمد عبده، وهذا بدوره إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني؛ ذلك لنتبين قدر الأثر الكبير في استعمال المنهج العقلي في تناول قضايا كان المستشرقون يرونها حكرًا على العقلية الغربية.
ما أهم الأفكار أو المذاهب الفلسفية الحديثة التي ترونها بحاجة للدرس والفحص، خاصة من زاوية الفكر الإسلامي؟
هناك مذاهب فلسفية تحتاج للقراءة إما الجديدة، للتعرف عليها، وإما إعادة القراءة لنقدها وبيان تهافتها منهجًا وموضعًا مثل: العولمة/ الكوكبة، وما بعد الحداثة، والتفكيكية؛ فهذه ليست مجرد مناهج فكرية، بل هي “تطبيقية” سوف تبدأ بما قد نوافق عليه، لكنها ربما انتهت إلى ما نرفضه؛ إما على صعيد الانتماء العقدي، أو على صعيد الانتماء التاريخي.

