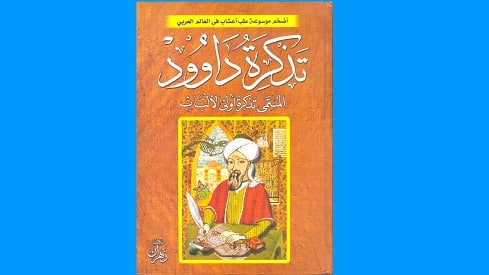قصتي مع التذكرة قصة ذات شجون وعلاقة عاطفية قوية فرضتها الظروف والنوازل ومقتضيات الواقع، وأخص الوقع الصحي وطوارئه التي لا تكاد تنتهي ولاتختفي .
وهذه القصة ابتدأت في لحظة حرجة وظرف صعب مرت به ابنتي الكبرى الغالية وهي في عز طفولتها ونعومة نشوئها، بسبب احتباس حبة عباد الشمس ابتلعتها بغير قصد بين مدخل البلعوم والمريء عند الحنجرة، فلم أجد إلا كتاب “تذكرة الأنطاكي” حلا للنازلة الصحية وأنا في طريقي إلى فرع “الزاوية البودشيشية” بتطوان لأذكر اللطيف بين العشائين، حيث اشتريت نسخة من الكتاب بما لم يتجاوز ثمنه الخمسين درهما، ما أزهده من ثمن ! فكانت المفاجأة وكان العلاج الحاسم وكان لطف الله تعالى، بعدما احتار الأطباء المتخصصون في ذلك وكل أدلى بدلوه، ولا أفصل في الموضوع لأن الوقت لا يحتمل !.
وحينما نعود للحديث عن مثل كتاب “تذكرة أولي الألباب والعجب العجاب” لداود بن عمر الأنطاكي فليس ذلك لأننا نطرح ما يسمى بالطب البديل أو التكميلي، ولكن لكي ننبه وننوه بالطب القديم في زمن اضطراب الطب الحديث وتردده أمام هجوم فيروس كورنا المستجد، على اعتباره علما قائما بذاته وله قواعده وضوابطه وتشخيصاته التي لا تقل عما هو عليه الطب الحديث، اللهم إلا في المصطلحات والآلات وتفريع التخصصات.
أولا: الطب القديم والتأسيس للضمير المهني
ومن الغلط كل الغلط أن يقارن هذا الطب الذي وظفه أمثال الأنطاكي وابن سينا قبله وابن رشد وابن زهر وحتى أبوقراط وجالينوس بما يجري اليوم من تسيب في مزاعم الطب البديل وفوضى في الوصفات وتطاول على الصيدلة الطبيعية وما إلى ذلك.والدليل نستقيه من هنا أي من التذكرة مباشرة.
في “تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب” المعروفة اختصارا بتذكرة داود الأنطاكي، كتاب في الطب يتألف من ثلاث أجزاء ألفها الطبيب العربي المشهور داود الأنطاكي ويتناول العقاقير النباتية، ويشمل 3000 من النباتات الطبية والعطرية. وتوجد من هذا الكتاب 37 نسخة خطية منتشرة في مكتبات الوطن العربي والبلاد الأوروبية والهند والولايات المتحدة وطبع عدة مرات وأغلب طبعاته هي مختصر تذكرة داود نظراً لطول مادته ووجود مصطلحات قديمة يصعب على القارىء المعاصر فهما وترجم هذا المؤلف للاتينية والتركية والفارسية والإنجليزية وغيرها من اللغات.
ومؤلف هذا الكتاب هو داوود بن عمر الإنطاكي (ولد بإنطاكية، وتوفي عام 1008 هـ/1599م، في مكة المكرمة) المعروف بالرئيس الضرير، ولد كسيحا ثم شفي من كساحه. ولد بقرية الفوعة في محافظة إدلب بشمال سورية، عاش بأنطاكية ونسب إليها، زار طلبا للاستزادة بالعلم دمشق والقاهرة وبلاد من الأناضول ومكة حيث استقر بها إلى حين وفاته. وكان عالما بالصيدلة والطب.
لكن المختصر لا يمكن له أن يصور لنا معنى الطب الذي بطبيعتها يتطلب التطويل والتشريح العميق للأجسام وعللها وأدوائها وأدويتها. ومن هنا سيكون الغلط والتغليط وستؤخذ الوصفات مبتورة عن مقتضياتها الطبية ولوازمها الضرورية كمنظومة متكاملة في العلاج والاستشفاء. ومع هذا فقد نختصر بدورنا الحديث عن هذا الموروث الثمين بسرد بعض النقاط التي يمكن أن يفهمها المثقفون العاديون كما قد يعيها جيدا الأطباء والمتخصصون.
فأول مسألة تعرض لها الأنطاكي هي تحديد قيمة الطب من بين العلوم مع التركيز على الحديث النبوي الشريف “طلب العلم فريضة على كل مسلم”، والأثر”الحكمة ضالة المؤمن“، هذا مع التنصيص على أن علم الطب علم شريف ولا ينبغي أن يسترذل ويتناوله ضَعَة الناس كما يستند على قول الشافعي: “علمان شريفان وضعهما ضعة متعاطيهما: الطب والنجوم” في حين قد ذهب إلى نظرية أرسطو حول الفضائل وصلتها بالطب عند قوله: “الفضائل تستحيل في النفوس الرذلة رذائل كما يستحيل الغذاء الصالح في البدن الفاسد إلى الفساد”.
ومن هنا فقد كان يمهد لما يعرف بالضمير المهني في المجال الطبي وأخلاقيات المهنة وذلك بتبني عهد أبقراط الشهير في الطب، والذي صاغه صياغة إسلامية أقتبس منه:”وعليك بحسن الخلق بحيث تسع الناس ولا تعظم مرضا عند صاحبه ولا تسر إلى أحد عند مريض ولا تجس نبضا وأنت معبس ولا تخبر بمكروه ولا تطالب بأجر، وقدم نفع الناس على نفعك، واستفرغ لمن ألقى إليك زمامه ما في وسعك فإن ضيعته فأنت الضائع وكل منكما مشتر وبائعنوالله شاهد علي وعليك في المحسوس والمعقول والناظر إلي وإليك والسامع لما نقول فمن نكث عهده فقد استهدف لقضائه إلا أن يخرج من أرضه وسمائه وذلك من أمحل المحال”.ثم يضيف :”ويجب اختيار الطبيب كامل الخلقة صحيح البنية نظيف الثياب طيب الرائحة يسر من نظر إليه وتقبل النفس على تناول الدواء من يديه”.
ولولا خشية التطويل والخروج عما قصدناه في المقال لفصلنا الحديث عن كل جملة وردت في هذا العهد وربطناها بالقوانين الطبية الحديثة سواء منها النفسية والأخلاقية، وكذا إيحاءاتها الظاهرية وصلتها بتطور حالة المريض نحو الأحسن أو الأسوأ بحسب الهيئة وما يتبعها.
ثانياً: خصوصية الطب وقوانين ضبط المجال
فمن أهم النقاط الرئيسية في الطب عند الأنطاكي هو تحديد المجال الذي يعمل فيه هذا التخصص وذلك لسد الباب أما التخليط العلمي واستعمال مسلك حاطب ليل أو الرمي في عماية.فيقول:”اعلم أن لكل علم (موضوعا)هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية(ومبادئ)هي تصوراته وتصديقاته(ومسائل)هي مطالبه الحالة مما قبلها محل النتيجة من المقدمتين (وغاية)هي المنفعة (وحدا)هو تعريفه إجمالا.فموضوع هذا العلم بدن الإنسان في العرف الشائع المخصوص والجسم في الإطلاق لأنه باحث عن أحوالهما الصحية والمرضية”.
وبما أن المسألة تتعلق بالأبدان فلا بد أن توظف عليها قوانين الأجسام وتقتبس أعراضها مما يعتري الصور المادية من مظاهر والتي قد لا تتجاوز أربعة طبائع لا غير وهي :النار والهواء والماء والتراب.وعليها يبني نظرية المزاج الذي يعني:”كيفية متشابهة الأجزاء حصلت من تفاعل الأربعة بحيث كسر كل سورة الآخر بلا غلبة، وإلا كان المكسور كاسرا والثاني باطل وهذا التفاعل بالمواد والكيفيات دون الصور وإلا لزالت عند التغير فلم يبق الماء ماء حال الحرارة أو خلت المادة عن صورة والكل باطل…”.
ثالثاً: العلاج بالمضادات والتنزيل العلمي للصيدلة
وتحديد هذه الأمزجة قد يكون الغرض منه التمييز بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الحيوانية، كما أنه من خلالها يمكن تشخيص حال المريض بالعين المجردة والمعاينة ثم قياسها على القانون العام الذي عليه الطبائع الأرضية، ولكن من جهة طبيعة الخلط، أي أنه مرتبط بنوعية الغذاء والتفاعل معه فتكون أعراضه ثابتة وعليها المعول عند العلاج، كالمزاج الصفاروي والسوداوي والبلغمي وكذا السوداوي…
ومن هنا يبدأ التحليل والتطلع نحو العلاج الذي غالبا ما يكون بالمضادات، أي توظيف التضاد الطبيعي بين العناصر كمعالجة الحرارة بالبوارد والرطوبات باليبوسات وغيرها. تماما كما وظفه أبو حامد الغزالي في” الإحياء”، ولكن على مستوى راقي وأخلاقي عقدي عند المقابلة بين مقامي الخوف والرجاء حيث يقول:” اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهم سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له، فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظراً إلى مواقع العلل معالجاً لكل علة بما يضادها لا بما يزيد فيها فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن الوسط.
وهذا هو نفسه ما قد يوظف في الطب الحديث عموما ولكن على مستويات عالية من الدقة والتجزيء المجهري والخلوي، قد يكون صحيحا في كثير من الأحيان وفي بعضها قد تكون له أعراض جانبية وربما خطيرة.
وحينما تتحدد هذه العناصر المتضادة فعندئذ يكون الجو مهيئا للبحث في الوسيلة الكفيلة بتحقيق العلاج، والتي قد تتوافق مع حالة المريض الرئيسية الثابتة، ويكون من اللازم تقسيمها إلى وضعين لا غير، إما أمراض وإما أعراض، ولا يمكن الولوج إلى تشخيص الأمراض إلا بالأعراض، وهاته الأخيرة قد تنقسم إلى شقين رئيسيين وهما: إما أعراض ثابتة عادية والتي قد تتغير بفعل الحركة والجو والغذاء والهواء وهي تغيرات فيسيولوجية محضة وإما أعراض مرضية تكون بسبب أمراض حقيقية لها ما لها من الصور التي لا يعلمها الكثير، تماما كما نص عليه الحديث النبوي الشريف. (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس).
لذا، فلا بد من صيدلية مفصلة قبل الحديث عن الأعراض والأمراض، في هذه الصيدلية يتبين العمق الطبي والاعتبار العلمي الدقيق والتي ليست مجرد صيدلية أعشاب كما يتوهم الكثير، وإنما هي صيدلية شاملة لجميع المواد الموجودة على وجه الأرض من عناصر كيماوية وفيزيائية وحيوانية وجرثومية (حشرات وديدان) ومائية، بل حتى طلسمية ذات حسابات غريبة عبر عنها الأنطاكي بعلم الخواص، وهي ليست شعبذات ولا دجل وإنما هي أرقام وحسابات فلكية وأرضية توظف في بعض الحالات المستعصية. وهذه الصيدلية ليست هي مصدر العلاج كما يتوهم أيضا بعض المتسلقين للميدان، ولكنها مخزن خاص بالمواد المحفوظة والمتعددة الاستعمالات لا يعلم تفاصيلها إلا الطبيب المختص ومعه الصيدلي المتبحر في خصائص الدواء.
فمثلا حينما يتحدث الأنطاكي وقبله ابن سينا وغيره عن عشبة أو مادة ما فإنه يحدد طبيعة المادة من حيث حرارتها وبرودتها ويبوستها ورطوبتها وأثرها على القلب أو الكبد وما إلى ذلك وفي نفس الوقت يورد عشبة أو مادة معدنية أو علكية مضادة لتلك المادة ومانعة من إحداث مضاعفات الأولى وهكذا دواليك.
كما قد يحدد المدة الزمنية لصلاحية المواد والأعشاب وتغيراتها عبر المراحل كمثلا: حارة في الأولى باردة في الثانية ورطبة في الأخيرة، بل هذه قوة حرارتها تبقى سنة أو سنتين …كل هذا قد يعطي لنا صورة نمطية حول الطبيعة العلمية للطب القديم، الذي لم ينتبه له كثير من أطبائنا المعاصرين ولم يستفيدوا منه كدعم للطب الحديث ومرجعية عند الضرورة، في حين تطاول المتهورون وأنصاف المتطببين، ممن يسمون بأصحاب الطب البديل، ففعلوا ما فعلوا ووصفوا ما وصفوا، والله أعلم بما كانت النتائج، بالرغم من مزاعم الاستشفاء بهذه العقاقير أو تلك.
وبعد الصيدلة يشرع الأنطاكي في التطبيق الطبي وتوظيف القواعد السابقة بدقة وعقلية صارمة قد نعجز عن مسايرتها ومطاولتها.فهل هذا التراث وهذا العلم مما يرمى في سلة المهملات أو يصفف في الرفوف ولا يتسفاد منه ؟
ولم لا يراجع كثقافة في زمن عجز أهله عن مقاومة جزيء صغير لا ندري؟ هل هو من صنف الحَوار والأحرار أم من البوارد والمجمَّدين؟
” فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا”.