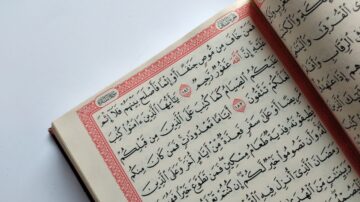من آيات الربا في القرآن من سورة البقرة قول الله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (276) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (277) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (279) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280)﴾ [البقرة: 275-280]
رأيت أن من المناسب للتعليق على هذه الآية أن أقسم هذا التعليق إلى فقرات كل فقرة بعنوان، وذلك حسب تسلسل الآية نفسها .
آخر آية نزلت في القرآن
روى البخاري[1] قول ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي ﷺ. فقال جبريل: ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة.
وعاش بعدها رسول الله ﷺ أحداً وعشرين يوماً. وقال ابن جريج: تسع ليال. وقال سعيد بن جبير: سبع ليال. ومات يوم الاثنين لليلتين خلنا من شهر ربيع الأول.
وقيل: ثلاث ساعات[2].
معنى “يأكلون” في الآية
الأكل: المراد به الكسب والأخذ والفعل. وقد خص بالذكر لأنه من المقاصد الضرورية الأولى للإنسان في المال، فهو أهم توابع الكسب، فأقيم الأكل مقام الكسب كله، وإن كان يدخل في هذا الكسب أيضاً: اللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال والصدقات …
تفسير “لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان”
القيام أي من القبور، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد. ومما يقوي هذا التأويل قراءة ابن مسعود: “لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم ….” أي بزيادة “يوم القيامة” إلى الآية .
وذهب ابن عطية إلى أن هذا القيام يكون في الدنيا، ويعرف من حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا، فالطمع والرغبة يستفزانه حتى تضطرب أعضاؤه. وضعف القرطبي هذا التأويل مستعيناً بقراءة ابن مسعود، كما مر .
غير أن صاحب تفسير المنار[3] رأى أن (المتبادر إلى جميع الأفهام ما قال ابن عطية، لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث). ثم ضعف الروايات المخالفة، وذكر قول الإمام أحمد : (قلما يصح في التفسير شيء). ثم قال: (أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في نفسه، فإن أولئك الذين فتنهم المال واستعبدهم، حتى ضريت (= تعلقت ) نفوسهم بجمعه، وجعلوه مقصوداً لذاته، وتركوا لأجل الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي، تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس. ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم، كما تراه في حركات المولعين بأعمال البورصة[4] والمغرمين بالقمار، يزيد فيهم النشاط والانهماك في أعمالهم، حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة …..).
ثم حاول الجمع بين قول ابن عطية والجمهور فقال: (ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظام المألوف هو أثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم، كان لا بد أن يبعثوا عليه، فإن المرء يبعث على ما مات عليه، لأنه يموت على ما عاش عليه).
وبهذا يتحصل في القيام ثلاثة أقوال: الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة، والثالث في كليهما معاً، وإني أميل إلى هذا القول الأخير، والله أعلم بصحته.
التخبط والمس والجنون كعقاب لآكل الربا
معنى التخبط
التخبط: هو الضرب على غير استواء، كخبط البعير الأرض بيده. ويقال للذي يتصرف في أمره ولا يهتدي فيه، إنه يخبِطُ خبط عشواء. وتخبطه الشيطان: إذا مسه بِخَبَل أو جنون، وتسمى إصابة الشيطان خبطة[5]. فجعل هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أن الله تعالى أرباه في بطونهم فأثقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون والناس يمشون عليهم .
وقد يكون التخبط في الدنيا كما مر في القيام، أو في كليهما معاً.
تعريف ومعنى المس
المس: الجنون، والممسوس: المجنون. قال الراغب في مفردات القرآن: (والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى، نحو قوله ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: 80] ، و﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ [البقرة: 214]، و﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر: 48]، ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، ﴿ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ [ص: 41]…) إلخ .
وذكر القرطبي أن العلماء جميعاً اتفقوا على أن أكل الربا يبعث كالمجنون عقوبة له، وتعقيباً عند جميع أهل المحشر.
وفي حديث الإسراء: فانطلق بي جبريل، فمررت برجال كثير، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، متصدين على سائلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشياً، فيقبلون مثل الإبل المهيومة[6]، يتخبطون الحجارة والشجر، لا يسمعون ولا يعقلون. فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قامواء فتميل بهم بطونهم، مصرعون، ثم يقوم أحدهم، فيميل به بطنه، فيصرع فلا يستطيعون براحاً (= تحولاً ) حتى يغشاهم آل فرعون، فيطؤونهم مقبلين ومديرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة، وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم الساعة أبداً فإن الله تعالى يقول : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46] . قلت: يا جريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)[7].
هذا والقيام والتخبط والمس أحوال مترابطة، تكون في القيامة، أو في الدنيا، وربما في كليهما معاً، والله أعلم .
الفرق بين البيع والربا
قوله: (قالوا: إنما البيع مثل الربا…) فيه التفرقة بين البيع والربا.
تحليل أقوال المشركين
مراد المشركين من قولهم أحد احتمالين :
(أ) إذا كان الربا حراماً فيجب أن يكون البيع حراماً أيضاً، فهذا نظير هذا، ففي كل منهما زيادة[8]. وعلى هذا الاحتمال يكون التشبيه على وجهه، فالبيع هو المشبه والربا هو المشبه به والزيادة هي وجه التشبيه.
(ب) إذا كان البيع حلالاً، فيجب أن يكون الربا حلالاً أيضاً، بل إن الربا واضح الحلية، حتى إننا نشبه البيع بالربا، ولا تشبه الربا بالبيع كقولك : القمر كوجه ليلى، مبالغة في جمالها. على هذا الاحتمال يكون التشبيه مقلوباً، لأن مرادهم تشبيه الربا بالبيع ولكنهم رغبة منهم في المبالغة والتوكيد على حلية الربا، قلبوا الأمر فجعلوا البيع هو المشبه، والربا هو المشبه به، أو جعلوا الربا أصلاً مقياً عليه، والبيع فرعاً مقياً، فهذا هو قياس العكس[9].
لقد قالوا، والقول يصلح دليلاً للاحتمالين، لا لواحد دون الآخر، (سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح، وعند المحل لأجل التأخير[10]، أي سواء علينا الزيادة الأولى في البيع، أو الأخيرة في الربا[11].
ويزيد مرادهم وضوحاً بمقارنة نعقدها بين الربا والبيع المؤجل . فإذا باع أحدهم سلعة ثمنها النقدي عشرة بخمسة عشر نسيئة، فلماذا لا يجوز أن يعطي العشرة معجلة بخمسة عشر مؤجلة ؟[12]
وبصورة أوضح : إذا باع سلعة بخمسة عشر إلى شهرين، فلماذا لا يجوز، إذا باعها بعشرة إلى شهر أن يزيد خمسة إذا أجل المدين شهراً آخر؟ أفليست النتيجة واحدة وهي أن ثمن السلعة خمسة عشر إلى شهرين ؟[13].
ويبدو أن هذه المحاكمة قد أثرت على الشيخ محمد رشيد رضا، فذهب إلى أن الزيادة الأولى للأجل حلال في كل من القرض والبيع، بخلاف الزيادة عند المحل ( = تاريخ الاستحقاق) ، ولعله رأى أن الزيادة تمنع عند عجز المدين فقط. وتبعه في ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف[14]، وكذلك الدكتور محمود أبو السعود[15]، فبالاستناد إلى جواز الزيادة للأجل في البيوع المؤجلة، أجاز فائدة الودائع المصرفية الحالة، وحسم الأوراق التجارية، والقرض العقاري .
حكم فوائد الودائع المصرفية
فوائد الودائع المصرفية من البنوك التقليدية هي عين الربا الذي حرم الله تعالى صريحا في القرآن الكريم أخذا أو عطاء وهذا ما قرره جميع المجامع الفقهية، ويختلف العقد الربوي تمامًا عن المضاربة الشرعية، فالبنوك التقليدية لا تقوم بأي نشاط تجاري أو استثماري، وإنما تقدم فوائد ثابتة تخالف مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. الفائدة المركبة التي تطبقها هذه البنوك تشابه ما كان عليه الربا في الجاهلية، وهو ما نهى عنه القرآن صراحة. القرار الذي يبيح فوائد البنوك مبني على أخطاء فقهية ومعلومات غير صحيحة. لذلك، يجب تصحيح هذه المفاهيم وعدم الانخداع بفتاوى تخالف الشريعة والإجماع الإسلامي
سنبين في فصل لاحق لماذا جازت الزيادة في تأجيل البيوع، ولم تجز في تأجيل القروض ؟
ونبين هنا أن قوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) لا يعني أن كل بيع حلال، ولا كل ربا حرام. قال الشافعي[16]: (إنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله في كتابه أو على لسان نبيه). فمعلوم من كتب السنة والفقه أن هناك بيوعاً ربوية محرمة، وبيوعاً أخرى محرمة لأسباب أخرى غير الربا، كالغرر والغش وغير ذلك .
تعريف الموعظة
الموعظة: والوعظ بمعنى واحد، وهو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، قاله الخليل[17]، وقال الراغب في مفرداته: الوعظ زجر مقترن بتخويف .
تفسير (فله ما سلف وأمره إلى الله)
قوله: “..فله ما سلف وأمره إلى الله”: أي له ما سبق أنْ قَبَضَهُ من الربا قبل نزول تحريمه[18] فلم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضاً، أما ما لم يقبض، وإن كان معقوداً قبل التحريم، فيأتي في الآية أنه يجب تركه وعدم قبضه[19].
أما من أربي بعد التحريم ثم تاب فيلزمه رد جميع ما أخذه بالربا، حتى ولو لم يعلم بالتحريم، فالجهل بالأحكام يرفع حق الله دون حق العباد[20].
وأمره إلى الله، أي ليس الأمر إليكم، حتى تطالبوه بما سلف.
أما من قال بأن معنى أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا المعنى لا يليق بقوله: (فله ما سلف)، فكيف يعفو عنه ثم يحاسبه؟ اللهم إلا أن يكون معنى له ما سلف أي لا تحاسبوه قضاء، وأمره إلى الله أي متروك لديانته فقيه حث على رد جميع ما أخذ بالربا.
وذكر المفسرون معاني أخرى رأيت عدم إثباتها لبعدها .
عقوبة العودة إلى الربا
العودة إلى الربا فيها معنيان :
(أ) عاد إلى أكل الربا.
(ب) عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا.
فمن استحل الربا بعد تحريمه، سواء بالقول أو بالعمل فقد كفر، والعياذ بالله، وصار من أصحاب النار الخالدين فيها كما في الآية.
تفسير {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
المحق : النقص والذهاب، ومنه مَحَاق القمر : انتقاصه . مَحَقَهُ : انقصه وأذهب بركته. وقرأ ابن الزبير “يمحِّق” بتشديد الحاء، و يربي بتشديد الباء ، وروي كذلك عن النبي ﷺ.
وتمحيق الربا وتربية الصدقات، يكون في الدنيا، وفي الآخرة.
(أ) ففي الدنيا يذهب الله بركة الربا، وإن كان كثيراً. وهذه معاملة لأكليه بنقيض قصدهم، ولهذا المحق صور منها هلاك المال من يد صاحبه، أو من أيدي ورثته، حتى يصيروا في غاية الفقر والذل والهوان ومنها ما يلحق بأكله من الذم والبغض وسقوط العدالة وزوال الأمانة وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة، ودعاء من ظلم عليه باللعنة، ودعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب . ومنها ما يصيب أكلة الربا من محن كثيرة من الظلمة واللصوص وغيرهم، زاعماً هؤلاء أن المال ليس مالهم في الحقيقة[21]. ولهذا كله جاء في الحديث: “أن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قُل[22].
وفي الدنيا يربي الله الصدقات، أي ينميها بالبركة، قال تعالى : وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المُضْعِفُون) (سورة الروم: الآية (٣٩)، وقال تعالى : (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) [سورة البقرة: الآية ٢٤٥]. وفي الحديث: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من ماله. رواه مسلم ٤٤٨/٥ وغيره.
وفي الحديث أيضاً : أنه ما من يوم إلا وفيه ملك ينادي: اللهم أعط منفقاً خلفاً، رواه الشيخان وغيرهما.
ومن صور نماء الصدقة في الدنيا حسن الأحدوثة لصاحبها، فيزداد جاهه وذكره الجميل، وتميل القلوب إليه، ويدعو الفقراء له، وتنقطع أطماع الناس عنه، فلا يتعرض له، ولا لماله، طامع ولا ظالم ولا فقير.
(ب) وفي الآخرة يمحق الله الربا، قال ابن عباس: لا يقبل منه (من أكل الربا) صدقة ولا حجاً ولا جهاداً ولا صلة[23].
وفي الآخرة تربو الصدقات، فقد جاء في الحديث: إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى يجيء يوم القيامة، وإن اللقمة لعلى قدر أحده. رواه مسلم. وفي حديث آخر: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل متفق عليه[24].
ويفهم من الآية أن القرض بلا ربا يعد من الصدقات. وقد بين الفقهاء أن القرض في الإسلام عقد معونة ومواساة وإرفاق. وقد ذهب الظن ببعض المعاصرين إلى أن الربا المحرم هو الربا على القروض الممنوحة إلى الفقراء لأغراضهم الاستهلاكية الضرورية. يريدون بذلك أن يصير القرض قرضين : قرضاً بلا ربا للفقراء يكون لهم صدقة وقربة، وقرضاً ربوياً للأغنياء والتجار يكون لهم منفعة في الدنيا. وسنعرض لهذه الشبهة في فصل مستقل لاحق.
صفة كفار أثيم
الكفار الأثيم : كلاهما صيغة مبالغة من الكفر والإثم. وقد يكون كلا الوصفين عائداً إلى مستحل الربا بالقول أو بالفعل، كما بينا في (العودة إلى الربا) فهو كفار أثيم من أصحاب النار الخالدين فيها. وقد يكون الكفار وصفاً للمستجل والأثيم وصفاً للعاصي. وربما كانا وصفين للعاصي المستمر في أكل الربا المتمادي فيه، ذلك أن أكل الربا من الأعمال الخبيئة التي إذا داوم عليها صاحبها قد تؤدي به إلى الكفر وسوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذا تحذير عظيم من مواقعة الربا[25] .
ترك ما بقي من الربا
المقصود بترك الربا الباقي في قوله تعالى : (وذروا ما بقي من الربا) أي اتركوا غير المقبوض، وإن كان معقوداً عليه قبل نزول التحريم، وقد مر أن المقبوض لا يفسخ .
وقد نقل ابن الجوزي[26] عن ابن عباس وعكرمة والضحاك : (أن كل ربا كان قد ترك، فلم يبق إلا ربا ثقيف).
فقد روى الواحدي عن السدي: كان العباس وخالد بن الوليد شريكين في الجاهلية، يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف في الطائف)، فجاء الإسلام[27]، ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله هذه الآية (…)، فقال النبي ﷺ : “ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس”[28].
أما ثقيف فقد كانوا أسلموا وعاهدوا النبي ﷺ في السنة التاسعة للهجرة على أن مالهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم من ربا فهو موضوع عنهم. فلما جاءت آجال رباهم بعثوا إلى بني المغيرة المخزوميين في مكة يطالبونهم بالقضاء، فامتنع بنو المغيرة عن الدفع، ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد، وكان قد بعثه النبي ﷺ والياً على مكة، فكتب عتاب إلى رسول الله ﷺ، فلما نزلت الآية، كتب بها رسول الله إليه وقال : “فإن رَضُوا وإلا فأذنهم بحرب”[29].
حرب الله ورسوله على آكل الربا
حرب الله ورسوله في الآية تهديد لهم بأنهم إن لم يكفوا عن الربا فهم محاربون الله ولرسوله: أي أعداء. والظاهر أن المراد بالآية الحرب في الدنيا أيضاً، ولا أدل على ذلك من أن الحرب أضيفت إلى الله والرسول، فعلى الرسول ﷺ بوصفه النبي وبوصفه الإمام أن يعلن الحرب عليهم، ومن حاربه الله، فكيف يتردد حاكم المسلمين في حربه؟
قال أهل المعاني: (حرب الله النار، وحرب رسول الله السيف)[30]. وعن ابن عباس قال: (يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب)[31]! وعن أبي حنيفة أن هذه الآية أخوف آية في القرآن)[32]. وقال مالك: (إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه، فلم أر شيئاً أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب)[33]، وقد رأى أن الربا أشر من الخمر.
وقد روي أن الآية لما نزلت، قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. فمن كانت له شوكة ولم يقدر عليه إلا بنصب حرب وقتال نصبوا له الحرب والقتال، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. فقتال آكلي الربا كقتال مانعي الزكاة، أفلم يجمع القرآن بين الربا والزكاة في آية واحدة؟
قال ابن خويز منداد: لو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة. وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك ؟[34]. وقال قتادة : أوعد الله أهل الربا بالقتل، فجعلهم بهرجاً أينما ثقفوا[35].
وروي أن النبي كتب إلى نصارى نجران، وهم من أهل الذمة: إما أن تذروا الربا، وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكان قد صالحهم على أن لا يأكلوا الربا فقال في آخر كتابه إليهم: فمن أكل الربا فذمتي منه بريئة.
أما من ليس له شوكة، فقد روي عن ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس فيمن أربي أن الإمام يستتيبه، فإن تاب وإلا قتله[36]. وهذا محمول على أنه يفعله مستحلاً له. فلا خلاف بين أهل العلم أن المؤمن بالتحريم لا يعد كافراً. ويمكن أن تتم الاستتابة بالتعزير كالحبس والضرب إلى أن يتوب .
أما من لم يدع الربا معصية، لا استحلالاً، فقد ذهب العلماء إلى أن إعلان الحرب عليهم لا يوجب تكفيرهم. ففي الحديث: “من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب” رواه البخاري. فيجوز محاربة من عظمت معصيته، وجاهر بها، وإن لم تبلغ حد الكفر.
التوبة من الربا: كيف تتم شرعًا؟
إن سبيل التوبة مما في يده من مال حرام، سواء كان رباً أو سواه، أن يرد المال إلى صاحبه إلى من أربى عليه، فيطلبه إن كان حاضراً، حتى إذا أيس من وجوده، أو لم يعد يعرفه، لم يجز له الاحتفاظ لنفسه بهذا المال، لأنه ليس حقاً له، بل عليه أن يدفعه إلى الفقراء، أو أن يصرفه في المصالح العامة للمسلمين .
فإذا لم يعرف المال الحرام من الحلال في يده، فإنه يتحرى، ويتخلص من قدر من المال لا يشك معه أن ما بقي له حلال خالص. فإن أحاط به الحرام، حتى إنه لا يطيق دفعه لكثرته، وجب عليه أن لا يبقي لنفسه إلا بمقدار ضروراته الدنيا، قال بعضهم: هو ما يستر العورة في الصلاة من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه، وهو ما يجوز له من مال غيره عند الضرورة، وإن كرهه هذا الغير[37].
رأس المال: ماذا يستحق المقرض في الإسلام؟
رأس المال في الآية تصريح واضح بأن ليس للمربي أو للمقرض إلا رأس ماله بلا أي زيادة. أما النقصان فجائز أو مستحب كما سيأتي في الآية. فرأس المال هو أصل المال وأوله فلا يجوز أي ربا، مضاعفاً كان أو يسيراً، فكله ربا ممنوع.
لا تظلمون ولا تُظلمون
لا تَظلمون
أجمع المفسرون على أن اشتراط الزيادة ظلم، وأن القرض بطبيعته لا يمكن أن يكون إلا عقد إحسان، فحالة المستقرض تستدعي الإحسان، والإحسان يكون بالقرض أو بالصدقة. أما الربا فهو ظلم له. فكيف تكون حاجة المحتاج موضعاً للمتاجرة والمراباة والاستغلال، والمساومة في المعدل، فتغلي عليه كلما زادت حاجته واشتد فقره إن طلب العوض ممن يحتاج إلى معونة ظلم، وحقه أن يطلب ههنا من الله تعالى الغني القادر.
وهاهنا قد يقال: إن القروض قد تمنح لغير الفقراء، فلا يظلمهم المقرض إذا طلب منهم فائدة قليلة. قال في تفسير المنار[38]: (في الآية أن الربا حرم لأنه ظلم ولكن بعض ما يعده الفقهاء منه لا ظلم فيه، بل ربما كان فيه فائدة للآخذ والمعطي)، وقد علمت سابقاً أن صاحب المنار لا يعد من الربا المحرم أخذ الفائدة عند عقد القرض، إنما يمتنع عنده الربا عند حلول القرض. كما علمنا، من فتاواه[39]، أنه رأى جواز حسم الأوراق التجارية لدى المصارف.
وجواب هذا أن رأس مال القرض هو مبلغه بلا أي زيادة، وأخذ المقرض فائدة مقطوعة من المستقرض، ولو كان تاجراً، فيه ظلم له، لأنه يعرض المستقرض للخطر، خطر الخسارة وحده، في حين أن المقرض يحصن نفسه منها. والعدل في هذا هو أن يشترك معه في الربح على سبيل القراض ( = المضاربة ) لا القرض. وقد نبه إلى مثل هذا الرازي[40].
أما إذا كان المستقرض غنياً، ويريد القرض لتلبية حاجاته غير الضرورية فلا يطلب من رب المال أن يقرضه، فخير له أن يقرض الفقراء والمحتاجين، وخير للغني أن لا يستقرض للسرف والترف، فالقرض بلا فائدة يكون عليه منة، وبفائدة يكون حراماً. ولو شاء رب المال إقراضه بلا فائدة، على سبيل المجاملة ورعاية الجوار أو القرابة أو الصداقة، فله ذلك، ولا إثم عليه.
ولا تُظلمون
أجمع المفسرون هنا أيضاً على أن معنى (لا تُظلمون) هو أنكم لا تظلمون بنقصان رأس المال[41]. أي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بالزيادة عليها، ولا تظلمون بالنقصان منها.
وذكر بعض المفسرين كالقرطبي وأبي حيان والبيضاوي[42]، أن المعنى يحتمل أن يكون: لا تظلمون في مطل، لأن مطل الغني ظلم، كما في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما.
وإنني أرجح أن المعنى: لا تظلمون عند الله بالثواب، وذلك للأسباب التالية:
(أ) القرض في الإسلام، مع أن بَدَلَيْه متساويان، لكن هذا التساوي كما هو معلوم في الشرع لا يتم إلا باتحاد زمن البدلين، وسنعود إلى هذا بالتفصيل والبرهان. فالقرض يدفعه المقرض في زمن ويسترد مثله في زمن آخر، فيكون هناك نساء أي تأخير أو تأجيل، وهو ربا النساء، وقد جاز في القرض إرفاقاً بالمقترض، ولم يجز في الذهب بالذهب، ولا في الفضة بالذهب، بيعاً.
وبعبارة أخرى فإن القرض معاوضة وتبرع في آن معاً، فهو معاوضة من حيث إنه يرد مثله، بخلاف الهبة أو الصدقة، لا ترد، وتبرع من حيث إن المقرض يتخلى عن ماله لمدة زمنية معينة، أي فيه ربا نساء لصالح المقترض.
ويمكن التعبير عن ذلك أيضاً بأن القرض معاوضة ناقصة، لا يُجبر نقصها في الدنيا بالربا (= الفائدة)، بل يُجبر بالثواب عند الله، والثواب يجبر النقص ويزيد قال تعالى : (يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) [سورة النساء : الآية ١٧٣]. وقال تعالى : (من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً، فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) سورة البقرة: الآية ٢٤٥]. وقارن بين الأضعاف المضاعفة التي يأكلها المرابون في الدنيا [سورة آل عمران : الآية ۱۳۰]، والأضعاف الكثيرة التي يدخرها الله للمحسنين في الآخرة [سورة البقرة: الآية ٢٤٥].
وهذا الذي نقوله هنا هو معنى قول الفقهاء : إن القرض عقد معونة وإرفاق. فلولا ثواب الله لكان المقرض مظلوماً، ولذلك بشره الله تعالى بأنه لن يظلم أجره على إحسانه .
(ب) قوله تعالى : (لا تظلمون) يفهم منه أن رأس المال يعاد إلى المقرض من دون زيادة، وبمقدار مساو، أي أن النقصان الذي ذكره المفسرون مفهوم من قوله : (لا تَظلمون)، ومن الأفضل حمل قوله: (ولا تُظلمون) على معنى جديد فالتغاير أو التأسيس أولى من التأكيد، كما هو معلوم عند علماء الأصول والبيان، لأن فائدته أعظم، ونشدان الإفادة أفضل من التعطيل[43].
(ج) لو كان المعنى، كما هو ظاهر قول المفسرين، لأمكن للمقرض أن يتمسك بمبدأ الحفاظ على رأس ماله أي على قوته الشرائية، بحيث لو هبطت قيمة النقود، طالب باسترداد مبلغ القرض بقيمته يوم الإقراض. ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء، فيما نعلم، ولا سيما في نقود الذهب والفضة. وقال به بعضهم في الفلوس، وفي الفضة إذا غلب عليها الغش، أي إذا كانت نسبة المعدن الثمين نسبة قليلة مرجوحة[44] ..
(د) لو كان المعنى كما يقولون لأمكن أيضاً للمقرض، وهذا غير مراد للمفسرين والفقهاء أن يطالب المقترض بجبر ما فاته من منافع، وتعويض ما لحقه من أضرار، نتيجة تخليه عن ماله إلى المقترض، فقد يحتاج إليه، ولا يكون المقترض قادراً على رده إليه، وقد يعسر المقترض أو يفلس، فلا يخلو إقراض الفقراء والمحتاجين من مثل هذه المخاطر.
(هـ) ومما يؤيد هذا المعنى قوله تعالى بعد آية من السورة نفسها ۲۸۱ : (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)، فالأمر أمر ثواب، أي المعنى لا تظلمون بالثواب، والتعبير عنه بهذه الصورة مشهود له في القرآن إذن بشاهد قريب.
ولا يخفى على أهل البديع ما في العبارة على هذا المعنى من مشاكلة للعبارة السابقة لها، لأن الله سبحانه تعالى عن الظلم علواً كبيراً، فهذا على نسق قوله تعالى : (وما ربك بظلام للعبيد) [سورة فصلت: الآية ٤٦]، وقوله تعالى : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ ﴾ [سورة آل عمران: الآية ٥٤].
كما أرى أن قوله تعالى : (لا تُظلمون) يحتمل معنى لطيفاً آخر، لا تُظلمون عندما تقترضون، ولا تَظلمون عندما تقرضون، يؤيد هذا المعنى ما ورد من سبب النزول، حيث شرطت ثقيف على النبي ﷺ لإسلامهم أن يأخذوا الربا الذي لهم على الناس، ولا يدفعوا الربا الذي للناس عليهم، فعلى هذا يكون المعنى : لا تظلمون بقبض رباكم على غيركم، ولا تظلمون بدفع رباهم عليكم[45].
المماطلة ظلم
رأينا في السابق أن قوله تعالى : (ولا تُظلمون) يفيد فيما يفيده أن المدين إذا ماطل في سداد دينه فهو ظالم لدائنه.
حكم الإنظار للمُعسر
إذا كان الغني المماطل ظالماً يستحق العقوبة، فإن المعسر يستحق الإنظار، لا البيع (الاسترقاق) كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وهذه الآية ناسخة لفعلهم هذا. وإذا كان القرض مندوباً عند عقده المواساة المحتاج، فإن الإنظار مندوب عند إعسار المدين. وثمة أحاديث ترغب في هذا الإنظار .
وهذا الأمر القرآني بالإنظار يحتمل الندب كما يحتمل الوجوب. والندب هو قول مالك والجمهور[46].
ومن العجيب أن يذهب البعض إلى أن الإنظار كان في الديون التي كانت بالربا، وليست في القروض والديون غير الربوية[47]، فهذا مستغرب في النقل لوجود أحاديث كثيرة في فضل إنظار كل معسر، ومستهجن في العقل. وكانوا يستشهدون لمعارضة إنظار من كان عليه دين بقوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [سورة النساء: 58)]، مع أن الدين ليس وديعة عند المعسر حتى نسميه أمانة، نعم قد ينطبق عليه لفظ الأمانة إذا كان موسراً فقط .
الإبراء والصدقة: مقارنة بين القرض والإحسان المطلق
الصدقة والإبراء: لا شك أن القرض صدقة، والإنظار صدقة، والإبراء صدقة. ومن هذه الآية يفهم أن الصدقة أفضل من الإنظار، وأفضل من القرض، إذا تساوى مبلغ القرض ومبلغ الصدقة. وقد وردت آثار بأفضلية الصدقة على القرض، فعلى هذا تحمل. ووردت آثار أخرى بأفضلية القرض على الصدقة، وجاء تعليلها في الآثار نفسها، وهو أن سائل الصدقة قد يسأل عن غير حاجة وسائل القرض لا يسأل إلا عن حاجة. وهناك تعليل آخر وهو أن الصدقة عند الإنشاء تكون عادة بمبلغ أقل من مبلغ القرض، فقد يكون ثوابها أقل، لأن الثواب بلا ريب يتأثر في الصدقة بحجم المبلغ وبأنها لا ترد، ويتأثر في القرض بحجم المبلغ ومدته. أما الصدقة عند الإبراء من القرض، فهي منصبة على مبلغ القرض نفسه، فكانت أفضل ثواباً باعتبار استواء المبلغ في كل منهما، كما قلنا آنفاً.
ما هو حكم الربا في الإسلام؟
الربا محرم تحريمًا قطعيًا في القرآن الكريم، وقد جاء في سورة البقرة أن الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وتوعدهم الله بالحرب إن لم ينتهوا عنه، وأمر بترك ما بقي من الربا وأحل البيع الصحيح.