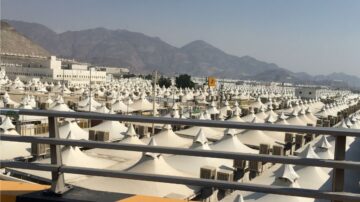ما هي مبطلات الحج؟ كثيرا ما يلجأ المسلمون الراغبون في أداء مناسك الحج، إلى طرح هذا السؤال على العارفين والمختصين. بل أن منهم من يطرح هذا السؤال حتى بعد الانتهاء تأدية فريضة الحج، ليعرف هل حجه صحيحا أم باطلا. فماهي مبطلات الحج؟ وماهي محظوراته للرجال والنساء؟ وماهو الإحصار في الحج؟ وما يترتّب على ارتكاب مبطلات الحج؟ وهل يوجد كفارة مبطلات الحج؟ وما حكم ارتكاب الحاج بعض المعاصي؟
الإنسان مطالب بتأدية العديد من العبادات المختلفة، ومن هذه العبادات ما يكون بالبدن كالصلاة والصيام، ومنها ما يكون بالمال كالزكاة. ومنها ما يجمع بين الإثنين، فتكون عبادته عبادة بدنية ومالية في نفس الوقت. وأبرز مثال على هذا النوع من العبادات، الحج، الذي يؤديه المسلم بجسمه وماله.
الحج فرض عين، على كل مسلم مكلّف، مستطيع، مرة واحدة في العمر، وقد ثبتت فرضيّته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع.
أما من القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (..وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا..) (سورة آل عمران – الآية 97).
أما من السنة النبوية فقد ورد عن النبي ﷺ قوله: (بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ؛ علَى أنْ يعبَدَ اللهُ ويُكْفَرَ بمَا دونَهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ). أما الإجماع فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب فريضة الحج على المسلم، مرة واحدة في العمر على المستطيع.
ولكن للحج شروط وأحكام ومبطلات. فما هي مبطلات الحج؟ وقبل ذلك ماذا نعني بالمبطلات؟
تعريف المُبطلات
قبل الحديث عن مبطلات الحج، نحاول شرح كلمة مبطلات، حيث جاء في قاموس المعاني في مسألة تعريف و معنى المبطلات مايلي:
بَطَل الشيءُ يَبْطُل بُطْلاً وبُطُولاً وبُطْلاناً: ذهب ضيَاعا وخُسْراً، فهو باطل، وأَبْطَله هو . ويقال: ذهب دَمُه بُطْلاً أَي هَدَراً وبَطِل في حديثه بَطَالة وأَبطل: هَزَل، والاسم البَطل
والباطل: نفي الحق، والجمع أَباطيل، على غير قياس، كأَنه جمع إِبْطال أَو إِبْطِيل، هذ مذهب سيبويه، وفي التهذيب: ويجمع الباطل بواطل، قال أَبو حاتم: واحد الأَباطيل أُبْطُولة، وقال ابن دريد: واحدتها إِبْطالة
وأَبْطَل: جاء بالباطل؛ والبَطَلة: السَّحَرة، مأْخو منه، وقد جاء في الحديث: ولا تستطيعه البَطلة، قيل: هم السَّحَرة.

وقالوا: باطل بَيِّن البُطُول. وتَبَطَّلوا بينهم تداولوا الباطل، عن اللحياني. والتَّبَطُّل: فعل البَطَالة وهو اتباع الله والجَهالة. وقالوا: بينهم أُبْطُولة يَتَبَطَّلون بها أَي يقولونه ويتداولونها.
وأَبْطَلت الشيءَ: جعلته باطلاً. وأَبْطل فلان: جاء بكذب وادَّع باطلاً.
وقوله تعالى: (..وما يبدئ الباطل وما يعيد) (سورة سبإ- الآية 49) قال: الباطل هن إِبليس أَراد ذو الباطل أَو صاحب الباطل، وهو إِبليس. وفي حديث الأَسو بن سَرِيع: كنت أُنشد النبي،ﷺ، فلما دخل عمر قال اسكت إِن عمر لا يحبُّ الباطل؛ قال ابن الأَثير: أَراد بالباطل صِناعَ الشعر واتخاذَه كَسْباً بالمدح والذم، فأَما ما كان يُنْشَدُه النبيُّ،صل الله عليه وسلم، فليس من ذلك ولكنه خاف أَن لا يفرق الأَسود بينه وبي سائره فأَعلمه ذلك والبَطَل: الشجاع.
ماذا يعني بطلان الحج؟
المُبطلات في اللغة هي مفسدات الأعمال، سواء تعلق الأمر بمبطلات الحج أو غيرها، فنقول: بَطلَ عملُه، أي: فسُدَ وذهب ضَياعاً، ويُعرَّف بطلان الحجّ بأنّه: وقوع الحجّ وأداؤه بصورةٍ غير كافيةٍ لإسقاطه، لسقوطه عن المكلّف، ويكون مُخالفاً لأصل الأمر، فلا ينعقد بأصله، وثمّة اتِّفاقٌ بين العلماء على أنّ الباطل لا يختلف عن الفاسد، وذلك في جميع العبادات، إلّا في الحجّ عند الحنابلة والشافعيّة، ويكمن التفريق بين الباطل والفاسد في الحجّ عندهم في أنّ الباطل لا يمضي فيه، ولا يجب قضاؤه، بخِلاف الفاسد.
وفقهاء المالكية والشافعية لا يفرّقون بين مصطلحَي الفاسد والباطل، أما فقهاء الحنفيّة فيفرّقون بينهما في باب المعاملات، أما فقهاء الحنابلة فلا يفرّقون بينهما إلاّ في موضعين؛ الحج والنكاح.
ما هي مبطلات الحج؟
ما هي مبطلات الحج؟ وماهى الأعمال التى تفسد الحج؟ وهل الجدال والفسوق يفسدان الحج؟ وهل الحج يكتب على الإنسان كما أداه مع ما كان فيه من أخطاء أو جدال؟
الحقيقة أن من مبطلات الحج وكما يقول معظم الفقهاء: الحج لا يفسد إلا بالجماع حال الإحرام، قال ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
والرفث المنهي عنه في قوله تعالى: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ. {البقرة:197} هو الجماع. وأما الجدال والفسوق- وهو المعاصي- فلا يفسد الحج بهما إلا أن الذنوب والمعاصي عموما لها تأثير على أجر الحاج، وقد يفوتان على الحاج ثواب الحج المبرور، قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق.
ومع ذلك فقد تعددت آراء الفقهاء في مبطلات الحج التي تُفسد النُسك، والتي يلزم بعدها القيام بعدد من الأمور لتجاوز هذا الإفساد، ويمكن أن نذكر مبطلات الحج التي تحدّث فيها أهل العلم، وقالوا بإفسادها للحجّ على النحو الآتي:
الردّة
من مبطلات الحج أنه إذا ارتدّ المُحرم أثناء الحجّ، وقبل تمامه بطل حجّه، لأنّ المرتدّ يصير في حكم الكافر، والكافر لا يُقبل منه أداء العبادات، قال -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ…)، [سورة التوبة-الآية 54] كما لا يصحّ منه الحجّ، حيث اشترط أهل العلم في وجوب الحجّ الإسلام، وهذا متعذّر في المرتد.
ترك ركن من أركان الحج
من ترك ركنا من أركان الحجّ كالوقوف بعرفة مثلا، بالوقت والمكان المحددين، أو ترك الإحرام من الميقات ولم يرجع إليه، ونحو ذلك من الأركان، فإن حجه باطل، وهذه الأمور هي من مبطلات الحج، وقيل إن كان ذلك من غير مانع قاهر سُمّي فواتاً، لأنّ نُسك الحجّ قد فات دون تدارك، وإن كان بمانع قاهر سُمّي إحصاراً، أيّ حال بينه وبين إتمام النُسك حائل لا قدرة له عليه.
النكاح والجماع
من أشد مبطلات الحج، النكاح وهذا يشمل أمرين: عقد الزواج، والجماع ومقدماته
أما عقد الزواج: فيحرم ولا يصح عند الجمهور ولا فدية فيه، فلا يتزوج المحرم ولو بوكيل غير محرم، ولا يزوج بولاية أو وكالة، فإن فعل فالزواج باطل. لقوله ﷺ: “لا يَنْكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب”، ومتى تزوج المحرم أو زوج، أو زُوِّجت محرمة، فالنكاح باطل؛ لأنه منهي عنه. وتكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب لحلال (غير محرم)، للحديث السابق «ولا يخطب» ولأنه تسبب إلى الحرام.
وأما الجماع ومقدماته: فيحرم الوطء في الفرج باتفاق الفقهاء على من كان محرما بالحج، ويحرم عليه كذلك مقدمات الجماع من تقبيل ولمس بشهوة ومباشرة وجماع فيما دون الفرج، لقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة :197] والرفث: ما يكنى به عن الجماع وجميع حاجات الرجال إلى النساء.
وقد فصل علماء الفقه في مسألة الجماع للمحرم وكونه من مبطلات الحج الذي يفسد الحج نلخصه فيما يأتي:
- إن جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أفسد حجه ومضى في سائر نسك الحج وعليه القضاء فوراً من العام القادم، حتى وإن كان نسكه تطوعاً، وعليه كفارة بدنة، لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وهذا باتفاق الفقهاء، وذلك سواء فعل ما ذكر من الجماع ومقدماته عامداً أو ناسياً أو مكرهاً.
- وإن جامع المحرم بين التحللين، أو جامع ثانياً بعد جماعه الأول قبل التحللين، فعليه شاة.
- وإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل، أو قبل أو لمس بشهوة أو باشر، فعليه كفارة دم، لكن لا يفسد حجه عند الجمهور غير المالكية، قال ابن عمر: «إذا باشر المحرم امرأته، فعليه دم»
الإغماء والجنون
ذهب بعض أهل العلم من الظاهريّة إلى أنّ الإغماء والجنون هي من مبطلات الحج؛ فمن أُغمي عليه، أو جُنّ قبل الزوال يوم عرفة فسد حجّه؛ سواء أكان واقفاً بعرفة أو غير واقف؛ وقد استدلّوا على ذلك بقوله -ﷺ-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ…).
وبناءً على هذا، فإنّ المجنون والمغمى عليه لا نيّة لهما، فإنّ كان ذلك -الجنون والإغماء- بعد الوقوف بعرفة، وحضور شيء من الصلاة بمزدلفة، فإنّ الحجّ في مثل هذه الحالة لا يفسد؛ لأنّ الله -تعالى- رفع عن المجنون والمغمى عليه القلم حتى الإفاقة، فإن استيقظا عادا لما كانا عليه من تمام الحجّ.
ماهو الإحصار في الحج؟
مبطلات الحج هي الأفعال التي تُبطل بها صحة الحج وتجعله غير صحيح، ويجب على الحجاج تجنبها. يجب أن نذكر أنه إذا تعذّر على الشخص القيام بالحجّ أو فوّت الفرصة للحجّ، فإن ذلك يعرف بـ”الإحصار” أو “الفوات”. فماهو تعريف الإحصار؟
الإحصارُ لغةً: المنعُ والحَبسُ
الإحصارُ اصطلاحًا: هو مَنْعُ المُحْرِمِ مِن إتمامِ أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ
أولا: الإحصار في القرآن الكريم
في قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196] ووجه الدلالة أنَّ سَببَ نُزولِ الآيةِ هو صدُّ المشركينَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه عن البيتِ، وقد تقرَّرَ في الأصولِ أنَّ صورةَ سَببِ النُّزولِ قطعيَّةُ الدُّخولِ، فلا يُمكِنُ إخراجُها بمخَصِّصٍ.
كذلك فإنَّ قولَه تعالى بعد هذا: فَإِذَا أَمِنْتُمْ يشيرُ إلى أنَّ المرادَ بالإحصارِ هنا صَدُّ العدُوِّ المُحْرِمَ
ثانيا: الإحصار في السنة النبوية
أمْرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه حين أُحْصِرُوا في الحُدَيبِيَةِ أن ينحَرُوا ويَحِلُّوا
ثالثا: الإحصار في الإجماع
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة، وابنُ تيميَّة وابنُ جُزَيٍّ
الإحصارُ بالمَرَضِ وغَيرِه: الإحصارُ يكونُ بالمَرَضِ وذَهابِ النَّفَقةِ وغيرِ ذلك، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، وهو قولُ ابنِ حَزمٍ، واختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّم، وابنِ باز, وابنِ عُثيمين

الأدلَّة: مِنَ الكِتابِ قولُه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ لفظَ الإحصارِ عامٌّ يدخُلُ فيه العدوُّ والمَرَضُ ونحوه
و مِنَ السُّنَّة، عن عِكرمةَ قال: سمعْتُ الحجَّاجَ بنَ عَمْرٍو الأنصاريَّ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابلٍ)، قال عِكرمةُ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن ذلك، فقالا: صَدَقَ.
أنواع الإحصار
الإحصارُ عن الوقوفِ بعَرَفةَ: اختلف الفقهاءُ فيمن أُحصِرَ عن الوقوفِ بعَرَفة دون البيتِ، على ثلاثةِ أقوالٍ:
- القول الأوّل: أنَّه ليس بمُحصَرٍ، وهو مَذهَب الحَنَفيَّة وروايةٌ عن أحمد؛ لأنَّه إن قدَرَ على الطَّوافِ له أن يتحلَّلَ به، فلا حاجةَ إلى التحلُّلِ بالهَدْيِ، كفائِتِ الحجِّ
- القول الثاني: يُعتَبَرُ مُحصرًا، ويتحلَّلُ بأعمالِ العُمرةِ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة؛ لأنَّه لَمَّا جاز أن يتحلَّلَ عن جميعِ الأركانِ، كان إحلالُه مِن بعضِها أَوْلى
- القول الثالث: يتحلَّلُ بعمرةٍ، ولا شيءَ عليه، إن كان قبل فَواتِ وقتِ الوُقوفِ، وهو مَذهَب الحَنابِلَة، واختارَه ابنُ عُثيمين؛ لأنه يجوزُ لِمَن أحرَمَ بالحجِّ أن يجعَلَه عمرةً، ولو بلا حصرٍ، ما لم يقِفْ بعَرَفةَ.
الإحصارُ عن طوافِ الإفاضةِ: وهنا اختلف الفقهاءُ فيمن وقَفَ بعَرَفةَ ثم أُحصِرَ عن البيتِ؛ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القول الأوّل: لا يكون مُحصَرًا، وعليه التحلُّلُ بالحَلْقِ يومَ النَّحرِ، ويَحِلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، حتى يطوفَ طواف الإفاضة في أيِّ وقتٍ قَدَرَ عليه، وهذا مَذهَب الحَنَفيَّة، والمالكيَّة
القول الثاني: أنَّه يكونُ مُحصَرًا، ويتحَلَّلُ، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة في الأظهَرِ
القول الثالث: أنَّه إن أُحصِرَ عن البيتِ بعد الوقوفِ بعَرَفة قبل رَميِ الجمرةِ، فله التحلُّلُ، وإن أُحصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ بعد رَمْيِ الجمرةِ، فليس له أن يتحَلَّلَ، وهذا مَذهَبُ الحَنابِلَة.
الإحصارُ عن واجبٍ مِن واجباتِ الحَجِّ: إذا أُحصِرَ عن واجبٍ فلا يتحَلَّلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
الإحصارُ عن العُمرةِ: يجوزُ للمُحرِمِ بالعمرةِ التحلُّلُ عند الإحصارِ، وهو مَذهَب الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وبعضِ المالكيَّة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
زوالُ الحَصرِ: متَى زالَ الحصرُ قَبلَ تحلُّلِه، فعليه إتمامُ نُسكِه، إلَّا أن يكونَ الحجُّ قد فاتَ، فإنَّه يَتحلَّلُ.
وقدم العلماء تعريفًا للإحصار بأنه منع المحرم من أداء أركان الحجّ، ويُسمح للمحرم بسبب الإحصار بالتحلّل من الحجّ. يمكن أن نستنتج من حادثة الحديبية التي حدثت في زمن النبي محمد ﷺ، أن الإحصار قد يسمح بالتحلّل من الحجّ، حيث خرج النبي ومعه الصحابة لأداء العمرة، ومنعتهم قريش من الوصول إلى البيت الحرام، وبعد ذلك تمت معاهدة الحديبية وتم العودة إلى المدينة المنورة، وفي السنة التالية تم تنفيذ العمرة.
ونجد في صحيح البخاري أيضا ما يدل على جواز الإحصار، حيث ذكرت حالة احتجاب النبي ﷺ وحلق رأسه.
الإحصار في بعض المذاهب الفقهية
فيما يلي تفصيل الإحصار في بعض المذاهب الفقهية:
المذهب الشافعي: يفوت الحجّ إذا لم يتم الوقوف في عرفة، ويتحتم على الحاج دفع الفدية إذا كان محرمًا بالحجّ الواحد أو القارن، ويجب عليه أداء باقي أعمال الحجّ مثل الطواف والسعي، ويتحلّل بحلق الشعر أو تقصيره، ويجب عليه قضاء الحجّ فورًا وأيضًا إحضار الهدي.
المذهب الحنفي: يقسمون الإحصار إلى أسباب شرعية وأسباب حسية. أمثلة على الأسباب الحسية هي وجود عوائق تمنع الحاجّ من إتمام النسك أو الحجز أو المرض. أما أسباب الإحصار الشرعية فتشمل فقدان المحرم للمحرم أو الزوج بعد الإحرام، أو عدم القدرة على المشي أو النفقة، أو منع الزوج للزوجة من أداء الحج النفل. إذا حُصِرَ الحاجّ، فلا يُسمح له بالتحلّل حتى يُذبَح الهدي في الحرم، وليس الحلق شرطًا للتحلّل بل يُفضَّل.
المذهب المالكي: إذا كان المنع ظُلميًا أو بالحق، يجوز للمحرم التحلّل بالنية وحُرِّم له الحلق، وإذا وجد الهدي فيجب ذبحه أو إرساله إلى مكة. أما إذا كان المنع بالحق، فيجب على المحرم أداء الهدي إذا كان بوسعه، وإلا فإنه يظل على الإحرام مثل الإحصار الظُلمي.
المذهب الحنبلي: يفوت الحجّ على من لم يقف في عرفة حتى طلوع فجر يوم النحر سواء كان لديه عذر أو لم يكن لديه عذر. يمكن للمحرم تحويل إحرامه إلى عمرة إذا لم يرغب في البقاء على الإحرام لأداء الحج في العام التالي. ويتحتم عليه ذبح الهدي وتأخيره للحج القضاء. إذا منع المحرم من إتمام النسك بعد الإحرام، فيجب عليه ذبح الهدي للتحلّل من الإحرام، وإلا فإنه يصوم عشرة أيام ويُعتبر هذا مثل الإحصار الظُلمي، والأفضل له أن يتحلّل بالنية.
12 من محظورات الإحرام للرجال والنساء؟
الحديث عن مبطلات الحج للرجال يقودنا للحديث أيضا عن محظورات الإحرام، وهي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها، فإن قام بها وجبت عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، ومن المحظورات التي يختص بها الرجال دون النساء ما يلي:
- لبس الذكر المخيط أو المحيط ببدنه أو بأي عضو منه. وإذا لم يجد المحرم نعلا ووجد خفا، فإنه يلبسه بعد أن يقطعه أسفل من الكعبين.
- لبس الأنثى المحيط بكفها أو أصابعها، ويغتفر لها الخاتم دون الرجل.
- تغطية الرجل رأسه، وستره وجهه بأي شيء، لما رواه نافع عن ابن عمر (ض) من أنه كان يقول “ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم”.
- ستر المرأة وجهها أو بعضه، ولو بخمار أو منديل، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها كما يقال.
- دهن الرجل أو المرأة الجسد أو الشعر بدهن مطيب أو غير مطيب لغير علة، فإن فعلا ذلك لزمتهما الفدية. وإذا كان الادهان لعلة جاز ولا فدية فيه ما لك يكن بدهن مطيب.
- إزالة الظفر أو الشعر أو الوسخ لحديث كعب بن عجزة (ض) أن رسول الله ﷺ قال له: “لعلك آذاك هوامك؟ قال له: نعم، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة”.
- مس الطيب، ولبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، لقوله ﷺ: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس”.
- استعمال الحناء والكحل، إلا للضرورة.
- الجماع، ومقدماته، والإنزال، لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق في الحج) والرفث شامل للجماع ومقدماته.
- الزواج والتزويج، لقوله ﷺ: “لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب”.
- التعرض لشجر الحرم الذي من شأنه أن ينبت بنفسه، بقطع أو قلع أو إتلاف إلا الإدخر.
- التعرض للحيوان البري ولبيضه، وإن تأنس كالغزال والطيور، أو كان لا يؤكل كالخنزير، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).
ما يترتّب على ارتكاب مبطلات الحج
ذهب الفقهاء إلى أنّ مفسد حجّه يُعد آثما، وتلزمه التوبة من ذلك، بغض النظر عن مبطلات الحج التي وراء ذلك، واشترط بعضهم إتمام الحجّ الفاسد إلى نهايته، ومن ثمّ قضائه في العام القادم على الفور، فإن تعذّر فإن القضاء يكون على الاستطاعة، وقد أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة الكرام، كما يجب على مفسد الحجّ بالجماع فديّة مغلّظة، بذبح بدنة -الإبل-، مع تفريقها على فقراء الحرم.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن رفع عنها الأغلال التي كانت على من قبلها من الأمم، فخفف عنها أثقال غيرها، ويسر عليها أمر عبادتها فقال سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} (سورة النساء 28). وقال جل وعلا: {هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج} (سورة الحج 78)، ولهذا جعل الله تعالى للمسلم ما يستدرك به النقص الحاصل في عبادته، وشرع له ما يكفر به ما ارتكبه من محظور حال العبادة، ومن هنا جاءت مشروعية الفدية في الحج.
والفدية تجب على المحرم بواحد من عدة أمور، هي أن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام، أن يترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، أن يكون متمتعاً أو قارناً وهو دم شكران وليس دم جبران، وأن يفوته الحج أو يحصر عنه.
أما الفدية الواجبة بارتكاب المحظورات فتختلف من محظور لآخر، وهذه المحظورات يمكن تقسيمها بحسب الفدية إلى أربعة أقسام:
1- ما لا فدية فيه
وهو عقد النكاح، فمن مبطلات الحج إذا عقد المحرم عقد نكاح، أو عُقد له، فإن العقد باطل في قول أكثر أهل العلم، والعاقد آثم بفعله، لكن ليس عليه فدية.
2- ما فديته مغلظة:
وهو الجماع حال الإحرام، وهو من مبطلات الحج، فإذا جامع المحرم زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول أثم، وفسد حجه وحجها إذا كانت مطاوعة له، ولزمهما معاً أن يمضيا في حجهما، ويستمرا فيما بقي عليهما من أعمال، ثم يقضيا الحج من عامهما القادم، وتلزم كل واحد منهما فدية، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم، والجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج به، أما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد بذلك وتلزمه شاة توزع في الحرم.
3- ما فديته المِثْلُ أو ما يقوم مقامه:
وهو قتل الصيد، فمن قتل صيد البر المأكول حال إحرامه لزمه واحد من أمور ثلاثة، أولها: المِثْل، وهو أن يذبح الحاج من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، ما يماثل الحيوان الذي صاده، ثانيها: الإطعام، وكيفيته أن يقوّم المثل، ويشترى بقيمته طعاماً يُوزعه على الفقراء والمساكين، لكل مسكين نصف صاع، ثالثها: الصيام، فينظر عدد المساكين الذين يمكن إطعامهم في الحالة الثانية، ويصوم عن كل مسكين يوماً.
4- ما فديته فدية الأذى:
وهو حلق الشعر، وقص الأظافر، وتغطية الرجل رأسه بملاصق، ولبس الرجل ما خيط على هيئة البدن، واستعمال الطيب، وانتقاب المرأة ولبسها القفازين.
فإذا ارتكب المحرم أحد هذه المحظورات التي تسير في مسار مبطلات الحج، فهو مخير بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، وهي المذكورة في قوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ( سورة البقرة 196).
وبقي أن ننبه في مسألة مبطلات الحج إلى أن المحرم إذا كرر فعلاً محظوراً من جنس واحد، وقبل التكفير عنه، كما لو قص أظافره أكثر من مرة مثلاً، ففيه فدية واحدة، أما إن كرر محظوراً من أجناس مختلفة، كما لو قص شعره، وغطى رأسه مثلاً، فعليه فدية لكل واحد منهما، وهذا في غير جزاء الصيد، ففيه كفارة لكل فعل، ولو كان من جنس واحد.
هذه أحكام الفدية المترتبة على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، وأما بالنسبة للفدية المترتبة على ترك الواجب، كترك الإحرام من الميقات، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، وترك المبيت بمزدلفة ومنى، وترك طواف الوداع، ونحو ذلك من واجبات الحج، فالواجب فيه شاة، فإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف، فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع، ومنهم من لم يلزمه بالصوم.
إلا أنه يجب التنبه إلى أن المحرم إذا ترك واجباً من واجبات الحج، فإنه يجب عليه الفدية سواء أكان الترك عمداً أم سهواً، أم جهلاً، لأنه تارك لنسك، بخلاف ما لو ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام التي سبق ذكرها، جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فلا شيء عليه على الصحيح، لقول النبي ﷺ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجة وغيره.
هل يوجد كفارة مبطلات الحج؟
هل هناك فدية جامعة لمن يقع في سلك مبطلات الحج ويرتكب أكثر من محظور في الحج؟ أم لكل محظور فدية؟
يجب أولا أن نعرف أن “كفارات الحج” هي الأمور التي وضعت للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه.
ومجمل القول: من ارتكب أكثر من محظور وهو محرم، فلا يخلو الأمر من حالتين:
الأولى: أن تكون المحظورات من جنس واحد كتكرار لبس المخيط
والثانية: ألا تكون من جنس واحد كمس الطيب مع لبس المخيط ونحوه.. فإن كانت من جنس واحد فلا يخلو الأمر من حالتين أيضاً:
الأولى: أن يتكرر فعل المحظور قبل أن يكفر عن المحظور الأول فهذا يلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.
الثانية: أن يتكرر فعل المحظور بعد التكفير عن المحظور السابق فهذا يلزمه كفارة أخرى وهكذا.
أما إذا لم تكن من جنس واحد فإنه يلزمه كفارة عن كل محظور ولو كان فعل المحظور الآخر بعد التكفير عن المحظور السابق.
5 كفارات بالحج
وهذه 5 كفارات للحج :
- كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا، فهذا من مبطلات الحج وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
- كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.
- كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم.
- كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة أصوُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام.
- كفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني دخل في مبطلات الحج وفسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.
حكم ارتكاب الحاج بعض المعاصي
يسأل الكثير من المقبلين على أداء مناسك الحج والمنتهين منه، عن حكم ارتكاب الحاج بعض المعاصي التي قد ربما تتسبب في كونها من مبطلات الحج، فهل يؤثر ارتكاب بعض المعاصي على الأعمال الطيبة للحاج الذي أدى الحج وهو محافظ على أركان الإسلام؟
الحقيقة أن الحج صحيح في هذه الحالة، ولو كان عند الحاج شيء من المعاصي الحج صحيح، لكن ما يكون مبرورًا إلا إذا كان صاحبه ليس بفاسق، لقوله ﷺ: من حج فلم يرفث، ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه وقال -عليه الصلاة والسلام-: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث، وهو الجماع ودواعيه، ولا فسق المعاصي، فإذا كان حين حج يأتي بعض المعاصي، حجه ناقص، ولكنه يجزئ يبرئ ذمته من الفريضة، لكن يكون حجه ناقصًا، لا يكون مبرورًا.

فإذا كان مثلًا يأكل الربا، أو عنده عقوق لوالديه، أو أحدهما أو قاطعًا للرحم، أو يغتاب الناس، يتعاطى الغيبة، أو ما أشبه ذلك، أو خان في معاملة، أو غش في معاملة، كل هذه معاصي، يكون حجه ناقصًا، ودينه ناقصًا، وإيمانه ناقصًا، ولكن لا يكفر بذلك، ولا يبطل حجه بذلك ما دام على الإسلام والتوحيد، والإيمان بالله ورسوله، هذا الذي عليه أهل الحق من الصحابة، ومن بعدهم، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين استقاموا على دين الله، ووحدوا الله، وأخلصوا له العمل، هؤلاء هم أهل الإسلام، وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى والبر.
فإذا وقع من أحدهم معصية، صار نقصًا في الإيمان، ضعفًا في الإيمان، لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام، وحجه صحيح، وصلاته صحيحة، وصومه صحيح، لكنه يأثم بالمعصية التي تعاطاها، كالغيبة، أو أكل الربا، أو غش في المعاملة، أو أشبه ذلك، يكون نقصًا في إيمانه، نقصًا في صومه، نقصًا في حجه.
فالواجب على المسلم الحذر من مبطلات الحج وتجنب المعاصي في كل أوقاته، خاصة إن كان محرما بحج أو عمرة، لقول لله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة: 197].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. والمعاصي التي يرتكبها الحاج، إما أن تكون من محظورات الإحرام، أو من غيرها من مبطلات الحج، فإن كانت من غير محظورات الإحرام، فالواجب فيها التوبة والاستغفار، ولا يؤثر فعلها على صحة الحج، مع أنها سبب في انتقاص أجره.