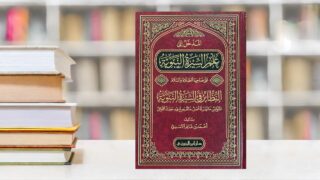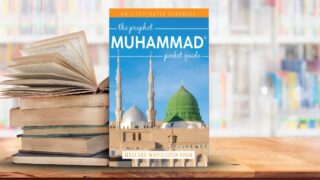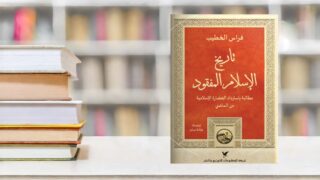أنجبت شبه القارة الهندية عدداً معتبراً من الكتّاب والمفكرين المتميّزين الذين شكّلت كتبهم إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية بفروعها المتعددة، ولعل من أبرز هؤلاء المفكرين المتميّزين الدكتور فضل الرحمن (1919-1988م) الذي يُعدُّ خصماً لثنين من أشهر مفكري وكتّاب هذه القارة؛ هما الباكستانيان: أبو الأعلى المودودي وحسين قريشي اللذين انتقدا فضل الرحمن كثيراً، وعندما رحلا قال خصمهما (فضل الرحمن) إن رحيلهما يمثل خسارة للإسلام[1].
ورغم أن عدد الكتب المؤلفة من طرف كتّاب ومفكري شبه القارة الهندية غير قليلٍ، إلا أن حديثنا في هذه المقالة سيقتصر على كتاب واحد مهم للمفكر فضل الرحمن عنوانه (الإسلام)، يحاول من خلاله أن يقدم صورة عن 14 قرناً من تاريخ الإسلام بمختلف محطاته التاريخية والفكرية والاجتماعية والسياسية في 14 عشر فصلاً يتناول كل فصل قضية معينة بشيء من التفصيل والنقد والتوقّع والاستشراف.
إن كتاب (الإسلام) يمثل مغامرة حقيقية، إذ ليس من السهل الحديث عن تاريخ دينٍ متعددِ الجذور كالإسلام في كتاب واحد، كما أنه ليس من النُّزْهة تلخيص أفكار كتابٍ بهذه الكثافة والشمولية والتوسّع، ولكننا سنحاول في هذه السطور أن نكشف عن جوانب من هذا الكتاب المرجعي في المكتبة الإسلامية عامة ومكتبة فضل الرحمن خاصة.
مصادر الإسلام
بدأ فضل الرحمن كتابه – لدراسة 14 قرناً من تاريخ الإسلام- بثلاثة فصول تتحدث عن تاريخ النبي محمد ﷺ والقرآن الكريم والحديث الشريف، حيث توقف في الفصل الأول مع حياة النبي محمد وما أحاط به من التحولات التاريخية الضخمة، ثم سلط الضوء على علاقة محمد بالوحي القرآني السماوي والمعارضة القوية التي واجهتها دعوته الربانية الخاتمة، كما توقف المؤلف مع استراتيجية النبي الفاعلة التي تمثّلت في كسب ولاء مكة لقضية الإسلام كمرحلة أولى دون إراقة دماء، وانطلاقاً من مكة يبدأ العمل في بقية العالم[2].
وفي الفصل الثاني، نجد المؤلف يتحدث عن المصدر الأول في الإسلام (القرآن)، فيؤكد أن النبي محمد كان على قناعة تامة بأنه يتلقى رسالة إلهية من الله، ثم يتحدث عن التعاليم القرآنية ومركزية الأخلاق في القرآن ودور الإنسان في إنهاء الفوضى الأخلاقية باعتباره خليفة الله في الأرض ويتحمل الأمانة كما جاء في سورتي البقرة والأحزاب، كما تحدث المؤلف عن التشريع القرآني الذي يوضح لنا كيفية المعالجة التشريعية التجريبية البطيئة لبعض المشكلات، مثل تحريم الخمر الذي تم على مراحل، ومعالجة حالة العبودية، ولم ينسَ المؤلف التعريج على التفاسير القرآنية وتأليف المسلمين للشروح النافعة وإنشاء علم التفسير القرآني الذي ظل يتطور عبر العصور.
أما في الفصل الثالث، فينتقل بنا المؤلف إلى المصدر الثاني (الحديث)، فيعرض موقف كبار الباحثين الغربيين المحدثين من علم الحديث وتطوره، مثل: “جولدزيهر” و”مارغوليوث” و”لامنس” و”جوزيف شاخت”، حيث يرون أنه “يكاد لا يوجد أي تشريع للنبي بعد التشريع القرآني”، وهنا يتحدث المؤلف عن العلاقة بين القرآن والحديث، فيؤكد “أن السلطة المرجعية القرآنية -في نظر المسلمين- فوق سلطة النبي نفسه”.
ولم يكتفِ المؤلف بهذا القدر، بل توقف مع المناهضة الكلاسيكية للحديث قبل تطوره وتقنينه، فذكر أن الحديث كان يُرد إلى الصحابي بدلاً من النبي، وكان لفقهاء المدينة حذر شديد من الحديث الآحاد، في حين كان غالبية المعتزلة يشكون في الحديث، الأمر الذي دفع ابن قتيبة (ت: 276 هـ) إلى تأليف كتابه المشهور (تأويل مختلف الحديث) من أجل الرد على اتهامات وشكوك المعتزلة، وفي منتصف القرن الثالث الهجري ظهرت حركة طلب الحديث، “فأخذ الحديث شكلاً جديداً، وعيّن تقريباً مجمل محتواه على نحو مفصل، وأحاط تماماً بكل المجالات”، فأنتجت مجاميع من الأحاديث في نهاية القرن الثالث الهجري، واعتبرت ستة منها سلطة مرجعية في علم الحديث، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
الفقه وعلم الكلام
في الفصول الثلاثة الموالية، توقف فضل الرحمن مالك مع بنية الفقه وعلم الكلام ومفهوم الشريعة، فحدثنا في الفصل الرابع عن تاريخ الفقه وأصوله وأركانه وتطوراته، وحين نتحدث عن الفقه وتاريخه لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الفقه والدولة كانت قائمة منذ العصور الأولى ولا تزال لحد اليوم قائمة، ولكنها كانت تختلف من زمن إلى زمن ومن خليفة إلى خليفة.
ثم إننا لا يمكن أن نُنهي الحديث عن الفقه قبل أن نذكّر بأن الحرية كانت من السمات التي ميّزت الفكر الفقهي في مرحلة مبكرة من تاريخ الإسلام، حيث كانت هناك كمية كبيرة من الآراء الفقهية المختلفة خلال القرنين الهجريين الأولين، ما أدى إلى ظهور مراكز فقهية مختلفة تحولت إلى مدارس فقهية في القرنين الهجريين الثاني والثالث، ومن هنا ظهرت المدرسة الحنفية، والمدرسة المالكية، والمدرسة الشافعية، والمدرسة الحنبلية، والمدرسة الظاهرية[3].
وفي الفصل الخامس، يُعيدنا المؤلف إلى سياق الجدل الكلامي بخصوص مرتكب الكبيرة، فيبدأ حديثه عن علم الكلام بالسؤال التاريخي الجدلي المعروف: “هل يبقى المسلم مسلماً إذا ارتكب الكبائر”؟، ثم بدأ يستعرض تاريخ الفرق الكلامية كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وناقش جملة من المسائل المشهورة المرتبطة بهذه الفرق الكلامية.
أما في الفصل السادس -في كتاب تناول أبرز محطات 14 قرناً من تاريخ الإسلام – فتوقف المؤلف مع مفهوم الشريعة وتطوره ومدى اقترانه بالأخلاق والسلوك الروحي والفكري والجسدي وعلاقته بمفاهيم أخرى كالفقه والعلم والمعرفة القانون، فاتّضح أن الشريعة كانت تعني عند البعض أموراً محددة، ولكنها تشمل عند آخرين كل “الأفعال الباطنية والأفعال الخارجية” كما يقول الشاطبي (ت: 790 هـ)، ولهذا تم تأسيس نظام فقهي عقلاني وأخلاقي وروحي في الإسلام في القرن الثامن الهجري.
بمجرد الانتهاء من مفهوم الشريعة، يدخل المؤلف من خلال الفصل السابع إلى عالم الحركة السلفية، فيبدأ حديثه بالتطور اللاهوتي المدرسي الذي شهده القرن النصف الثاني من القرن الثاني الهجري بسبب الترجمات العربية للأعمال الفلسفية العملية اليونانية، الأمر الذي أدى إلى ظهور حركة فكرية فلسفية علمية قوية “مثيرة للانتباه” ابتداءً من القرن الثالث الهجري حتى القرن السادس الهجري، وقد ركّز فضل الرحمن على تتبّع الأثر القوي التي تركته هذه الحركة على الفكر الإسلامي، فكان لا بد أن يتوقف مع ابن سينا (ت: 428 هـ) والفارابي (ت: 339 هـ) والغزالي (ت: 505 هـ)، ليؤكد أن الفلاسفة المسلمين ابتكروا بعض النظريات الفلسفية، لكنهم أيضاً أخذوا من النظريات المعرفية والميتافيزيقية اليونانية بعض الأفكار مثل فكرة ثنائية العقل والجسم الجذرية.
أما في الفصل الثامن، فسنجد فضل الرحمن يفتتح حديثه عن التصوف بالقول “إن وعي محمد ﷺ، الذي تجسد في رسالته، قام على تجارب صوفية قوية وحيّة في غاية الوضوح، تجارب وصفها أو أشار إليها القرآن”[4]، ويبدو أن التصوف ساهم في تعزيز الخشية من الله (التقوى)، بيد أن هذه التقوى الزهدية واجهت معارضة عاصفة من جهتين، تتمثل الأولى في طبقة المتع الدنيوية المترفة مثل الأمويين، أما الثانية فتتمثل في الخوارج[5].
ومن هنا بقي التصوف خلال القرنين الإسلاميين الأولين ظاهرة فردية حرّة، ولكن مع تطور علم الفقه وعلم الكلام الإسلاميين الرسميين تحول التصوف سريعاً إلى مؤسسة[6]، وهذا التحول سيؤدي إلى توسّع رقعة التصوّف وظهور طرق صوفية جديدة مختلفة، حيث ظهرت حركة المتصوفة السلفيين، ثم ظهرت في القرنين الرابع والخامس الهجريين “عقيدة جديدة على النقيض تماماً من روح الإسلام السلفي”.
إننا عندما نبدأ تصفّح الفصل التاسع، سنواجه حديثاً عن الفرقالصوفية والعلاقة بين التصوف والدين الشعبي، ففي منتصف القرن الثالث الهجري بدأ التصوف يُدرس على نطاق شعبي واسع في مدن عديدة، فظهرت طرق صوفية عديدة يصعب حصرها.
التربية والتعليم
في الفصل الحادي عشر، تناول المؤلف قضية مركزية جداً ألا وهي التربية والتعليم، فحدثنا عن تاريخ المدارس وطبيعة التعليم الإسلامي ومناهجه، حيث أشار إلى أن من أبرز سمات التعليم الإسلامي في الأيام الأولى للإسلام أنه كان يعتمد على الأفراد لا المدارس، ومن اللافت للانتباه أن التعليم الابتدائي في السابق كان يشكل وحدة قائمة بذاتها ولم يكن هناك ارتباط عضوي بينه وبين التعليم العالي، ومن هنا “فإن النظر إلى التعليم الابتدائي على أنه القاعدة الأساسية للتعليم العالي ظاهرة حديثة”[7].
وقد توقف المؤلف مع نشأة المدارس العامة والخاصة، فذكر أنها أنشئت من جهود فردية ومن تبرعات لهيئات إسلامية خاصة، حيث أسّس أبو حاتم البُستي (ت: 277 هـ) مدرسة في مسقط رأسه مع مكتبةٍ وقسمٍ للسكن للتلاميذ، كما أسّس الفاطميون عام (361 هـ) جامعة الأزهر في القاهرة، ولا يمكن أن ننسى جامعة الزيتونة بتونس ومعهد ديوباند في الهند.
ويبدو أن مناهج التعليم كانت تسيطر عليها موضوعات دينية محضة كالحديث والفقه وعلم الكلام والتفسير بالإضافة إلى الأدب والنحو، ولكن في القرن الثاني عشر الهجري قام مولى نظام الدين بوضع المناهج الدراسية في الهند، وعرف هذا المنهج باسم “دارسي نظامي”، ثم ظهرت مناهج دراسية مماثلة في بلاد فارس وآسيا الوسطى، منها منهج شاه ولي الله (ت: 1174 هـ) الذي كان يتضمن الرياضيات وعلم الكون والطب، وقد حاول المؤلف أن يقدم وجهة نظر حول دور التعليم في الإصلاح الإسلامي الشامل، فأكد “أن أي إصلاح إسلامي اليوم لا بد أن يبدأ بالتعليم”.
الحركات الإصلاحية
في القرن الثاني عشر الهجري انتشر الفساد الديني والتراخي الأخلاقي والتفسخ في المجتمع الإسلامي وولايات الإمبراطورية العثمانية وفي الهند، فكان لا بد من ردود فعل تجاه هذا الأمر الشنيع وهو ما حصل بالفعل، فظهرت حركات الإصلاح في عدة أنحاء من العالم، وقد خصص فضل الرحمن الفصل الثاني عشر لتقديم صورة عن هذه الحركات الإصلاحية المتعددة.
إذا بدأنا بالجزيرة العربية، سنجد أنها شهدت ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب (ت: 1206 هـ) باعتبارها ردة فعل على الانحطاط الأخلاقي الذي سمحت الأمة لنفسها أن تسقط فيه تدريجياً على مرّ القرون التي أصبح فيها التصوف الشعبي هو العامل المهيمن [8]، وقد شهد القرن الثامن عشر أيضاً إحياءً لاتجاه سلفي عقلي مثّله العالمان اليمنيان: محمد المرتضى (ت: 1204 هـ) ومحمد بن علي الشوكاني (ت: 1250 هـ).
ويبدو أن القارة الهندية لم تكن بمعزل عن حركات الإصلاح، فقد ظهر في الهند دين يُدعَى “الدين الإلهي” لكنه مات في المهد بسبب رفض الهندوس والمسلمين له على السواء، وفي القرن الثاني عشر الهجري بدأ المسلمون في الهند يكتشفون الحاجة إلى توجّه جديد في إعادة تفسير الإسلام عبّر عن نفسه من خلال أعمال شاه ولي الله الدهلوي (ت: 1176 هـ).
وعندما نريد الحديث عن الحركات الإصلاحية في القارة الإفريقية، لا ينبغي أن نتجاوز الحركة السنوسية، وحركات الجهاد الفُلَّانية والمهدية التي ظهرت في نيجيريا والسودان (مثلا) خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري[9]، وحركة ناصر الدين، وحركة الإمام عبد القادر.
التطورات الحديثة
في الفصل الثالث عشر، حاول المؤلف أن يقدم صورة عن التطورات الحديثة في الإسلام، حيث تحدث عن “الحداثة العقلية” ممثلة في جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسيد أحمد خان ومحمد إقبال، كما تحدث عن “الحداثة السياسية” ممثلة في جمال الدين الأفغاني وضياء جوك ألب التركي، ولم ينسَ فضل الرحمن أن يسلط الضوء على العلاقة بين الحداثة والمجتمع.
أما في الفصل الرابع عشر والأخير من – كتاب يدرس 14 قرناً من تاريخ الإسلام – فتوقف المؤلف مع “التراث والمنظورات المستقبلية”، فتحدث عن: “الدين والتاريخ”، و”العقيدة السياسية”، و”الأصول الأخلاقية”، و”المثل الروحية”، و”الحاضر والمستقبل”، ولعل من أبرز الأفكار التي ختم بها أن “مهمة إعادة النظر في الإسلام وصياغته في الوقت الراهن هي مهمة أكثر دقة وجذرية من تلك التي واجهت المسلمين منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، والإنجاز المطلوب تحقيقه يساوي إنجاز القرنين والنصف الأولين”[10].
وقبل أن نطوي صفحة هذا العرض، لا بد من التأكيد على أن كتاب (الإسلام) يمثل مغامرة شجاعة بحق، تسمح لنا القول إن صاحبه لم يستطع أن يغطّي كل أحداث وتطورات 14 قرناً من تاريخ الإسلام بشكل شامل (100 %)، ولكنه نجح في تقديم صورة شبه شاملة عن هذه القرون الطويلة، ولهذا يَبقَى من الصعب استعراض كل الأفكار المنثورة بين دفتي هذا الكتاب المهم في بابه، نظراً لكثافته وتعدد أفكاره وأطروحاته.
[1] انظر، فضل الرحمن، الإسلام وضرورة التحديث، 7.
[2] فضل الرحمن، الإسلام، 65.
[3] انظر، نفسه، 149-151.
[4] نفسه، 213.
[5] انظر، نفسه، 214-215.
[6] نفسه، 219.
[7] نفسه، 286.
[8] نفسه، 311.
[9] انظر، نفسه، 323-325.
[10] نفسه، 382.
تنزيل PDF