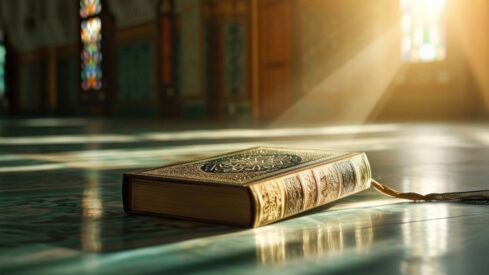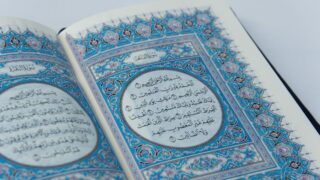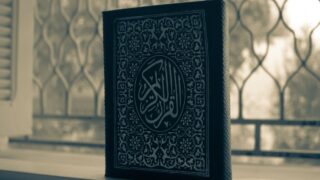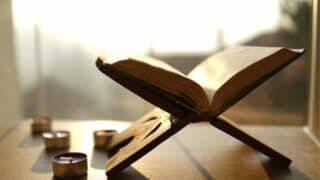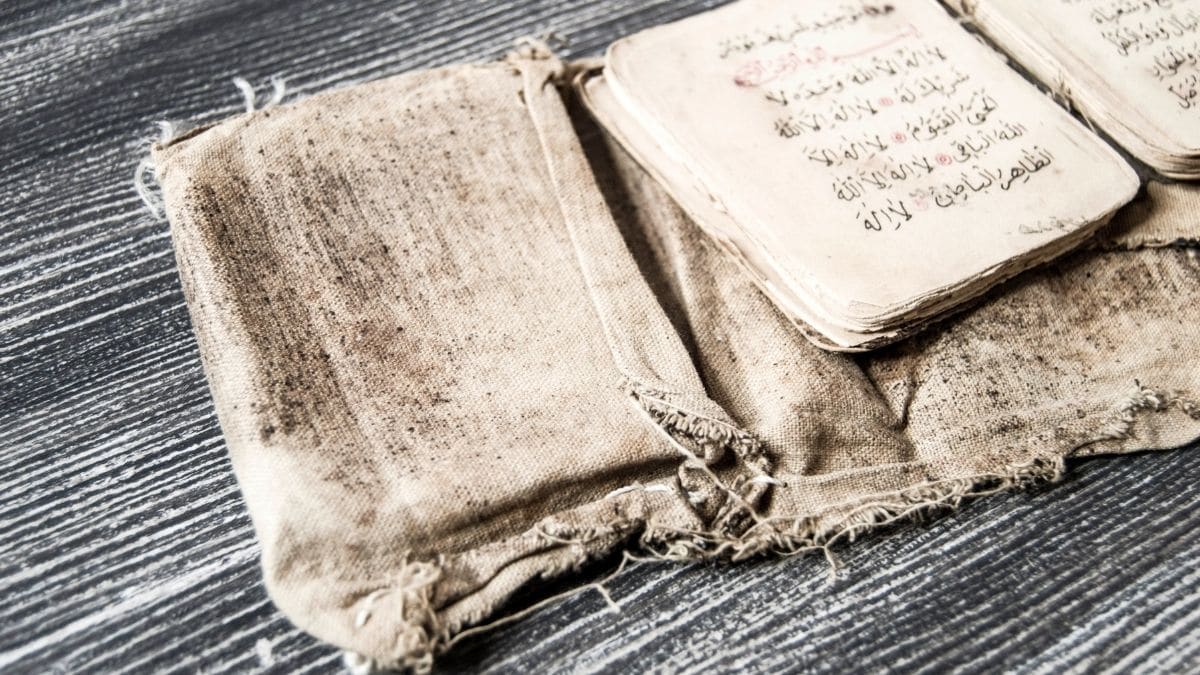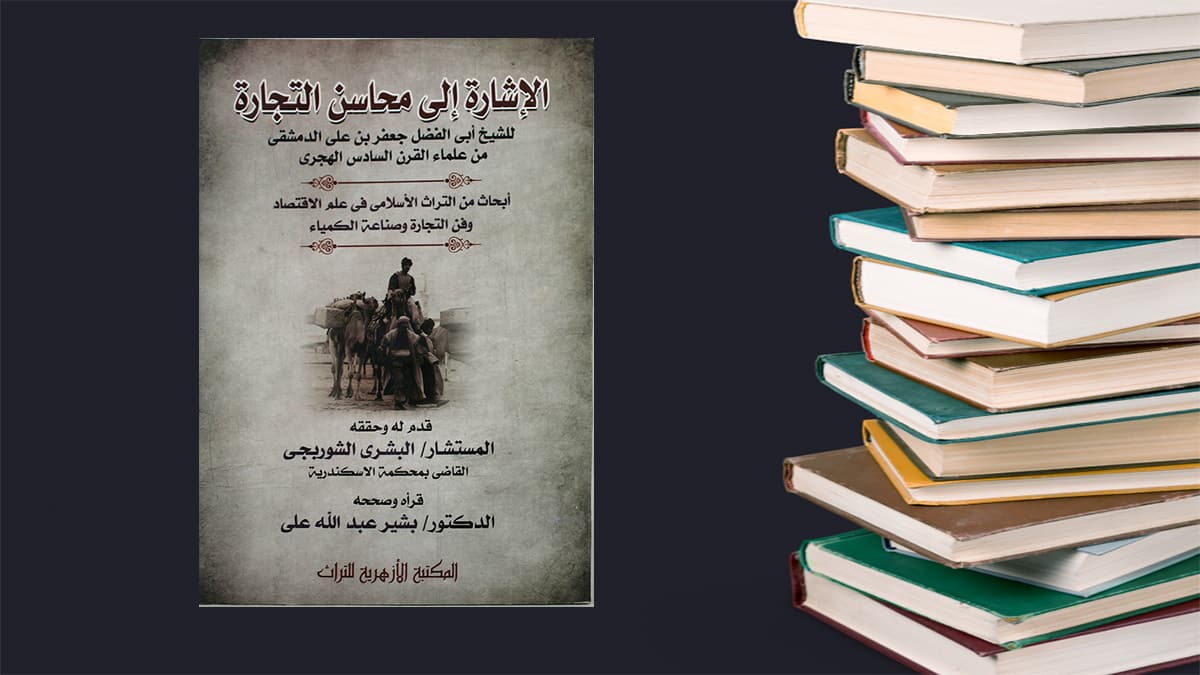سورة ص من السور المكية التي تعالج قضية الدعوة، وصراع النبي ﷺ مع الكذبين، ومعاناته معهم رغم وضوح البينات التي جاء بها، وتهافت الاعتراضات التي يقدمونها.
والسورة تتلخص في مقدمة موجزة، واستعراض في ثلاث محاور: تناول الأول تاريخ الأمم مع الرسل، وتاريخ الرسل مع ابتلاءات الحياة المختلفة، وتناول المحور الثاني مآل المصدقين والمكذبين من أصحاب الدعوات، وتناول الثالث قصة بدء الخلق واستكبار إبليس عن السجود، وخاتمة للسورة تبين بعض الحقائق المهمة.
تفسير سورة ص: مقدمة ومحاور السورة الرئيسية
بدأت السورة، ككثير من السور القرآنية، بالحروف المقطعة، التي لم يرد في معناها دليل شافٍ مجمع عليه. ولكن الواضح أن القرآن يقول إن هذا القرآن، المكوَّن من هذه الحروف التي تعرفونها، يتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 23–24]، ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]، وما دمتم عاجزين عن ذلك، وقد حُكم عليكم بالعجز في الآتي والمستقبل، فاذعنوا لحكمه، وصدقوا بخبره، وامتثلوا أمره.
وقد لخّص القرآن الكريم قصة الدعوة النبوية في هذا الطور من أطوارها في جملتين:
﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص: 1–2]
وهذا التقديم الموجز المختصر يُلخص كل ما في الأمر:
- القرآن كتاب الذكرى:
﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 90]
﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: 31]
- كتاب التذكير
﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [ص: 87]
﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: 44]
﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: 10]
فلا يعرض عنه إلا من اعتزَّ بما عنده، وشاقَّ الله ورسوله، وهي صفة المعرضين عن دعوة الرسل في كل زمان ومكان: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: 14]
وأمام هذا التقديم الموجز غاية الإيجاز المختصر غاية الاختصار كان من المناسب الرجوع لتاريخ المكذبين والمعارضين للنبوات، وتاريخ ما عاناه الأنبياء في سبيل توطين الدعوة وتبليغ الدين للناس، مع المكذبين أو مع الابتلاءات المختلفة التي يتعرضون لها.
وهذا ما اتجه جمهور السورة لبيانه:
المحور الأول: تاريخ الأمم مع الرسل وصور من ابتلاءات الأنبياء
في هذا المحور يستعرض القرآن بعض مآلات المكذبين بإيجاز؛ لأنها ذكرت في سور أخرى سابقة على هذه في النزول. كما يذكر بعض الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء، فيفصل بعضها تفصيلا لم يرد في غير هذه السورة، ويجمل بعضها؛ لأنه ذكر في غيرها، ويشير إلى بعضها إشارات دون أي تفصيل.
أولا: مصارع المكذبين السابقين
يتحدث القرآن أن هؤلاء ليسوا أول من كذب، ولا أول من دفع ضريبة التكذيب وهي الهلاك الذي لا مرد له ولا معقب له، ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: 3] .
وهذا يؤكد:
- خطورة استعجال العذاب؛ إذ لن يكون العذاب اختبارا، ولن يرجع بعد أن يحدق؛ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: 83-85]
- فكما أهلك أولئك على هؤلاء أن يحذروا، فسنن الله ماضية لا تحابي أحدا.
من أسباب تكذيب الرسل
وليس لهذا التكذيب المسبب للهلاك سبب سوى التعجب والاستغراب من إرسال بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذا التعجب وما ينشأ عنه من التكذيب دليل على الجهل بالله، وعلى إرادة التحكم في اصطفائه واختياره. فلا جواب لذلك التساؤل الغبي: ﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ [ص: 8]، إلا قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75]
ولا فائدة في الاعتراض، ولا في الاقتراح؛ فجواب الاعتراض: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: 31-32]
والجواب المسكت عن كل اعتراض وكل اقتراح: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: 90-93].
وجواب السورة نفسها على هذا التساؤل: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ [ص: 9-11]
ولذلك فهذا التساؤل غبي أو متغاب ينسجم في سياق واحد مع التساؤل الغبي الآخر من هؤلاء الذين يصنعون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها، ثم يُنكِرون دعوة التوحيد: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: 5]، والعجيب حقا هو عبادتهم لما يصنعون، وادعاؤهم فيه الألوهية كذبا وخذلانا.
ويبقى الإصرار على الباطل، رغم وضوح البينات، السمة البارزة لقادة المجتمع الجاهلي، والمكابرة رغم وضوح الحق العلامة المميزة لهم: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴾ [ص: 6-7]، فهم يكذبون من لم يأثروا عليه كذبا، ويدّعون أن الملة الآخرة لم يُذكَر فيها التوحيد، ولم تخل منه ملة لا قديمة ولا حديثة، بل البشر مفطورون عليه، ومنهم هؤلاء أنفسهم: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 67].
إذن فلا حل للمكذبين، ولن يصدقوا حتى يروا العذاب الأليم؛ لأن هذه سنة الله في المكذبين ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) ﴾ [ص: 12-15]
وليس هؤلاء ببعيدين عن منهج الهالكين قبلهم، فقد سألوا الله تعجيل العذاب: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [ص: 16]، وقالوا: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: 32]، فكيف التعامل مع هؤلاء؟ لا تعامل معهم إلا بالصبر على أذاهم، والتحمل حتى يفتح الله، ويحكم الله، والتسلي بقصص السابقين، وسنن الله مع المؤمنين والمكذبين.
ثانيا: صور من ابتلاءات الأنبياء
ذكر الله في هذا المحور صورتين مزدوجتين من الابتلاء بالخير والشر في نبيين من أنبياء الله تعالى، هما داوود وسليمان عليهما السلام.
قصة داود عليه السلام
تتميز قصة داود في هذه السورة بأن عناصرها الأهم لم تذكر في أي سورة من القرآن غير هذه، فداود عبدٌ عابد، آتاه الله الملك والحكمة، وعلّمه مما يشاء، ثم ابتلاه كما يبتلي أولياءه، فابتلاه بأنواع من ابتلاءات الخير، منها:
﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: 18-20].
وأمام هذه الابتلاءات الخيرية، والدنيا دار ابتلاء لا بد من ابتلاء غير حلو، فكان الابتلاء المر، الذي خص القرآن هذه السورة بذكره: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 21-24].
ويتلخص الأمر في دخول خصمين على داود في وقت لم يأذن فيه لداخل، وكأنهما تسوّرا عليه، ففزع منهما، فطرح عليه أحدهما المشكلة، فتكلم داود بالحكم، وقدم النصيحة، قبل أن يسمع من الثاني فعاتبه الله على ذلك، فارتبع الخصمان، فعلم داود أنهما ملكان جاء يختبرانه، فتاب إلى الله وأناب فغفر له الغفار ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: 24-26]([1]).
وفي قصة داود عليه السلام من العبر:
- ضرورة التأني في الأمور وعدم العجلة في إصدار الأحكام
- التنبه للابتلاء وصوره غير المعهودة
- الاستغفار عند الخطأ والرجوع إلى الله تعالى.
- ضرورة اقتداء المؤمنين بالأنبياء في تعجيل التوبة والبعد عن الإصرار.
- أن الصلاة سبب للمغفرة، وقد قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45].
قصة سليمان عليه السلام
وبين قصة داود عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام، يفصل القرآن بالحديث عن موضوع السورة الأساسي، وهو ما يتعلق بالنبي ﷺ وبالقرآن الكريم، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 27-29].
وهذا التنبيه العظيم من الله جل جلاله لعباده إلى تدبر القرآنمن أعظم التنبيهات التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، ومن التزمها أفلح ونجح.
وفصل القصة بهذا الموضع ربطٌ بين القصص وموضوع السورة، وتنبيه على أن المقصود من القصص هو العبرة، لا التوثيق التاريخي. وهذا شأن قصص القرآن كلها، تأتي لعبر وعظات، ليست للتسلي، ولا لتوثيق كل الأحداث؛ لذلك كانت سمتها الغالبة الإجمال، وتفصل في كل موضع بحسب سياقه، والمعاني التي سيقت القصة من أجلها.
وليتم الله النعمة على داود يذكر أنه امتن عليه بسليمان عليهما السلام ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 30]، ورغم أن داود عليه السلام له أبناء كثر فإن منة الله بسليمان تختلف عن منة الله تعالى بأي منهم؛ إذ سليمان هو النبي الوريث الحقيقي للنبوة والملك، والأنبياء لا يورثون ما تركوا صدقة([2]).
لذلك بدأ الله قصة سليمان والمنن عليه بوصلها بمنة الله على أبيه داود زيادة في المنة وربطا للقصص بعضها ببعض.
فمنة الله على سليمان كانت امتدادا لمنن الله على أبيه، وكان من الشاكرين للنعم المستشعرين لها، حتى قال الله عنه: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: 16].
وتتكون قصة سليمان في سورة “ص” من جزئيتين:
الأولى: فتنة الخيل
اشتغل بطاعة عن طاعة، فندم على ذلك، فصرف ما شغله عن طاعة الله، حتى لا يُشغله مرة أخرى:﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: 31-34]
وأمام عرض الصافنات الجياد اشتغل النبي الكريم عن الصلاة حتى جاء الليل فذبح الخيل وأهداها في سبيل الله فعوضه الله الريح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه([3])، وكان من سنن الصالحين أن من شغله شيء عن الطاعة تخلص منه لله، فهذا رسول الله ﷺ حين شغلته حلة عن صلاته أهداها([4])، وحين شغله رداء عن الصلاة أمر به فأزيل([5]) أو شقق مخدات([6])، وهذا أبو طلحة حين شغله حائطه عن صلاته أهداه([7])، فتلك سنة الصالحين.
الثانية: فتنة الجسد الملقى
وقد وردت فيها روايات كثيرة لا يليق التطويل بها، وقد صح عن النبي ﷺ أن سليمان نذر أن يطأ نساءه وهن مائة، فتلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله ولم يعلق على المشيئة، فلم تلد واحدة منهن إلا نصف إنسان، فكان في ذلك تنبيه له على ضرورة تعليق الأمرمرأمر بالمشيئة([8]).
ورغم أن الحديث لم يرد فيه ربط بينه وبين الآية، فإنه أولى من قصة الجني([9])؛ إذ مبناها على تعلق ملك سليمان بالخاتم، وانسلابه منه حين يفقد الخاتم، وهذا لا يخلو من لوثة وثنية وسحر، ولعل منشأه اتهام اليهود لسليمان بالسحر وقد قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: 102] ، فينبغي للمسلم أن يجل مقام الأنبياء، وأن يربأ بهم عن كل لوثة تجر إلى ما لا يحمد، مع التزام المنهج الشرعي القاضي بالتوقف في التعامل مع مرويات أهل الكتاب التي لا دليل على تصديقها أو تكذيبها، حتى لا يُصَدَّق باطلٌ أو يُكذَّب حق([10]).
وعلى كل فإن القرآن صرح أن الله فتن سليمان، والفتنة تكون بالخير والشر ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35]، وفتنة سليمان كان فيها متحققا بالعبودية، فاستغفر ربه، وسأله ما لم يعط أحد من الآتين بعده من الملك والخير، فحقق الله رجاءه وأجاب دعاءه، وأعطاه مسألته، وامتن عليه بالمنة العجيبة، النافعة في الدنيا والآخرة ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 39-40].
وفي هذه القصة من العبر:
- ضررورة التعلق بالله في كل حال، واستشعار العبودية في كل موقف
- أن الملك لا ينافي الخيرية إن كان على منهج سليمان، وينافيها إن كان على منهج قارون
- أن العبرة في النعم التي يُنعم الله بها على الإنسان إنما تكون بما يفعله بها من عمل صالح، لا في ذات النعمة نفسها؛ إذ إن الابتلاء بالخير يقع لكل من البر والفاجر ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾﴾ [الزخرف: 33-35].
- من الضروري تقييد العزائم والالتزامات المستقبلية بالمشيئة الإلهية، تبركًا بها، واعترافًا بالافتقار إلى توفيق الله، واستعانةً به على إنجاز الأمور، كما أرشدنا الله تعالى في قوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24].
قصة أيوب عليه السلام
ومن جملة الأصفياء الأخيار الذين ابتُلوا فصبروا، نبي الله أيوب عليه السلام، فقد ابتُلي في جسده بالمرض، وفَقَد ماله وأهله، ومع ذلك ظل صابرًا محتسبًا، متحققًا بكمال العبودية، كما أثنى الله تعالى عليه بقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 44].
وكان من شأنه أن امرأته لما طال عليه البلاء وسوس لها الشيطان، فجاءت بما يكره فأقسم أن يجلدها مائة جلدة تأديبا لها على اتباع وساوس الشيطان، وهي امرأة نبي في فتنتها فتنة أمة، فلما دعا الله شفاه الله، وأعطاه من فضله وزاده فوق ما كان عنده، وأرشده إلى البر بيمينه.
وفي هذه القصة تتجلّى عظمة اليمين وخطورتها؛ إذ إن هذا النبي الكريم، أيوب عليه السلام، أُرشد إلى الوفاء بيمينه بطريقةٍ لا يُفضي فيها إلى إيذاء امرأته، تخفيفًا من الله ورحمةً بهما، كما قال تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: 44].
فأخذ الضِّغث، وهو حزمة من العيدان يبلغ مجموعها مائة، فضرب بها امرأته ضربة واحدة، فبرّ بيمينه ولم يحنث. ولم يأتِ توجيه القرآن بإهمال هذا اليمين، بل أرشده إلى الوفاء بها بطريقة لا تؤدي إلى الأذى، وفي ذلك دلالةٌ على عِظَم شأن اليمين وشدّتها.
وفي قصة أيوب من العبر:
- أن النبي يبتلى وقد يطول به البلاء حتى يرى الله فيه العبودية والصبر والرضا.
- أن الابتلاءات — وإن بدت في ظاهرها شرًّا — هي خير للمؤمن في جميع أحواله، “عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له”([11]).
وفي قصص هؤلاء الأنبياء إشارة إلى الابتلاء والتعامل معه، وإلى لزوم الأنبياء للاستغفار، وصبرهم على الأحوال، وفي ذلك تسلية للنبي ﷺ وإرشاد لكل مؤمن سالك طريق الأنبياء أنها محفوفة بما يقتضي الصبر والتحمل، والاستغفار والتصحيح دوما.
قصص مجملة لبعض الأنبياء
ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يذكّر بقصص جماعة من أنبيائه الكرام ﴿وَٱذْكُرْ عِبَادَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٖ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلّٞ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾﴾ [ص: 45-48].
كل أولئك الأنبياء كانوا من المصطفين الأخيار، وفي اصطفائهم حُجّة على قريش، تُبيِّن أن اصطفاء النبي محمد ﷺ ليس أمرًا بدعًا، بل هو امتداد لسنّة الله في أنبيائه وعباده المصطفين. وقد أبقى الله لهم في الدنيا ذكرًا جميلًا، وفي ذلك بشارة للنبي ﷺ بأن له مثل ما لأولئك من الثناء الحسن، رغم ما يصفه به المشركون من الجنون والسحر والكهانة، كما هو شأن كل أمة تُبتلى برسول من عند الله، قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْاْ بِهِۦ ۚ ﴾ [الذاريات: 52-53].
فالعاقبة الحَسَنة والذِّكر الطيب في الدنيا، دليل على أن العاقبة للمتقين، وأن كيد الكافرين لا يضرُّ أنبياء الله شيئًا. وإذا انضم إلى ذلك ما أعدَّه الله لهم من الجزاء في الآخرة، كان ذلك أتمَّ للفضل وأعظم للأجر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمۡ عِندَنَا لَمِنَ ٱلۡمُصْطَفَيْنَ ٱلۡأَخْيَارِ﴾ [ص: 47].
فقد اجتمع لهم الثناء الحسن في الدنيا، والجزاء العظيم في الآخرة، كما اجتمع ذلك لداود وسليمان وأيوب عليهم السلام، الذين فُصِّلت قصصهم في هذه السورة بعض التفصيل، ليكونوا عبرة للنبي ﷺ وأمته، وتسلية له في وجه الإعراض والاستهزاء
المحور الثاني: نتائج الابتلاءات والامتحانات
تقدم في القصص التفصيلية أن الأنبياء يبتلون فتكون لهم العاقبة، وأجمل هنا ذلك، وأشير إلى أصل الموضوع وهو القرآن وما فيه من الذكرى فقال تعالى: ﴿هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 49]. فكما افتتحت السورة بأن هذا القرآن ذو ذكر أكدت هنا بعد القصص الخادمة لموضوعها أن هذا ذكر، وأن العاقبة للمتقين، ثم بدأت بتفصيل مآل المتقين، فذكرت منه المجمل والمفصل:
فالمجمل: ﴿هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 49]
والمفصل: ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ﴾ [ص: 50-54] .
وفي مقابل هذا النعيم لا شك أن النفوس تسأل عن جزاء القسم الآخر، فالصراع بين طرفين، وتيارين واتجاهين وفريقين، لذلك كان الجواب سريعا: ﴿وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ﴿٥٨﴾ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ﴾ [ص: 55-61].
وشتان ما بين الجنة ونعيمها،ـ والنار وعذابها! وشتان ما بين صورة المكرمين يتقلبون في النعيم، وينوعون في الفواكه والمشتهيات، تدور عليهم الكأس، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، مع نعيم لا ينقطع، وكرامة لا تنتهي…
شتان بين هذه الصورة وبين صورة أهل النار المجملة والمفصلة؛
فالمجملة: ﴿وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ [ص: 55]، ﴿وَآخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ﴾ [ص: 58]
والمفصلة: شراب من حميم يتجرّعه المعذّب فلا يكاد يسيغه، ويشربه اضطرارًا فتتقطّع أمعاؤه، وغُسالةٌ خبيثةٌ كريهة الرائحة، وعداوة منكّدة، وصحبة سيئة، وتلاوم دائم.
ويزداد عذاب أهل النار شدة وقسوة، ويزدادون حسرة وندامة حين يدركون أن من كان يسخرون منهم في الدنيا لم يذوقوا طعم هذا العذاب، ولم يقربهم حسيس تلك النار، فيصرخون في استفهام استنكاري ينبئ عن حسرة وندم وشقوة وخسارة: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَٰهُمۡ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ [ص: 62-63]
وهي أسئلة يجيب عنها الزمان والمكان والحال، دون حاجة إلى جوابٍ لفظي، فأولئك نجوا ولم يدخلوا النار، واحتسابكم لهم من الأشرار لم يجعلهم كذلك، واتخاذكم لهم سخريا إنما هو سخرية من أنفسكم، ولذلك يتولى القرآن الإجابة عنهم: إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٞ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمۡ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴾ [المؤمنون: 109-111]
بل قد يكرم أحدهم بالسخرية من الكافر في النار فيقول لإخوانه في الجنة: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الصافات: 51-60]
بل ويجمل الصورتين المتقابلتين في الدنيا والآخرة في تصوير واحد في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المطففين: 34-36].
وأمام مشاهد القيام هذه والمآلات الحتمية، يرجع السياق القرآني إلى من هم في عزّة وشقاق، فينبّههم إلى ضرورة المراجعة، ويقدّم لهم بعض الأدلة الدامغة على نبوّة هذا الرجل الكريم ﷺ، فيقول: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭۚ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٞۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌۭ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۢ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ﴿٧٠﴾﴾ [ص: 64-70]
فهذا الغيب الآتي الذي أُحدثكم عنه، لا أعلمه لو لم يُوحَ إليّ به، وغاية ما أريد منه هو ردّكم إلى الإيمان بالإله الواحد، لا شريك له، الذي تعترفون بأنه لا شريك له في الخلق، ثم تعبدون معه، أو من دونه، بعض خلقه!
ويُنَبَّه النبي ﷺ إلى ما أُجمل من قبل في قضية القرآن وعظيمته، وأنه النبأ العظيم والخبر اليقين، فالإعراض عنه بالضرورة عظيم.
ويصل السياق القرآني خبر الماضي بخبر المستقبل؛ لأن ذلك بالنسبة لمنزل القرآن سواء؛ فالزمن يجري على الناس، والله خالق الزمن، يستوي عنده ما كان وانتهى، وما سيكون ولما يأت، وما هو كائن الآن؛ كل ذلك تحت قدرته ومشيئته، واقع بإرادته وعلمه وحكمته جلّ جلاله.
المحور الثالث: قصة بدء الخلق واستكبار إبليس
وأمام هذا الوصل بين الآتي والماضي، تأتي قصة بدء الخلق لتنبه هؤلاء المتكبرين إلى:
- أن هؤلاء المكذبين ليسوا أول من تكبّر.
- وأن استعجالهم للعذاب لن يغير من قدر الله شيئًا، ولن يأتي العذاب إلا في الوقت المحدد؛ فقد عصى الشيطان، ولم يُعاجله الله بالعقوبة، بل استجاب له طلب الإمهال، ولن ينفعه الإمهال، لأنه صائر إلى الله، وهو معاقب على فعله، لا تنفعه توبة.
قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌۭ بَشَرًۭا مِّن طِينٍۢ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [ص: 71–85]
وفي هذا الحديث:
- دلالة على صدق النبي ﷺ؛ فما كان يعلم شيئًا من أخبار السابقين، فضلًا عن أخبار الملأ الأعلى، لولا تعليم الله تعالى، وهو ﷺ أُمِّيٌّ لم يكن يتلو من كتاب، ولم يخطّه بيمينه، حتى لا يرتاب فيه المبطلون.
- دلالة على قِدم الاستكبار، وعلى عِظَم حِلم الله وتأخيره العذاب إلى الوقت الذي يقدّره هو سبحانه.
- أن لا سلطة للشيطان على من أخلصهم الله تعالى، وفي صدارتهم الأنبياء، ثم أتباعهم، ولا نجاة منه إلا بالتخليص الإلهي، ومن علامات تخليص الله للعبد إخلاصُه العبادة لله، وهو ما يدعو إليه النبي ﷺ والأنبياء من قبله.
- وفيه تلطف بالمدعوين حتى لا يتبعوا خطوات الشيطان، فيحق عليهم ما حُق عليه من الطرد والعذاب.
خاتمة السورة
تؤكد خاتمة سورة “ص” القضية التي ابتدأت بها، وهي علاقة الداعي بالمدعوين، ومآل الدعوات:
- ففي علاقة الداعي بالمدعوين: قال تعالى: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [ص: 86]، فكيف تستثقلون دعوة أنتم وحدكم المستفيدون منها، وأنا مجرد مُبلِّغ، لم أُكَلِّفكم عليها لا مالًا ولا جاهًا؟
- وفي قضية القرآن: قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [ص: 87]، فالذكرى تنفع من كُتب له الانتفاع بها، فليختر الإنسان لنفسه أين يكون. وهذا تأكيد لما جاء في صدر السورة: ﴿ص وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ﴾ [ص: 1].
- وفي مآل الدعوة: قال تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: 88]، فقد عرفتم سنة الله في الأولين: أن الأمم المكذبة تُهلك، والأنبياء يُبتَلون ثم تكون لهم العاقبة([12]). وسترون هذه السنة ذاتها تتحقق في هذا القرآن، مع المصدقين والمكذبين.
وفي هذه الخاتمة بشارة للنبي ﷺ بالتمكين لدينه، ونجاح دعوته، وهو ما حققه الله له، حتى أصبحت مكة – التي كانت مركزًا للكفر – صدرَ أرض الإسلام، يحيطها المسلمون من كل جانب. والحمد لله رب العالمين.
وختاما
فقد اشتملت سورة “ص” على أساليب دعوية عظيمة، وقصص معبّرة، ومعانٍ كثيرة يصعب حصرها، نُوجز منها ما يلي:
- نبَّهت السورة إلى خطورة الاستكبار والصد عن سبيل الله، وأمن مكر الله.
- نبَّهت إلى مآل المكذبين الخاسر لا محالة، وندمهم الدائم أبد الآبدين.
- نبَّهت إلى ضرورة الصبر على الابتلاء أياً كان، وإلى ضرورة شكر النعمة وصرفها في الطاعة.
- نبَّهت إلى أن صداقة الكافرين مؤقتة تعقبها عداوة جوارٍ دائمة في نار جهنم، بينما المؤمنون إخوة في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة منزوع الغل منهم، فلينزعوه من أنفسهم في الدنيا.
- نبَّهت إلى ضرورة تدبّر القرآن والتفهم فيه والتبصر به، فما لم يقع ذلك، فلن نفهم القرآن، وما لم نفهمه، فلا يُتوقَّع أن نعمل به.
- ردّت على شبه المكذبين بأساليب بديعة، وطرق رائعة تجمع بين الإجمال والتفصيل، وتستخدم وسائل متعددة لتأكيد المعنى المقصود.
- تميّزت بتفاصيل في بعض القصص لم تذكر في غيرها من السور، وأشارت في ثناياها إلى ضرورة التزام العبودية، والمسارعة إلى الاستغفار كلما وقع تقصير أو خطأ.
وهذه وقفات سريعة، ويبقى القرآن بحرًا لا ساحل له، نسأل الله أن ينفعنا به، وأن يجعلنا من أهل التدبر والعمل.وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه، وسلّم تسليمًا كثيرًا.
والحمد لله رب العالمين.