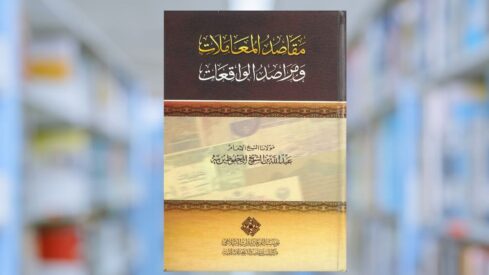تطرق كتاب مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات لمؤلفه الشيخ عبدالله بن بيه لـ موضوع المال بين الملكية والوظيفة.
تعريف المال في الاصطلاح: اختلف في تعريفه فعرفه الأحناف بتعريفات عدة قال ابن عابدين: المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم[1].
وعرفه المالكية بتعريفات مختلفة، كذلك فقد عرَّفه الشاطبي بقوله: هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. وقال ابن العربي: هو ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع به.
وقال عبدالوهاب البغدادي: هو ما يتموّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه.[2]
وعرف الزركشي من الشافعية المال بأنه ما كان منتفعاً به أي مستعداً لأن ينتفع به.[3] وحكى السيوطي عن الشافعي أنه قال: لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلّت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك.
وقال الحنابلة المال شرعاً ما يباح نفعه مطلقاً أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجة[4]
قلت: إلا أن هناك “الأيلولة” أي اعتبار مالية ما يئول إلى المال في جواز الاعتياض عنه.
ولقد أشار إليها المالكية في باب الشهادات باعتبار أنما يئول إلى المال بوجه من الوجوه كالمال في نصاب الشهود ومثلوا لذلك بجرح الخطإ والشفعة والجراح التي لا قصاص فيها “ولما ليس بمال ولا آئل إليه” كما قال خليل.
ولكنهم كانوا أصرح في اعتبار بعض الحقوق قابلة للعوض كتنازل الضرة عن نوبتها بعوض كما سنرى في آخر هذه المقدمة.
ولهذا فإنَّ مجال المالية يمكن أنْ يوسع بنظرة مقاصدية تعتمد مذهب مالك ويمكن أن تحل الإشكالات في العقود الحديثة لتجيز الاعتياض عن فعل أو امتناع عن فعل لصالح جهة ما إذا ثبت أصل الحق بوجه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ربا.
إن العلاقة بين الإنسان وبين المال هي نسبة الملك القائم على الاحتواء والقدرة على الاستبداد به. أما ملك الناس فهو كما يقول الراغب التصرف بالأمر والنهي في الجمهور، هذا في مصدر ملَك وهو مثلث إلا أن المِلك بالكسر فهو فعل بمعنى مفعول كنقض ونكث للمنقوض والمنكوث.
للتملك أسباب
وللتملك أسباب أربعة كالتالي:
1- الاستيلاء على شيء لا ملك لأحد عليه من حيوان ومن صيد أو شجر أو أرض فيما يسمى بإحياء الموات “من أحيا أرض ميتة فهي له”. كما جاء في الحديث. وقد صنف الفقهاء فيه ووضعوا له حدودا حتى لا يبغي أحد على أحد وليس هذا من غرضنا.
2- انتقال الأموال عن طريق التبرعات من هبة أو صدقة أو وقف أو عارية أو قرض أو عن طريق الميراث والوصية.
3- التبادل بالأعـواض من بيع وشراء بأصنافه وأوصافه.
4- المشاركات التي تأخذ أشكالا مختلفة فهي أحياناً بالأموال وبالأبدان من الطرفين كشركة العنان والمعاوضة وأحياناً بالأبدان بلا أموال كشركة الوجوه وشركة أصحاب الحرف وبالبدن من جهة والمال من جهة أخرى كالقراض والمساقاة والمزارعة، ويمكن أن ندخل الإجارة في هذا الصنف.
قال ابن تيمية: وشركة الأبدان في مصالح المسلمين في عامة الأمصار وكثير من مصالح المسلمين لا ينتظم بدونها كالصناع المشتركين في الحوانيت من الدلالين وغيرهم فإن أحدهم لا يستقل بأعمال الناس فيحتاج إلى معاون والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعمله كما لا يمكن مثل ذلك في المضاربة ونحوها فيحتاجون إلى الاشتراك.[5]
ومن هذا القبيل بذل الآلات ووسائل الإنتاج إلى العامل بنسبة من الإنتاج، وما عرف عند القدماء بـ”اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه”.
ومن غرضنا النوعان الأخيران.
إن مسألة التعلق بالمقاصد كثر فيها الحديث في القديم والحديث وانقسم فيها الناس إلى طوائف وعلى حد قسمة الشاطبي إلى ثلاث مدارس مدرسة أعرضت عن المعاني وتمسكت بالظواهر والمباني ومدرسة أعطت للظاهر حقه وللمعني مستحقه ومدرسة لم تر في الظاهر مستمسكاً وهي التي سماها الشاطبي بالباطنية وفي العصر الراهن تمظهرت في المدرسة الحداثية التي دعت إلى ركوب سفينة المقاصد وهي دعوة للهروب من ديمومة مفاهيم الشريعة المستنبطة من الدلالات اللغوية وتجريدها من المعاني التي فهمها الرعيل الذي تلقى الوحي، وذلك من خلال ما سماه بعض المعاصرين بالمقصد الجوهري الذي يضفى النسبية على كل معنى ليتلائم معه وهكذا تكون لكل عصر شرعته ولكل زمن أحكامه دون تمييز بين ثابت ومتغير ومؤقت ومستقر.
ونحن اليوم أمام مدرسة رابعة تقول بالظواهر والمقاصد لكنها تسيء في استعمال الاثنين أحياناً جموداً على الظواهر مع قيام الحاجة للتعامل مع المقاصد وأحياناً انصرافاً عن الظواهر بمقاصد زائفة وغير منضبطة وتجدون أمثلة لهذه المدرسة اللامنضبطة في آخر هذا البحث إلا أن عدم الانضباط ناشئ عن فك الارتباط بالأدلة الأصولية التي أشرنا إلى بعضها.
وإن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي جزء من منظومة مقاصد الرسالة الخاتمة التي جاءت لصلاح الخلق ودلت بمجملات الأدلة وتفاريقها على أنها أنزلت لمصلحة العباد في الدارين وتحصيل السعادتين.
ولهذا كانت الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه وتكميل سعادته على أتم صورة. وكما يقول الراغب الأصفهاني : فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة[6].
فبكمال مراعاة الإنسان لقيمها ومقاصدها ورسومها يحصل السعادتين ويفوز بالحسنيين ﴿للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين﴾ سورة النحل.
يقول الشاطبي: ومعلوم أنَّ الشَّريعةَ وضعت لمصالح الخلق بإطلاق حسبما تبيَّن في موضعه، فكلُّ ما شُرعَ لجَلْب مصلحةٍ أو دَفْع مفسدة؛ فغيرُ مقصودٍ فيه ما يُناقض ذلك، وإنْ كان واقعاً في الوجود؛ فبالقدرة القديمة وعن الإرادة القديمة، لا يعزب عن علم الله وقدرتِه وإرادتِه شيءٌ من ذلك كله في الأرض ولا في السماء، وحكمُ التشريع أمرٌ آخر، له نظرٌ وترتيبٌ آخر على حسب ما وضعه، والأمرُ والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع، أو عدم الوقوع، وإنما هذا قولُ المعتزلة، وبطلانُه مذكور في علم الكلام؛ فالقصد التَّشريعي شيء، والقصد الخَلْقي شيء آخر، لا ملازمة بينهما.[7]
إن موقف الشريعة الفريد من المال ينسجم مع الحقيقة التي عليها يقوم بناء هذا الدين من أن الكون كله ملك لله جل وعلا فليس المال فقط وإنما الإنسان أيضا في كل تقلباته وتصرفاته وسكناته وحركاته ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾
بقدر ما يخضع الإنسان كيانه لهذه الحقيقة بقدر ما يكون صلاحه وتمام النعمة عليه ورضاه ﴿ وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ .
إن هذا الموقف يجعل الإنسان مستخلفاً وفرعاً، وليس أصلاً في الملكية، ولهذا فإن حريته في التصرف مضبوطة بالضوابط التي يضعها المالك الأصلي. ويجعل للمال وظيفة في هذه الدنيا على الوكيل أن يحصره فيها.
إن هذا الموقف يوضحه التشريع الإسلامي والقرآن الكريم في أشكال مختلفة إيجاباً وسلباً وجوداً وعدماً فيأمر باقتنائه : ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه ﴾ ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ ويمنع اقتناءه من السحت والربا والغصب والسرقة ويفصل أسباب الملكية المباحة وكيفية التصرف فيه وحسن إدارته فيمنع التبذير الذي يفوت صاحبه المال على غير هدى ويرميه إلى غير مرمى بل تبعاً للشهوات والطيش والغرور كما يمنع التقتير الذي يمنع صاحبه الحقوق ويغل يده إلى عنقه ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِك.. ﴾
ليست أموالنا
تفصل الشريعة سلوك الإنسان بالمال وسلوكه في المال انطلاقاً من الاستخلاف ويشرح القرطبي ذلك بقوله: “وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم”.
ويبين الشاطبي مقصد الاستخلاف بياناً مفصلاً بقوله: المسألة الثانية: قصد الشارع من المكلف أن يكون قصدُه في العمل موافقاً لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر منْ وَضْعِ الشَّريعةِ ؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوبُ من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يَقصد خلافَ ما قصد الشارعُ ، ولأنَّ المكلف خُلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة -هذا محصول العبادة- فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة.
وأيضاً فقد مرَّ أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات، وهو عين ما كلف به العبد؛ فلا بُد أن يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك، و إلا لم يكن عاملاً على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات، وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، وأقلُّ ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :” كُلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رَعِيَّته”.
وفي القرآن الكريم : ﴿آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾[8] وإليه يرجع قوله تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[9] وقوله ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾[10] ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ﴾[11]
والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث قال :” الأميرُ راعٍ والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وولدِه؛ فكُلّكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعِيَّته”.
وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص؛ فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامة كانت أو خاصة، فإذا كان كذلك؛ فالمطلوب منه أن يكون قائماً مقامَ من استخلفه، يُجري أحكامه ومقاصدَه مجارِيها وهذا بيِّـن[12] .
إن المال جعله سبحانه وتعالى قياماً لشئون الناس وقيماً وقرن الاعتداء عليه بالاعتداء على الأنفس فقال تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً﴾ ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام﴾
الوقت رأس مال المرء
وأشار عليه الصلاة والسلام إلى أهمية الوقت والمال ” نهى رسول الله عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال”. كما في الصحيح.
فقيل وقال تشير إلى تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه فيضيع العمر، وكثرة سؤال الناس وطلب الحاجات منهم دليل على عدم الإنتاج والاعتماد على الغير.
وكثرة السؤال بتوليد المسائل التي لا ترتجى منها فائدة فيفتى فيها بفتوى تسد باب الاجتهاد على العصور المقبلة وهذا خاص بزمنه ﷺ كما هو مقرر في تفسير قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ وحديث: اتركوني ما تركتكم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
وإضاعة المال بعدم حفظه وسوء التدبير وعدم الاستثمار ، فالوقت رأس مال المرء والعلم النافع يزكيه ويعمره والمال الصالح يسعده ويثمره.
[1] – ابن عابدين/ رد المحتار4/3
[2] – البغدادي عبدالوهاب/ الإشراف2/271
[3] – الزركشي/ المنثور3/222
[4] – شرح منتهى الإرادات 2/377/ تراجع الموسوعة الفقهية الكويتية
[5] – ابن تيمية/ الفتاوى30/98
[6] – تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين/ ص120
[7] – الشاطبي/ الموافقات2/ 49
[8] – سورة الحديد/ الآية 7
[9] – سورة البقرة/ الآية 30
[10] – سورة الأعراف/ الآية 129
[11] – سورة الأنعام/ الآية 165
[12] – الشاطبي/ الموافقات3/23