من بيت الحكمة إلى فلسفة الغزالي، ومن ترجمات جيرارد الكريموني إلى تعليقات نيوتن على كتب ابن الهيثم، يتنقّل الحوار بين شواهد حية على إبداع علمي ضخم تم التعتيم عليه عمدًا أو جهلًا في السرد الغربي. في هذا اللقاء المعرفي، نستضيف الأكاديمي المصري الدكتور ماهر عبد القادر محمد علي، أحد أبرز المفكرين والباحثين في تاريخ وفلسفة العلوم في العالم العربي. يشغل منصب أستاذ تاريخ وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، حيث امتد عطاؤه الأكاديمي والبحثي لأكثر من خمسة عقود.
حصل الدكتور ماهر على درجة الدكتوراه في مناهج البحث العلمي وتاريخ وفلسفة العلوم من جامعة الإسكندرية عام 1978م ، وتدرج في السلك الأكاديمي من باحث مساعد إلى أستاذ جامعي ورئيس قسم الفلسفة، ثم وكيل الكلية للدراسات العليا، ثم عميدًا لكلية السياحة والفنادق. كما شغل مناصب علمية مرموقة في جامعات عربية عدة، منها جامعة الإمارات وجامعة بيروت العربية.
تميّز الدكتور ماهر بإنتاج علمي غزير شمل المنطق، فلسفة العلوم، تاريخ الطب العربي، والتراث العلمي الإسلامي، وله مؤلفات مرجعية مثل المنطق الرياضي: التطور المعاصر، فلسفة العلوم: قراءة عربية، الحسن بن الهيثم وتأسيس فلسفة العلم، منطق الكشف العلمي (ترجمة)، بالإضافة إلى مساهماته الريادية في تحقيق نصوص تراثية علمية. كما شارك في عشرات المؤتمرات الدولية، ونال عضويات في أهم الجمعيات العلمية العالمية، وعمل كمستشار علمي ومحكم لعدد من الموسوعات والدوريات الأكاديمية.
إسلام أون لاين التقى بالدكتور ماهر على هامش أعمال المؤتمر الدولي للاستشراق والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 26 – 27 أبريل 2025 م بمشاركة نخبة من المستشرقين والمفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وأجرى حوارا حول ملف يتصل بدور العرب والمسلمين في نشأة وتطور العلوم، ونقلها إلى الغرب، وكيف تجاهل الغرب هذا الدور، وطالب بإعادة كتابة تاريخ العلوم بإنصاف وموضوعية.
وأكد الدكتور ماهر أن هذه المسألة ليست مجرد دفاع عن تراث، بل عن هوية علمية وحضارية، وأن إنتاج المعرفة في العالم العربي لا بد أن يكون مبنيًا على الاعتراف بالماضي، وإعادة الاعتبار لما أُنتج حضاريًا. كما دعا إلى استمرار البحث العلمي الجاد، وتوثيق هذا الدور الذي شكّل أساس نهضة الغرب وتطرق خلال حديثه أيضا إلى قضايا المنطق، وفلسفة العلم، والاستشراق، ووثق شهادات علمية دقيقة لم يُلتفت إليها كثيرًا.
إلى الحوار :
إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ العلوم، فهل أنصف الغرب المسلمين في تأريخه للعلوم؟ مثلًا آدم ميتز وآخرون، يتجاوزون الفترة الإسلامية كأنها انقطاع ويقفزون من العصر اليوناني إلى العصر الحديث. ما رأيكم في ذلك؟
ليس كل المفكرين، طبعًا، يسيرون بإطار واحد أو على وتيرة واحدة، لأن اتجاهات الفكر العلمي في إطار تاريخ العلوم مختلفةٌ حسبَ المدارسِ العلميةِ، وهذا يؤدي إلى أن كل مدرسة لها طابع معين يميزها.
اهتم العرب بتاريخ العلوم وبعلوم الآخرين منذ زمن بعيد، منذ القرن الثاني والثالث الهجري، واستخرجوا منها الدرر، وكان هذا الاهتمام ناتجًا عن اتصالهم بعلوم الآخرين عبر الترجمة، ونتيجة ما حصل في بيت الحكمة، هذه الأكاديمية العظيمة التي تُرجمت فيها علوم الآخر، علوم اليونان وغيرهم، إلى اللغة العربية، وبالتالي استفادت منها الحضارة الإسلامية.
لكن العرب والمسلمين لم يتوقفوا عند هذه المحطة، بل انتقلوا إلى سبيل الابتكار بعد أن هضموا هذه العلوم، وعرفوها وتعاملوا معها على أنها ذات كيان خاص، ثم أنتجوا كل ما هو جديد، إما في الرياضيات أو في البصريات أو في الفلسفة والفكر.. في كل المجالات.. كان هناك إنتاج عربي وإسلامي متميز.
هل كان إنتاج هذه العلوم بفلسفة إسلامية؟
بالتأكيد. هناك فلسفة إسلامية لهذه العلوم جميعًا، وفلسفة هذه العلوم كانت عبارة عن البحث في أسسها القائمة عليها، وكيف يمكن أن نستخدمها ونوظفها ونطورها ونطوعها لرفاهية الإنسان، وهذا أمر مهم جدًا.
عندما بدأت العلوم تنتقل إلى العرب والمسلمين، كان دور العلوم قد انتهى لدى اليونانيين ولم يستفيدوا منها، ولم يعد لها أي قيمة، لأن مدارس الفكر أُغلقت، مثل مدارس الإسكندرية وغيرها. نحن من بعث هذه العلوم من مرقدها.
كذلك لم تكن هناك ألغام طائفية كما هو حاصل الآن: مسلم ومسيحي ويهودي وسرياني..، كل ذلك لم يكن موجودًا. بل كان هناك شيء اسمه الدولة الإسلامية القابضة على كل شيء، وبالتالي كان الجميع ينتمي لهذه الدولة الإسلامية، وكان الإنتاج لصالح الدولة ككل، لأنها كانت تنفق على هذا الإنتاج، وبيت الحكمة دليل عظيم وشاهد على ذلك.
ثم جاء الآخر واستفاد من هذه العلوم حيث بدأت وفود الترجمة تأتي من أوروبا حين كان العلم فيها مظلمًا، فجاء التراجمة ونقلوها.
إذن المسلمون نقلوا التراث العلمي الذي أخذوه ممن سبقهم إلى الحضارة الأوروبية.
المسلمون أنتجوا ولم يتوقفوا عند اليونان. أخذوا وطوّروا وترجموا وأنتجوا ما هو جديد. والآخر الذي جاء من الغرب أخذ ما هو جديد ونقله إلى اللغة اللاتينية ونقله إلى اللغات الغربية، وبالتالي استفاد منه الغرب. فإذن الغرب لم يتوقف عند مسألة أنه يستفيد من هذه العلوم فقط، بل يدعي امتلاك هذه العلوم أيضًا، ويقول للعرب والمسلمين: أنتم لم تفعلوا شيئًا، أنتم فقط حافظتم على علوم اليونان، ونحن أخذناها منكم.
ونحن كشفنا عن أشياء كثيرة في هذا المجال. ستجد كتابًا من تأليفي بعنوان: “الوجه العلمي للاستشراق الإيطالي .. جيرارد الكريموني نموذجًا” يقع الكتاب في حوالي 350 صفحة أو 300 صفحة، ويتناول الترجمات التي قام بها جيرارد الكريموني للكتابات العربية المهمة إلى اللاتينية، والتي استفادوا منها وتعلموا منها، مثل كتاب القانون في الطب لابن سينا، كتاب البصريات (المناظر) لابن الهيثم، كتاب الجراحة للزهراوي، وكتاب إحصاء العلوم للفارابي، وكتب أخرى كثيرة من إبداعات المسلمين نُقلت إلى اللغة اللاتينية ثم إلى أوروبا. ويتحدث الكتاب عن ماهية هذه الكتب ومن قام بنقلها وترجمتها وإلى غير ذلك من تفاصيل. ولم يكن الغرب ليأخذ هذه العلوم ويستمر فيها إلا لكونها مهمة فتوقف العلماء عندها ودرسوها واستفادوا منها.
وهنا تظهر مشكلة غريبة، فعندما أخذ الغرب هذه الكتابات لم يذكروا المصدر العربي الأصلي، واكتفوا بالنقل دون الإشارة إلى صاحب الأصل. هذه مشكلة في الأمانة العلمية. على سبيل المثال، عندما ينقل جيرارد الكريموني نصًا معينًا من مراجع معينة يذكرها في ترجماته، ونحن بدراستنا وجدنا أنه اتبع طريقة المترجم العربي حنين بن إسحاق في بيت الحكمة، وهي الاعتماد في النقل على أكثر من مخطوطة وتحقيقها، وهذا ما جعله يُنتج ترجمات ممتازة. ثم تُرجمت كل أعماله من اللاتينية إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وغيرها من اللغات الأوروبية.
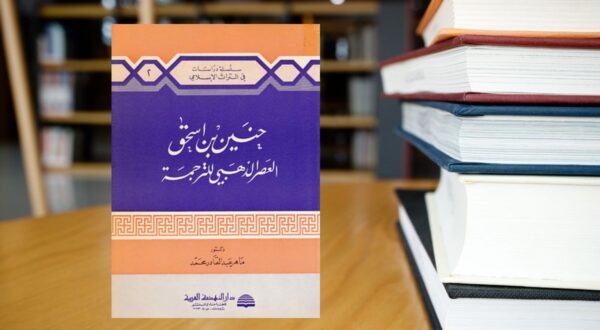
وهنا أشير إلى نقطة مهمة جدًا في تاريخ العلوم؛ الأوروبيون عندما نقلوا الكتابات العربية لم يذكروا المصادر التي نقلوا منها، مما يعكس خللًا في الأمانة العلمية لأنهم يعتبرون أنفسهم مصدرًا للعلم، على عكس ما يحدث اليوم عند الباحثين العرب، حيث يُشترط ذكر المصادر.
سبق لي الاطلاع على كتاب المناظر لابن الهيثم في جامعة لندن، وذلك في قسم تاريخ العلوم، عام 1981م. حينها سألني رئيس القسم بالجامعة: “هل تعرف هذه الصورة؟”، قلت له: “شكلها كتاب”. قال لي: “هذا كتاب المناظر لابن الهيثم.” قلت له: “جميل جدًا.” قال: “الأجمل أن تعليقات الحواشي هذه كتبها إسحق نيوتن!”
ومع ذلك، نيوتن لم يذكر ابن الهيثم بكلمة. قال إن الإلهام جاءه مباشرة! وهذه مشكلة علمية وأخلاقية كبرى. ولا بد من الدفاع عن ذلك. ولا بد من حلها. لماذا؟ لأن مسألة العلوم تتصل بذاتية الأمة، وبالتالي تتصل بإنتاج علماء مسلمين وعرب مؤمنين جدًا. ونحن عندما أخذنا من الآخر اعترفنا بإنتاجه، لكن الآخر رفض الاعتراف بإنتاجنا. ولهذا السبب ستجد لي كتابًا من تأليفي بعنوان: “الأنا والآخر” يتحدث عن هذا الموضوع.
لماذا اعترف جيرارد الكريموني بدور المسلمين؟ هل قرب إيطاليا الجغرافي من العالم الإسلامي له دور؟
جاء ذلك بمحض الصدفة، ثم تحول إلى خط منهجي مختلف. سبب مجيء الكريموني للمشرق الإسلامي كان بحثه عن كتاب يوناني مفقود، وهو كتاب “المجسطي لبطليموس“، لأن تخصصه الأساسي كان الفلك. فظل خمسين عامًا يبحث عنه، ولم يجده إلا في نهاية رحلته. وخلال هذه السنوات، أنتج ترجمات هائلة من التراث الإسلامي. الكتاب كان يتحدث عن الفلك، والمسلمون اهتموا به اهتمامًا شديدًا. ورأى الكريموني بأم عينيه الجهد العلمي الإسلامي، وعاين هذا التراث واقعًا، فاعترف به. ومثل هذه القصة تعطيك فكرة حول أسرار عالم يريد أن يصل إلى الحقيقة، وخلال رحلته البحثية اطلع على الكتاب والتعليقات الموجودة على الكتاب وعرف من الذي ترجمه وفي أي عصر وطريقة ترجمته وإلى غير ذلك من تفاصيل.
من قام بترجمة “المجسطي لبطليموس”؟ بيت الحكمة ببغداد؟
نعم. في أيام بيت الحكمة أو بعده بقليل، وكان من أوائل الكتب المترجمة في ذلك العصر.
وهل وجد الكريموني فيه اهتمام العلماء المسلمين وآثارهم بهذا العلم؟
الكتاب في مجمله يتحدث عن الفلك، واهتمام المسلمين بعلم الفلك أصيل ومتجذر، وبالتالي نظر جيرارد الكريموني إلى هذه القضية واطلع عليه بنفسه ومن أرض الواقع، كما استفاد من التراث العلمي الموجود في ذلك الوقت، وهو إنتاج ضخم جدًا، وما زلت أبحث عن بقية الكتابات الأخرى التي ترجمها، لأنه توجد كتابات أخرى غير التي ذكرتها ولم أصل إليها حتى الآن، وغير معروفة، وسنكتشف هذه الكتابات مع الوقت.
وهناك نقطة في غاية الأهمية، هي أن العلوم طرحت فكرة تعدد مناهج العلوم وتنوعها. وهذا الأمر اكتشفناه على مراحل. فعلمنا كيف تسربت الفلسفة إلى الفلاسفة الغربيين مثل ديكارت وغيره، وكيف تسرب المنهج التجريبي إلى فرانسيس بيكون؟ ثم بدأنا نتعرف على بعض الإجابات وقدمنا عليه الأدلة بفضل عدد من الباحثين الواعدين العاملين في الحقل.
بمناسبة انعقاد أول مؤتمر دولي يقام في الشرق عن الاستشراق، وفيما يتصل بما ذكرتموه عن تعرف الغرب حول منهج المسلمين في هذه العلوم. عقد مؤتمر في الغرب عن الاستشراق في القرن الماضي قبل مائة عام تقريبًا، وذكر أحد العلماء المصريين أنه اطلع على مسودة في مكتبة ديكارت لكتيب الإمام الغزالي، فلعلك تحدثنا عن هذا الموضوع.
هذا صحيح. هذا ما كشف عنه الدكتور محمود حمدي زقزوق – رحمه الله – في كتابه “فصل المقال عن المنهج” وفي كتابات أخرى، عن المواضع التي أخذها ديكارت من الإمام الغزالي في كتابه “المنقذ من الضلال”، وذكر أن ديكارت نقل منهج الشك المنهجي من الغزالي. وجاء ما اكتشفه زقزوق كان خلال رسالته لدرجة الدكتوراه في ألمانيا، مما شكل صدمة ومفاجأة للمشرف.
فيما يتصل بالمنطق في العلوم، كيف وفد إلى المسلمين؟ وكيف تعاملوا معه؟
استخدموه دراسة نقدية، وتطورت بناءً عليه علوم كثيرة. وهذا أمر لم يمر مرور الكرام على الغرب. فأحد أهم الكتّاب الغربيين، وهو نيكولا ريشر، كتب كتابًا بعنوان “تطور المنطق العربي” وتأثير ذلك على تطوير المنطق في أوروبا.
العلماء العرب فهموا حدود المنطق وفهموا أن المنطق علم لا بد من معرفته. الإمام الغزالي مثلًا له مقولة مهمة جدًا يقول فيها: “لا يوثق بعلمه من لا يعرف المنطق”، وابن تيمية نفس الشيء، رغم نقده للمنطق، إلا أنه يقر بأهميته حتى يحمي متعلمه ويعينه على إنتاج علم جيد. وهذه نقطة في غاية الأهمية للعالم أو الباحث لكي لا يُخدع في استنتاجاته، لأن المنطق يعلّم طريقة الاستدلالات وطريقة التفكير. وهناك من جهل أهمية المنطق مثل ابن الصلاح عندما فشل في دراسته لأنه لم يستوعبه فذمّه.
عندما تستطيع تعلم المنطق، يمكن أن تُفيد العلم. لقد عرف الغرب هذه الأفكار عن طريق العرب والمسلمين. ولهذا، حين مُنع ابن رشد في فترة من الفترات، لم يُمنع الغزالي، ولم يُحرم فكره، لأنهم أدركوا أن كلام الغزالي صحيح، فعرفوا قيمة حديثه عن العلوم، وفي معيار العلم، في كتابه «القسطاس المستقيم»، وفي «المنقذ من الضلال»، وفي كل ما كتبه من مؤلفات حملت أفكارًا جليلة. لقد استوعبوا أهمية هذا التراث الفكري الذي قدّمه.
ما مستقبل تاريخ العلوم والمناهج في العالم العربي والإسلامي؟
هناك باحثون شباب في العالم العربي مهتمون الآن بهذه القضايا، وهذا مبشّر جدًا. الربط بين العلم وتاريخه ومنهجه أمر ضروري، وهو الذي يجعلنا نشارك في صنع الحضارة. نحتاج إلى إنفاق على البحث العلمي، ولا نعدّه خسارة فيه، لأنه استثمار في المستقبل.

